أحسب أن قلة ضئيلة من الأميركيين والأوروبيين سمعت عن وائل الحلقي، وليست أكثر منها بكثير نسبة العرب الذين سمعوا به وعرفوا عنه. إن الدكتور الحلقي، لمن يهمه الأمر، هو رئيس حكومة النظام السوري، وكان قبل بضعة أسابيع قد أدلى بتصريح أعلن فيه بدء العد العكسي لاحتلال مدينة حلب.
النفوذ السياسي والعسكري للدكتور الرئيس، في نظام شخصاني وعائلي وأمني كنظام دمشق الذي يخدمه، محدود جًدا إن لم نقل معدوًما. وبالتالي، فما “كشف” عنه لجهة نية النظام احتلال حلب أتى وفق المثل السائر في بلاد الشام “اعرفوا أسرارهم من صغارهم”. أما لماذاُترك أمر هذا التصريح – التلميح له بدلاً من صدوره عن أصحاب القرار الفعلي في سوريا فمسألة تستدعي التفكير الجاد.
على أي حال، ما حدث ويحدث في حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وثاني أقدم حواضر العالم، يبدو الآن جزًءا مهًما من الاستراتيجية المؤامرة المعّدة لسوريا والعالم العربي، كل العالم العربي. وإلا لما كانت المدينة قد استثنيت عمًدا من “الاتفاق” الروسي – الأميركي على هدنة تساعد على تسريع تطبيق الشق السياسي من هذه الاستراتيجية. ذلك أن الهدنة المتفق عليها بين موسكو وواشنطن تشمل غوطة دمشق ومحافظة اللاذقية، وهما منطقتان يشكل صونهما والمحافظة على خطوط الفصل فيهما مسألة حيوية لبقاء النظام.
موضوع حلب في الحسابات الدولية مختلف تماًما، وذلك لاعتبارات كثيرة لكل اللاعبين الأساسيين في الملعب السوري، أهمها اعتباران: الاعتبار الأول أنها أقرب حاضرة سوريا كبرى لتركيا، وكانت مع المناطق المحيطة بها تضم أكثر من 4 ملايين نسمة، ويشّكل التركمان والأكراد والعرب السّنة غالبية سكان ريفها.
وبالتالي، من أجل ضمان مستقبل “سوريا المفيدة” وعزل تركيا عن العمق العربي السّني، كما تريد كل من إيران وروسيا، لا بّد من تهجير نسبة عالية من التركمان والعرب السّنة.
والاعتبار الثاني، وهوُمكمل جغرافًيا وديموغرافًيا لسابقه، يقوم على بناء قطاع جغرافي كردي يفصل تركيا عن الشمال السوري، من شأنه فتح المجال مستقبلاً أمام إمكانية تأمين منفذ بحري على المتوسط لـ”كردستان الكبرى” إذا ما قررت واشنطن مواصلة سياسة الرئيس باراك أوباما القائمة على الاستثمار في الأكراد، إلى جانب اعتماد إيران “شريًكا” استراتيجًيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وهكذا، فإن تغيير هوية حلب، وإعادة رسم جغرافية الشمال السوري، هما الهدف من المجازر التي ارتكبها النظام بدعم عسكري روسي – إيراني وغطاء سياسي أميركي. وهذا يحمل تحديات كبرى ليس للسوريين فحسب، بل لكل العرب من المحيط إلى الخليج. هي – على الأرجح – لن تخفت أو تزول في المستقبل المنظور. هذه التحديات الخطرة تمتد اليوم من المغرب، حيث أعادت شخصيات مقّربة من البيت الأبيض فتح ملف الصحراء، متعّمدة إحراج “الحليف المغربي” واستفزازه وابتزازه، إلى منطقة الخليج واليمن حيث تتدّخل إيران وتزرع التوتر، مروًرا بـ”الهلال الخصيب” الذي باتت إيران تحتله فعلًيا برضى دولي. ومن هنا بات مطلوًبا أكثر من أي وقت إطلاق مقاربات واقعية تتعاطى مع حقائق السياسة والاقتصاد والأمن من دون أوهام.
أول الغيث كان في المملكة العربية السعودية مع إعلان “الرؤية 2030” التي تشّكل أهم تصّور متكامل يخطط للمستقبل ويتحّسب لتطوراته الإيجابية والسلبية، وينطلق من أرض الواقع بعيًدا عن “هامش الطمأنينة” الذي ركنت إليه عدة دول عربية خلال نصف القرن الأخير لتكشف في ما بعد، أنه باهظ التكلفة. والمنطق يقول إن الدول لا تختار مواردها الطبيعية ولا جيرانها، لكنها تستطيع – بل واجبها – بناء أولوياتها الاقتصادية والتنموية والسياسية والأمنية، في ظل إدراكها ما لها وما عليها، ومن هو الصديق ومن هو العدو، وأي جار يمكن تحييده، وأيهم يتحتم كسبه، ومن منهم يتوجب الحذر منه.
وأي جار يمكن تحييده، وأيهم يتحتم كسبه، ومن منهم يتوجب الحذر منه. ولقد قيل الكثير خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة تفسير سياسات إدارة أوباما إزاء قضايا العرب والشرق الأوسط، ولا سيما الانفتاح على إيران. ومن ثم، ما استتبع ذلك من مواقف حيال الثورة السورية، والتوتر السّني – الشيعي الذي غذته طهران واستثمرت فيه منذ 1979، والتعايش مع الطموحات الروسية في شرق المتوسط. وكان بين التفسيرات المطروحة تناقص أهمية نفط الخليج بعد ظهور ثروات طاقة بديلة، وتزايد أهمية منطقة الشرق الأقصى ولا سيما الصين اقتصادًيا وأمنًيا، وتغّير المزاج الشعبي الأميركي من "المغامرات الخارجية".
"المغامرات الخارجية". هذه التفسيرات لا تخلو من الصدق… فكيف يكون التعامل الحكيم معها؟ التعامل الحكيم كان لا بد أن يقوم: أولاً على المكاشفة والمصارحة. وثانًيا: على الاعتماد على النفس. وهذا ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مشاركة الرئيس الأميركي نفسه في قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، التي لعبت وما زالت تلعب عدة أدوار محورية في الملفين الساخنين اليمني والسوري. الثابت أن الكلام الإيجابي الذي ورد رسمًيا عن حصيلة لقاء أوباما بالقادة الخليجيين كان متوقًعا، غير أن الجانبين الخليجي والأميركي يتفّهمان تماًما أن أي علاقة “صداقة” أو “تحالف” تحتاج بين الفينة والفينة إلى “صيانة”. وما صدر عن واشنطن خلال السنتين الأخيرتين، وصولاً إلى ما بات يوصف بـ”عقيدة أوباما”، لم يأت مصادفة أو في مناسبة عابرة، بل على العكس، جاء معّبًرا عن قناعات فكرية عميقة عند الرئيس أوباما أسهمت في رسم “منظومةُمثل” عنده تتجاوز الكلام الدبلوماسي المنّمق. في المقابل، من السذاجة أن تتصّور واشنطن أن العالم العربي، وبالأخص الدول الخليجية وعلى رأسها قادتها، ما زال عاجًزا عن قراءة الحقائق والمتغيرات. فالحقيقة أن في العالم العربي، وبالذات، في دول الخليج الواقعة على مرمى حجر من إيران، ذاكرة سياسية قوية وغريزة سياسية قوية لا يتفّوق عليهما سوى اللباقة والصبر الجميل. وبانتظار نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندماُينتخب رئيس أميركي جديد، لا بديل عن الواقعية والاعتماد على النفس.. أما “هامش الطمأنينة” فقد بات ضرُره أكبَر من نفعه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


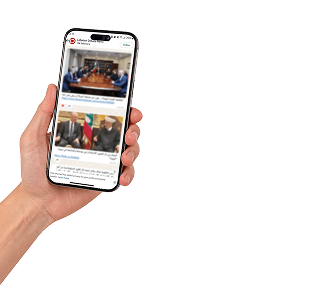




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





