بينما يستعد دونالد ترامب لخلافة أوباما في رئاسة الولايات المتحدة آخر شهر كانون الثاني، طُلب من كُتّاب الأخبار المتخصصين في الشأن الأميركي في صحيفة "الغارديان" البريطانية أن يُقيِّموا فترة رئاسة أوباما: ما الإنجازات التي حققها في المجالات الرئيسية المتنوعة، وهل ستصمد؟
الاقتصاد
بعد ثماني سنوات من تنصيب أوباما رئيساً، وصلت سوق الأوراق المالية في أميركا مستوياتٍ قياسية، وانخفضت نسبة البطالة إلى 4.6%، وهي أقل نسبة بطالة شهدتها الولايات المتحدة الأميركية على مدار العقد الأخير، وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 23%، بعدما تعافت من كبوتها الضخمة التي يذكرها الجميع.
بهذه المقاييس، يمكن للولايات المتحدة أن تحتفي بالسجل الاقتصادي للرجل الذي ورث أسوأ فترة ركود حدثت منذ الكساد الكبير. ومع ذلك، انتُخب خلفه ترامب اعتماداً على موجةٍ من الشعبوية الاقتصادية، وبناءً على وعدٍ بـ"جعل أميركا عظيمةً ثانيةً"، وهو ما يوحي بأنَّ أعداداً غفيرة من الناس لم تشعر بتغييرٍ يمكن لهم تصديقه رغم كل هذه الأرقام الوردية.
حين نُصِّب أوباما رئيساً في كانون الثاني من عام 2009، كانت نسبة البطالة 7.6%. وحين أدى الركود الاقتصادي إلى فصل العديد من الناس من وظائفهم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 10% في تشرين الأول من العام ذاته.
ومع أنَّ أوباما يمكنه أن يفتخر بتوفير 11 مليون وظيفة خلال عهده، تُشير إحصائياتٌ أخرى إلى أحد الأسباب التي جعلت الناس يريدون التغيير، وهو أنَّ مُعدل مشاركة القوى العاملة، وهو عدد الناس الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل، قد انخفض انخفاضاً لم يحدث منذ سبعينات القرن الماضي. والسبب في هذا الانخفاض كان موضوعاً شهد الكثير من الجدل. رُبما يكون السبب هو التركيبة السكانية، أو وصول الكثيرين لسن التقاعد، أو ربما يكون الناس قد تخلَّوا عن أملهم في أن يجدوا عملاً مناسباً. حدث معظم الانتعاش التوظيفي في قطاعَي الخدمات والصحة، لكن ما زالت الوظائف الصناعية تختفي بسبب المشروعات الأميركية التي تُقام خارج البلاد، أو بسبب حلول الآلات محل البشر في هذه الوظائف. ونتيجةً لهذا، ظلَّت نسبة نمو الأجور بلا زيادة خلال عهد أوباما.
تجنَّب الاقتصاد الأميركي موجةً أخرى من الخراب في عهد أوباما، لكنَّ النمو كان هزيلاً. لكن تجدر الإشارة إلى أنَّ الاقتصاد، بعدما تعافى من الأزمة الاقتصادية، صار أقوى وأسرع من نظرائه في أوروبا، وذلك بعد تجنُّب إجراءات التقشُّف التي كانت شائعةً هناك. ومنع أوباما أيضاً احتمالية حدوث أزمة كبرى جديدة في القطاع المالي بوضع قواعد صارمة جديدة من خلال فرض قانون "دود-فرانك" لإصلاح "وول ستريت" وحماية المستهلِك.
لكن مع كل هذه الإنجازات الجديرة بالثناء، ترك إرث أوباما الاقتصادي الكثير من الناس شاعرين بأنَّهم غير آمنين، وأنهم لا يتلقون أجوراً كافية. والآن، إذ يَعِد ترامب بتحرير قوى الرأسمالية من جديد، بإلغاء قانون "دود-فرانك" وغيره من القوانين، قد تنتظرنا أوقاتٌ ذات إيقاعٍ أسرع. لكننا جميعاً نعرف ماذا يحدث بعد الكلمات الصاخبة. وربما يكون التاريخ أرحم بإرث أوباما الاقتصادي من الناخبين الأميركيين.
السياسة الخارجية
كانت سياسة أوباما الخارجية مُكرَّسةً قبل أن تتَّضح معالمها على نحوٍ جليٍ. وقد نال جائزة نوبل للسلام بعد انقضاء تسعة أشهر على بدء رئاسته، في وقتٍ كانت فيه أهم إنجازاته هي خطاباته الطموحة حول الشرق الأوسط وانتشار الأسلحة النووية. وكان من الصعب تنحية الشك في أنَّ الرئيس مُنِح الفوز بنوبل بالأساس لأنَّه لم يكن كجورج بوش.
كان يُعتَقَد أنِّ وجهة نظر أوباما في التعامل مع بقية العالم تناقض من أتوا قبله. واعتمد ذلك بشدة على الاستفادة من درس غزو العراق، أي أنَّ التدخل الأميركي العسكري، الذي تغذِّيه الغطرسة والجهل، يمكنه أن يجعل الأوضاع المشحونة في الخارج أكثر سوءاً.
وإذا كان لمبدأ أوباما عنوان فرعي، كان سيكون: "لا تقوموا بأمورٍ حمقاء". وقد جعل مسؤوليه يردِّدون العبارة نفسها في العشرات من البيانات الموجزة، وفي مناسبةٍ واحدةٍ على الأقل، في رحلةٍ خارج البلاد عام 2014، قيل إنَّ الرئيس جعل صحفيي بالبيت الأبيض يردِّدون الكلمات وراءه، مثل تلاميذٍ في فصلٍ بليد بإحدى المدارس الابتدائية.
وبعد سنوات حكم بوش، كان لتلك الكلمات وقعاً مطمئناً، وباعتبارها مبدأً، كانت لها نجاحاتها.
كان قرار أوباما بالتعامل مع إيران باعتبارها ليست تجسيداً للشر الأوحد، ولكن كمجتمعٍ معقَّدٍ لديه نزعة براغماتية حقيقية، هو ما أفضى في النهاية إلى اتفاق يوليو/تموز 2015 في فيينا (الاتفاق النووي الإيراني)، والذي من خلاله قبلت طهران فرض قيودٍ صارمة على برنامجها النووي، في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. ومع أن الظروف وقتها ساعدت كثيراً في التوصل إلى الاتفاق، إذ كان حسن روحاني قد انتُخِبَ رئيساً لإيران في يوليو/تموز 2015، ومع أن الاتفاق ينطوي على بعض نقاط الضعف، ويواجه الكثير من الانتقادات، لكنَّه يظل أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية لهذا العصر.
ومثَّل التقارب مع كوبا كذلك على مدار العام الماضي تراجعاً عن "الأمور الحمقاء"، من خلال إنهاء سياسة العزلة التي فشلت في تحقيق هدفها على مدار أكثر من نصف قرن.
ولكن هذه الخطوات لم تكن كافيةً لبناء عقيدة أميركية جديدة في السياسة الخارجية. فمع نهاية عصر أوباما، أصبح هذا الشعار يشكِّل عبئاً، وتحوَّل إلى سببٍ للتردد والجمود في السياسة الأميركية. فبعض الحكومات والقادة قاموا بأمورٍ حمقاء، نابعةً من الغطرسة، والطموح، أو الضعف، دافعين بقية العالم إلى اللجوء لواشنطن. وفي ظروفٍ كتلك، عُدَّ عدم القيام بفعل أيضاً فعلاً في حد ذاته.
راوغ أوباما في التعامل مع الثورة الليبية، فوافق على التدخل، لكن على أن يتولّى "القيادة من الخطوط الخلفية". وتداركاً للأخطاء التي حدثت في العراق، لجأت الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على دعمها للعمل العسكري، لكن لاحقاً، من وجهة نظر موسكو على الأقل، أُسيء استخدام التفويض من خلال السعي لتغيير النظام. وأُطيح بالقذافي، وبعد ذلك، بُذِل القليل من أجل إنقاذ ليبيا من الانزلاق إلى الفوضى.
عكَّر التدخل في ليبيا العلاقة مع روسيا بصورةٍ أكبر، وساهم في التسبُّب في إخفاق مجلس الأمن الدولي في أكبر أزمات حقبة أوباما: الصراع السوري. إذ انخرطت الولايات المتحدة على نحوٍ غير فعَّالٍ في دعم قضية المعارضة، وكانت يدها مغلولةً نتيجة حالة الغموض التي اكتنفت الجماعات التي كانت تتعامل معها. والأمر الأكثر كارثيةً كان وضع الرئيس "خطاً أحمر"، يقضي باستخدام القوة العسكرية في حالة استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية، ثُمَّ بعد ذلك لم يفِ بتحذيره النهائي هذا عندما قصف بشار الأسد شعبه بالأسلحة الكيماوية في آب 2013. وقد أدَّى التراجع فعلاً إلى التخلُّص من معظم الترسانة الكيماوية السورية، لكنَّه جعل الأسد أكثر جرأة، وترك فراغاً ملأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب تبعاتٍ مُهلِكة طالت الشعب السوري.
ومع خسائر في الأرواح تُقارب نصف المليونٍ، تُخيِّم ظلال سوريا على إرث أوباما في السياسة الخارجية، تماماً كما لطَّخت أحداث العراق إرث جورج بوش. فبالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، يمكن أن يكون لخطيئة الامتناع عن فعل ما هو ضروري نفس حجم وتأثير القيام بأفعالٍ خاطئة.
الأمن القومي
بعد أن يترك أوباما منصبه بفترةٍ طويلةٍ، سيتجادل الباحثون الأمنيين حول ما إذا كانت أجهزة الأمن هي التي كات تسيطر على الأمور خلال رئاسته، أم أنَّ أجندة أوباما هي التي كانت مصادفةً تتسق مع المصالح البيروقراطية لهذه الأجهزة.
وصل أوباما إلى البيت الأبيض بأجندة الأمن القومي الأكثر ليبرالية منذ الرئيس جيمي كارتر. فقد بنى حملته على إنهاء حرب العراق في تاريخٍ محدَّدٍ، وحظر التعذيب الذي تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية، وإغلاق معتقل خليج جوانتانامو، وفتح حوارٍ مع الخصوم التقليديين في الولايات المتحدة. لكن في الوقت نفسه، تعهَّد أوباما بتصعيدٍ في حرب أفغانستان، وانتهاك سيادة باكستان من أجل ملاحقة أسامة بن لادن. وأيَّد توسعاً هائلاً في عمليات المراقبة، في حين كان أقرب مستشاريه لمكافحة الإرهاب له هو جون برينان، المسؤول البارز في وكالة الاستخبارات المركزية في بداية برنامج التعذيب.
قايض أوباما على نحوٍ فعَّالٍ إنهاء حرب العراق في مقابل استمرار الحرب على الإرهاب، الشيء الذي استبعده كلٌ من أنصاره الليبراليين ومنتقديه المحافظين على اعتبار أنَّه لا يتماشى مع صورة أوباما المنقذ الليبرالي، أو أوباما داعية السلام الساذج.
في بدايات رئاسته، أقام أوباما علاقةً هشَّةً مع جنرالاته العسكريين، رغم أنَّه منحهم أكثر مما أخذ منهم. وتلكَّأ أوباما في الانسحاب من العراق، وأمر بإرسال أكثر من 30 ألف جندي إلى أفغانستان. لكنَّه انسحب من العراق في 2011، وهو العام نفسه الذي كان قد قرَّر أن ينهي فيه التصعيد الأفغاني. خرج أوباما من تلك التجربة محبطاً مما اعتبره إرادة المؤسسة العسكرية في دفعه إلى تحقيق أهدافها المنشودة. وكانت لديه خطةٌ بديلة.
فبدلاً عن الحروب البرية المكلفة التي اعتبر أوباما أنَّ الجيش يفضِّلها، تحوَّل إلى الاعتماد على الطائرات بدون طيَّار التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، وشبكة الرقابة العالمية لوكالة الأمن القومي، وكذلك المداهمات السرية، لكن العنيفة، من قيادة قوات العمليات الخاصة المشتركة. وسمح لهم أوباما بالعمل في ظل الحد الأدنى من القيود، موسِّعاً النطاق الفعلي للحرب العالمية على الإرهاب إلى الصومال، واليمن، وباكستان، وليبيا، ومالي، والنيجر، وكذلك النطاق الرقمي لهذه الحرب في جميع أرجاء العالم. وفي حين أعلن أوباما أنَّ "تيار الحرب آخذٌ في الانحسار"، قام بتوسيع نطاقه إلى مزيدٍ من الشواطئ.
ولم تؤدِّ تسريبات وكالة الأمن القومي التي قام بها إدوارد سنودن، ولا حتّى الكشف عن أنَّ غارات الطائرات بدون طيَّارٍ قتلت صبي أميركي يبلغ عمره 16 عاماً إلى الكثير من التراجع. وبنهاية ولايته، كان أوباما قد بارك القيود المفروضة على المجموعة الأكبر من التسجيلات الهاتفية للأميركيين، وفرض قيوداً بسيطةً على غارات الطائرات بدون طيَّار. وفي ظل الأهمية الكبيرة التي احتلتها وكالة الاستخبارات المركزية في استراتيجية أوباما، تردَّد أوباما في محاكمة المتَّهمين بالتعذيب داخل الوكالة، ضارباً مظلَّة دفاعيةً للتستُّر على برنامج التعذيب.
وأرادت وكالات الاستخبارات حرية حركةٍ أكبر حتى من تلك التي وفَّرها لهم أوباما، ويُنتَظَر أن يوفِّر دونالد ترامب لها ذلك. وفيما يتعلَّق بالأمن القومي، مثَّل أوباما، بكل وعوده التقدُّمية، جسراً أكثر منه حاجزاً بين حقبتي بوش وترامب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


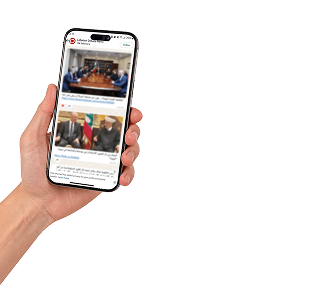




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





