الخطوة التي يُقدِم عليها الرئيس تأتي في ظرفٍ لبنانيٍّ هشّ، حيث الاعتداءات الإسرائيلية اليومية لا تزال تطال العمق اللبناني، وحيث يعيش الجنوب تحت القصف، والبقاع تحت التهديد، والبلد بأكمله في دوّامة قلقٍ وجودي. فكيف يمكن الحديث عن تفاوضٍ في ظلّ استمرار العدوان؟ وأيّ منطقٍ سياسيّ يبرّر الجلوس مع من يقتل المدنيين ويقصف القرى بلا رادعٍ أو وازع؟
التفاوض في مثل هذه الظروف لا يُقرأ إلا على أنه استسلامٌ سياسيٌّ مغلّف بشعارات السيادة والسلام، ومحاولة لتجميل مشهدٍ قاسٍ يُراد فرضه على لبنان تحت وطأة التعب والخراب.
ثمّة من يرى أن لبنان، وهو الخارج من حربٍ طاحنة، لا يملك ترف الدخول في مغامرةٍ تفاوضية تُعيد إلى الأذهان اتفاق 17 أيار 1983، الذي وُقّع بين الحكومة اللبنانية آنذاك وإسرائيل برعايةٍ أميركية، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982.
ذلك الاتفاق، الذي أسقطه الشارع ورفضته غالبية القوى السياسية، لم يجلب سوى مزيدٍ من الفتنة، وأدخل البلاد في دوّامة صراعٍ داخليٍّ أنهك الدولة والمجتمع، وانتهى بإلغائه تحت ضغط الدم والسلاح والانقسام.
اليوم، يعيد التاريخ نفسه وإن بوجوهٍ مختلفة. المسيحيون الذين حملوا عبء 17 أيار حينها، يجدون أنفسهم اليوم في الواجهة مجدداً، يُدفعون إلى “واجهة التفاوض” وكأن قدرهم أن يكونوا بوّابة التنازلات ومسرح التجارب.
إنّ ما يُطرح اليوم لا يمسّ فقط الموقف السياسي من إسرائيل، بل يطال جوهر الكيان اللبناني وتوازناته الداخلية، ويهدّد بقطع ما تبقّى من حضورٍ مسيحيٍّ متماسك داخل الدولة، في ظلّ مناخٍ إقليميٍّ ودوليٍّ لا يُبشّر إلا بالمزيد من الضغوط والتطويع.
لبنان، الممزّق بين إرادة الصمود ومغريات الانفتاح، يقف على مفترقٍ خطير. فالتفاوض ليس تفصيلاً دبلوماسياً، بل خيارٌ وجوديّ يحدّد وجهة البلد لعقودٍ قادمة.
وإن كان لا بدّ من حوارٍ أو تسوية، فليكن من موقع الندّية والسيادة لا الخضوع، ومن موقع الوحدة لا الانقسام. فكلّ تنازلٍ اليوم تحت نار العدوان سيكون بمثابة توقيعٍ جديد على اتفاقٍ آخر…
قد لا يُسمّى “17 أيار”، لكنّ نتائجه ستكون، بلا شك، أسوأ ممّا يُتخيّل.


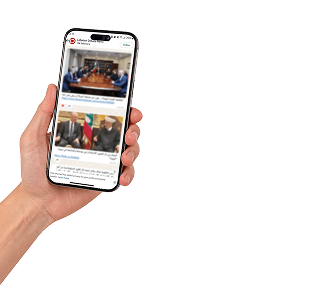




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






