منذ بدايات المشروع الصهيوني، شكّلت المشكلة الديموغرافية هاجسًا مركزيًا في التفكير الإسرائيلي. فقبل تأسيس الدولة العبرية بعقود، أدرك قادة الحركة الصهيونية أن وجود أغلبية عربية في فلسطين سيُقوّض فكرة "الدولة اليهودية"، فكتب تيودور هرتزل في يومياته عام 1895 أنّه "يجب طرد السكان الفقراء بهدوء عبر الحدود"، فيما أكد دافيد بن غوريون عام 1947 أنه "لا يمكن أن تكون هناك دولة يهودية مستقرة ما دامت أغلبية سكانها اليهود لا تتجاوز 60%".
هذه الرؤية الديموغرافية لم تكن تفصيلًا ثانويًا، بل الأساس العقائدي الذي وُلدت منه السياسات اللاحقة: من النكبة عام 1948 إلى محاولات التهجير بعد حرب 1967، وصولًا إلى الحروب والحصار في غزة حتى اليوم. فكما يوضح المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين، سعت الصهيونية دائمًا إلى إنشاء "قلعة بيضاء في عالم أسود"، أي كيان غربي في محيط عربي، ما جعل الخطر الديموغرافي هاجسًا مستمرًا للدولة العبرية.
مع إعلان قيام إسرائيل عام 1948، بدأت واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في التاريخ الحديث، طُرد خلالها نحو 750 ألف فلسطيني من ديارهم، من بينهم 200 ألف لاجئ تدفقوا إلى قطاع غزة. كان عدد سكان القطاع قبل النكبة لا يتجاوز 80 ألف نسمة، لكنّه تضاعف ثلاث مرات خلال أشهر، فتحوّل إلى بقعة مكتظة ومغلقة تُشكّل عقدة ديموغرافية داخل المشروع الإسرائيلي.
وفي أوائل الخمسينيات، برزت أول محاولة منهجية لتوطين اللاجئين في شمال سيناء ضمن خطة تشاركية بين أونروا والحكومة المصرية، تقضي بتهجير نحو 60 ألف فلسطيني من غزة إلى أراضٍ زراعية مصرية. ورغم تغليف الخطة بطابع “إنساني”، رفضها الفلسطينيون بشدة وعدّوها مقدمة لتصفية حق العودة.
وفي عام 1956، استغلت إسرائيل العدوان الثلاثي على مصر لتجتاح غزة للمرة الأولى منذ النكبة، فارتكبت مجازر مروّعة في خان يونس ورفح راح ضحيتها أكثر من 1200 فلسطيني، ترافق ذلك مع تهجير مئات العائلات إلى صحراء النقب والحدود المصرية، في محاولة واضحة لتفريغ القطاع من سكانه.
في أعقاب حرب 1967، طوّرت إسرائيل إستراتيجية جديدة أطلقت عليها "الهجرة الطوعية"، تقوم على خلق أزمة إنسانية مركّبة في غزة تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم من تلقاء أنفسهم. اقترح موشيه دايان حينها تقليص سكان القطاع من 450 ألفًا إلى 100 ألف فقط، معتبرًا أن هذا العدد هو "الحد المقبول للتعايش".
أنشأت الحكومة الإسرائيلية وحدة سرية عام 1968 لتسهيل الهجرة إلى الخارج، وقدّمت حوافز مالية للراغبين بالمغادرة، مستهدفة دول الخليج والأردن وأوروبا. لكنّ الوعي الشعبي ورفض اللاجئين أفشلا الخطة، إذ لم يغادر سوى نحو 20 ألف شخص.
لاحقًا، طرحت إسرائيل مشاريع تهجير جديدة تحت غطاء العمل، منها نقل آلاف الفلسطينيين إلى أريحا ثم إلى الأردن، وخطة أخرى لترحيل 50 ألف لاجئ من جباليا إلى الخارج، إلا أن الرفض الأردني والفلسطيني حال دون تنفيذها.
وفي أيار 1969، وقّع جهاز الموساد اتفاقًا مع حكومة باراغواي لاستيعاب 60 ألف فلسطيني كـ"عمال مهاجرين"، لكن المشروع فشل بعد أن أدرك الفلسطينيون أهدافه الحقيقية.
في السبعينيات، أطلق أرييل شارون خطة لإعادة رسم جغرافيا غزة، تقوم على تفكيك المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى جزر مغلقة، عبر هدم المنازل وشقّ طرق عسكرية لتسهيل دخول الدبابات. الهدف المعلن أمني، أما الخفي فكان إعادة توزيع السكان وتقليص عددهم.
ورغم تهجير آلاف الفلسطينيين نحو سيناء، اصطدمت الخطة برفض مصري قاطع، خصوصًا بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، وبضغوط دولية اعتبرت الترحيل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف.
بعد اجتياح لبنان عام 1982، اتّبعت إسرائيل سياسة "التهجير الصامت"، عبر الخنق الاقتصادي، وإغلاق المعابر، وتقييد حركة العمال، بهدف دفع الفلسطينيين إلى الرحيل طوعًا. كما كشفت وثائق عن خطة إسرائيلية لنقل ربع مليون لاجئ إلى "مناطق جديدة" خارج فلسطين، في محاولة لإلغاء المخيمات كمراكز رمزية لحق العودة.
عام 2005، انسحبت إسرائيل من غزة شكليًا، لكنها أبقت على الحصار كأداة تهجير حديثة. فمنذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا خانقًا، أضعف الاقتصاد وأصاب الخدمات الصحية بالشلل، ورفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تكررت الحروب على غزة في 2008 و2012 و2014 و2021، وأجمعت تقارير الأمم المتحدة على أن القطاع قد يصبح غير صالح للحياة، وهي النتيجة المقصودة ضمن سياسة "الهندسة الديموغرافية بالقوة".
في عام 2010، قدّم الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند مشروعًا سُمّي "البدائل الإقليمية"، يقترح توسيع غزة على حساب أراضٍ من شمال سيناء بمساحة 720 كم²، لتوطين الفلسطينيين هناك مقابل تنازلهم عن أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.
ورغم رفض مصر الرسمي والشعبي للمشروع، فقد بقيت فكرته حاضرة في خطط لاحقة، منها صفقة القرن (2020) التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ضمّت مشاريع تنمية خارج القطاع، خصوصًا في سيناء، في محاولة لخلق "حل اقتصادي بديل للهجرة".
عقب هجوم 7 تشرين الأول 2023، عادت فكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء إلى صدارة الخطاب السياسي الإسرائيلي. كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أنّ الخطة المفضلة للحكومة هي نقل الفلسطينيين إلى مصر ودول مجاورة، وجرى بالفعل التواصل مع واشنطن ولندن وباريس للضغط على القاهرة لقبول الفكرة.
وفي عام 2024، ظهرت ما عُرفت بـ "خطة الجنرالات" التي صاغها غيورا آيلاند مجددًا، داعية إلى فصل شمال غزة عن جنوبها، وفرض حصار وتجويع ممنهج يدفع المدنيين للنزوح الذاتي، وهي صيغة حديثة من التهجير القسري عبر الجوع.
ورغم تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الرافضة للتهجير القسري، فإن السياسات الأميركية كشفت تناقضًا واضحًا بين الأقوال والأفعال. فبينما حذّر بايدن من "تغيير ديموغرافي قسري"، دعا لاحقًا إلى "فتح الحدود أمام فلسطينيي غزة"، وخصّصت إدارته 3.5 مليارات دولار ضمن ميزانية المساعدات للهجرة واللجوء، في خطوة رآها مراقبون تهيئة لاستيعاب نازحين محتملين من القطاع.
أما دونالد ترامب، فقد كان أكثر صراحة في تبنّي فكرة التهجير، إذ تحدّث عن تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، ودعا إلى "إدارة أميركية مباشرة للقطاع"، في حين أكدت خطته الأخيرة أن "لا أحد سيُطرد قسرًا"، لكنها فتحت الباب لخيارات تهجير مقنّعة عبر مشاريع اقتصادية خارج القطاع.
من هرتزل إلى نتنياهو، ومن التهجير بالنار إلى التهجير بالجوع، لم تتغيّر جوهرية المشروع الإسرائيلي القائم على إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض واقع ديموغرافي جديد. فالحروب، والاتفاقيات، والمبادرات، لم تكن سوى مراحل متتابعة من مشروع واحد: تفريغ الأرض من أهلها، وإبقاء الفلسطيني عالقًا بين حصارٍ دائم وتهجيرٍ مؤجل.

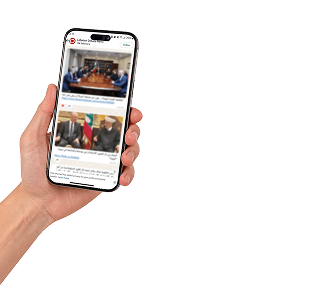



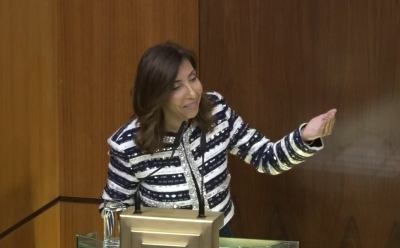
 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






