وفي تفاصيل ما حصل، تروي زينب أنها دخلت إلى المستشفى وهي تصرخ من شدّة الوجع وتبكي، فيما كان ضغطها منخفضًا نتيجة حالتها الصحية، ولم يكن يرافقها سوى شقيقها الذي لم يطلب أكثر من التأكّد مما إذا كانت قدمها مكسورة أم لا. إلّا أنّ ما واجهته، بحسب روايتها، لم يكن أي شكل من أشكال الرعاية أو التعاطف، بل صراخًا وإهانةً وُجّها إلى شقيقها داخل حرم المستشفى، على خلفية صفّ السيارة، رغم تأكيدها أن السيارة كانت مركونة بطريقة طبيعية، وشاهدت ذلك بعينها.
وتقول زينب إن الطاقم الحاضر في تلك اللحظة تجاهل بالكامل وجود مريضة تتألّم أمامهم، ولم يبادر أي شخص إلى تهدئة الوضع أو حتى توجيه كلمة إنسانية بسيطة "حصل خير" أو "تفضّلوا"، ما دفعها وشقيقها إلى مغادرة المستشفى وسط حالة من الانكسار والألم. والمفارقة المؤلمة، بحسب ما نشرت، أنّ الفحوصات اللاحقة أثبتت أنّ قدمها كانت مكسورة بالفعل، ما يعني أنها تحمّلت ساعة إضافية من الوجع بلا أي مبرّر، وبلا أي رحمة.

إن ما ورد في هذه الشهادة، إن صحّ بكل تفاصيله، لا يمكن التعامل معه كحادثة عابرة أو مجرّد سوء تفاهم، بل كنموذج خطير لتعاطٍ يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الأخلاق المهنية والإنسانية. فالمستشفى، مهما كان اسمه أو تاريخه، ليس مساحة لتصفية النفوذ أو فرض السلطة بالصوت العالي، بل يُفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للمريض، لا سيّما في لحظات الضعف والألم.
والتسليط هنا لا يستهدف مهنة الطب ولا القطاع الصحي ككل، بل يضع علامات استفهام كبيرة حول الطاقم الطبي والإداري الذي كان حاضرًا في تلك اللحظة، وفضّل التجريح والصراخ على أداء واجبه الإنساني. فالتقصير في التعامل، والتجاهل، والفظاظة، لا تقلّ خطورة عن الخطأ الطبي نفسه.
انطلاقًا ممّا سبق، يوضع ما حصل برسم وزارة الصحة. فالمطلوب اليوم ليس فقط فتح تحقيق في هذه الحادثة، بل إعادة التأكيد على معايير واضحة للمساءلة، وتذكير إدارات المستشفيات وطاقمها بأن المرضى ليسوا أرقامًا ولا حالات عابرة، بل بشر لهم كرامتهم وحقّهم في المعاملة اللائقة.
فالمستشفى، كما قالت زينب في منشورها، ليس مجرّد مبنى وأجهزة وفواتير… المستشفى أخلاق قبل أي شيء آخر. وعندما تسقط الأخلاق، يسقط معها كل ادّعاء بالإنسانية والرعاية.

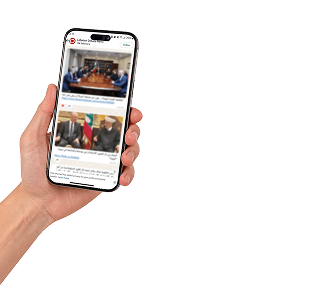




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






