الأخطر أن هذا المشهد يتشكّل في لحظة تحاول فيها الدولة إعادة تعريف سيادتها، فيما بيئات بأكملها لا تزال خارج بيوتها، تحت النار، ومن دون أفق إعمار أو حماية أو عودة.
ما جرى في منطقة سليم سلام اول من أمس لا يمكن قراءته كحدث عابر أو تحرّك احتجاجي محدود. في السياسة اللبنانية، عندما ينزل الخلاف إلى الشارع، وفي قلب بيروت تحديداً، فهذا إعلان عن انتقال السجال من دائرة الرسائل المضبوطة إلى منسوب أعلى من الضغط. والأهم أن هذه الرسالة لم تصدر عن خصم تقليدي للعهد، بل من بيئة لطالما وُصفت بأنها شريكة أو متفهّمة لمسار الحوار القائم، ما يمنحها دلالة سياسية مضاعفة.
اللافتة التي رُفعت بعبارة "الحقيقة هي ما ترون لا ما تسمعون" لم تكن شعاراً إنشائياً. كانت اتهاماً مباشراً لمقاربة الدولة، وتشكيكاً بقدرتها على ترجمة خطاب السيادة إلى حماية فعلية. حين تُربط صورة رئيس الجمهورية بصور تهديدات إسرائيلية وخرق مستمر، يصبح المعنى واضحاً، الوقائع على الأرض لا تطمئن، وما يُقال سياسياً لا يبدّد الخوف ولا يوقف النار.
لكن لفهم هذا الاعتراض، لا بد من طرح السؤال الجوهري، ماذا يريد العهد؟ رئيس الجمهورية يحاول، منذ بداية ولايته، تثبيت منطق الدولة كمرجعية وحيدة للقرار، عبر مسار تدريجي يتجنّب الصدام الداخلي، ويستند إلى المؤسسات وإلى دعم خارجي واضح، وخصوصاً للجيش. هذا المسار ليس سرياً ولا ملتبساً، بل معلن، ويهدف إلى إعادة إدخال لبنان في خانة الدولة القابلة للدعم، بعدما استُنزف لسنوات بفعل ازدواجية القرار وتناقض المرجعيات.
غير أن هذا المشروع يصطدم بواقع أشدّ قسوة. إسرائيل لا تنتظر نتائج النقاشات اللبنانية، ولا تُكافئ أي "مرونة" سياسية، بل تصعّد بالنار، وتوسّع رقعة الاستهداف، وتفرض وقائع ميدانية تُفرغ أي مسار تفاوضي من مضمونه. هنا تحديداً، يتعقّد المشهد، فالدولة تطلب وقتاً ومساحة، فيما العدوان يسرّع الإيقاع ويضغط على الأعصاب والبيئات قبل السياسة.
في هذا السياق، تصبح قراءة موقف البيئة الشيعية أساسية. هذه بيئة ما زالت مهجَّرة، بيوتها مدمَّرة، خسائرها البشرية مفتوحة، ولا ترى أمامها أي مسار فعلي للإعمار أو العودة. بالنسبة لها، الحرب لم تنتهِ، والعدوان مستمر، والدولة عاجزة عن تقديم ضمانات أو تعويضات أو حتى جدول زمني واضح للخروج من الكارثة. في مثل هذا الواقع، لا يعود الغضب خياراً سياسياً، بل ردّ فعل طبيعي على شعور متراكم بالغبن والعجز.
هنا، يصبح الشارع أكثر من وسيلة ضغط. يتحوّل إلى مساحة تنفيس خطرة، قابلة للاشتعال عند أي شرارة إضافية. والسؤال لم يعد ما إذا كان الشارع سيتحرّك، بل متى وكيف وبأي سقف. فبيئة دُمرت بيوتها وقُتل أبناؤها ولم تُفتح أمامها أبواب الإعمار، لا يمكن ضبطها بخطاب عقلاني مجرّد أو بوعود مؤجّلة، وخصوصاً إذا استمر تلاقي العدوان الخارجي مع ضغط سياسي داخلي يُقرأ، في هذه البيئة، على أنه استهداف إضافي.
الأخطر أن أي انفجار غضب في هذا السياق لن يبقى محصوراً بعنوان واحد. قد يبدأ احتجاجاً على العدوان، ثم يتحوّل إلى رفض أوسع للمسارات السياسية القائمة، وربما إلى نقمة شاملة على الدولة، إذا ترسّخ الانطباع بأنها تطلب الصبر ولا تقدّم شيئاً في المقابل. عندها، يصبح ضبط الشارع أصعب بكثير من ضبط خطاب سياسي أو تفاوضي.
هذا ما يجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية. الرئيس جوزاف عون يقف عند أخطر مفترق في عهده، المضي في مشروع الدولة يعني حكماً الاحتكاك بواقع داخلي مأزوم، والتراجع عنه سيُقرأ فشلاً مبكّراً وخسارة لما تبقّى من ثقة داخلية وخارجية. في المقابل، خصوم هذا المسار يدركون أن الضغط الشعبي قد يكون ورقة فعّالة لرفع الكلفة السياسية، خصوصاً في ظل العدوان المتواصل وغياب الإعمار.
هل نحن ذاهبون إلى صدام؟ الصدام ليس قدراً محتوماً، لكنه بات احتمالاً واقعياً إذا أسيئت إدارة المرحلة. فإذا استمر تلاقي الضغط الإسرائيلي مع احتقان الداخل، وإذا لم تُفتح مسارات جدّية وسريعة لمعالجة الجرح الاجتماعي المفتوح، فإن الشارع قد يسبق السياسة، ويفرض معادلاته خارج المؤسسات.
المسؤولية اليوم ثقيلة. لا يمكن بناء دولة على أنقاض بيوت لم تُعمر، ولا فرض منطق السيادة على بيئات تشعر أنها تُستنزف من دون مقابل. كما لا يمكن مواجهة إسرائيل ببلد منقسم على نفسه. المرحلة المقبلة ستكون اختباراً لقدرة العهد على الفصل بين مواجهة اسرائيل وإدارة الخلاف الداخلي، وعلى منع تحويل السيادة من مشروع إنقاذ إلى شرخ داخلي.


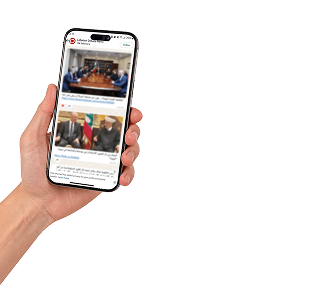




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






