كأننا عُدنا نعيش زمن الجدران المرفوعة، بعد سقوط جدار برلين من رموز العزل والفصل، بين شعب واحد، وسقوط الستار الحديد السوفياتي، من خلال الجنون العنصري، والديني، والمذهبي، والحروب. جدران الدم. والخوف. والتقهقر. والموت، خصوصاً في ظل أزمة المهاجرين، أو اللاجئين، أو النازحين، هروباً من جدران أخرى، هي العنف، والقتل، في سوريا، والعراق. فالجدران تعني، في ما تعنيه كأشياء ورموز، الفصل «فصل المجتمعات، والجماعات القومية، والاثنية، والدينية، وحتى الايديولوجية» وانتزاعها من أماكنها.
الجدار هو العازل. والقاطع: وهو في كل ذلك «عمل شنيع«. قاتل، يعبّر عن الأنانيات، والنرجسيات، والعزلات المظلمة والهويات المغلقة على ذاتها. أو فلنقل المستنقعات الآسنة. وبدلاً من ان تتحول الجدران جسوراً بين الأمم والشعوب، ها هي ترتفع اليوم، مهددة بزمن الانقسامات البائسة، والعمودية. الجسر للتواصل، للحياة، للتقدم، للاكتشاف لانتصار الاختلافات الخاصة، والمصائر المرسومة، واشكال التهجين، (لقاء تفاعل الآخر بالآخر). فالذوات البشرية، إذا لم تحاور، وتمشي، وتجري كالنهر، تستنقع، أوبئة وعنصرية، ويباباً، وعقماً. المجرى، الذي يلون الزمن بالتعددية، والتواصل. هذه الذوات إذا اكتفت بمحاورة ذاتها تنتن وتتعفن وتندثر كان لبنان، قبل حروب الجدران المذهبية، والطغاة، بلا جدران. مفتوحاً بأبوابه، ونوافذه، وتواريخه وثقافاته على كل العالم. وكان هذا سرّ غناه وتميزه، وتقدمه، وجعله مسرحاً للإبداع والتواصل. كأنما كان بحدوده المرسومة لا نهائي الفضاء حدود لامحدودة ضمن حدود معينة. مرسومة، بناسها، وقيمها، وعيشها، وحريتها، ونفاذها الى «الغير». لكن الجدران هنا، برمزيتها المادية، والمعنوية، كأنها تقف دائماً على حافة خطر، أو على تهديده لمكوناتها أيضاً، وكائناتها، وهوياتها وأمكنتها وتاريخها، إذا ما تم تجاوزها بحدود أخرى طاغية.
إنه المعنى الآخر للجدار. المعنى التاريخي والمادي والروحي. فمن عازل قاطع يبدو خطوطاً مرسومة للمصائر، حدوداً تختلف تقسيمها الارادات الفوضوية والعنف. انها حدود المجمعات، والكائنات، والدول، والشعوب «لا مجتمع من دون حدود ولا حدود من دون مجتمع». وبهذه الصفة، لا تعني «الحدود» هنا إشهار الكراهية. وإذا كانت البلدان لا تكون إلا بحدودها، فهذا يعني اختلافاً بين الرمزيتين: القطع والفصل. فلبنان، موجود بحدوده، إذا عرف حده. وكذلك سوريا. أو فرنسا. فلكل حدود «حدها»، أو مساحتها الخاصة، تؤوي اختلافات الناس والمجتمعات وهوياتهم وعاداتهم وقيمهم. من هنا، القول انه ليس كل جدار (أو حدود) لكل الجدران كراهية لها. كل يحب جدرانه: في البيت، وفي المدرسة، وفي المدن. وفي تخوم البلد. انها عبور الى كل ما هو آخر. من هنا، علينا دائماً، مقاربة طبيعة هذا الجدار، او ذاك. أسئلته المميزة، اي كنقطة لقاء، أو إرتقاء، أو كنقطة اعتساف أو عزل، أو هيمنة من حدود أخرى، ماحية حرية التفكير، والمكان والعبور والحركة، واغتناء الهويات. وهنا بالذات، نرى انفسنا بعد كل الحروب التي اقتلعتنا، وقولبت مخيلاتنا، وجمدت الدماء الحية فينا، وجرفت كل ما هو خاص بنا (أي جدراننا)، متمسكين بهوياتنا، إذ ليس كل هوية هي شريرة، ما عدا الهويات القاتلة، التي تختزل كل هويات الكائن بواحدة، مغلقة، سواء المذهبية، أو الايديولوجية، أو الاجتماعية...
الحماية
لكن ماذا نفعل أحياناً، لحماية ما نحن فيه وعليه، وما نحلمه ونحسّه، وما نطمح إليه، ويستشعرنا بحرية الاختيار سوى مواجهة جنون العواصف اليوتوبية، وسيول الوحول «الايديولوجية» وأوبئة البنى الاستبدادية، التي تمنع الوضع الانساني برمته من تحقيق ذاته أو التعبير عنها، فتحاصره، لكي تستنزف كل دفاعاته، وصموده، فينساق لها، بارادته أو بخضوعه، أو بعجزه. هذا بالتحديد ما نعيشه منذ عقود مع إسرائيل. وكأنما لا تكفي جدران الكراهية، والإبادة، وسلب فلسطين بحدودها، فها هي اليوم، ترفع جدار الفصل العنصري بينها وبين الفلسطينيين. وها هي بعدما عززت حدودها اليوتوبية «الشريرة»، وحيطان عنصريتها، تفيض عن كل حدود لها والآخرين (أو ما تبقى لهم)، وتجتاحها وتنتهكها حتى صارت معها كل حدود خطراً. وموتاً. وهجرة. ووحشية.
مستوطناتها جدران ومدنها جدران، ونظامها جدران. هذا ما عنيناه في مطلع المقالة عن «جدران الشر». واللافت. ان جدراناً كثيرة تساقطت، بعد الحرب العالمية الثانية، وقرّر العالم الانفتاح على نفسه بهوياته، وألوانه، وأشكاله، وكائناته، إلاّ هذا «الكيان الصهيوني» غير «الكائن» إلا بنفي الحق، والآخر، والوجود. وبهذا المعنى كاد لبنان يصير (على شاكلة إسرائيل) «كيانات» كراهية، وعبثية، وجدراناً، تنمي التعصب المذهبي، والطائفي: «صراع هويات قاتلة» ونظن ان خميرة «الشر» التي بقيت بأمان في إسرائيل وفي سواها، ها هي، اليوم، بعد أزمنة انفتاح الشعوب، والتواصل، وتكنولوجيات الاتصالات، تسقط في زمن الجدران: (فرنسا، المنارة الفكرية، بلاد باسكال، وديكارت، وسارتر وكامو، كأنها باتت جدرانها من نسيج ما نراه عندنا).
جدران الحروب
فالحروب والغزوات ما هي إلاّ تدمير للجدران الواقية. والأعراف، والمشاعر، والعلاقات، والتخوم الخاصة. إلغاء كل حدود لمصلحة «حدود فائضة»، تدمير كل الجدران لاقامة جدران أكبر وأضخم. وكأنها بُني التاريخ على الجدران، والأسوار. وعندما نعود إلى حروبنا في لبنان، منذ 1975(وحتى اليوم)، لا نجد في آثارها، وطوابعها، سوى ما تفعل الجدران المذهبية بالشعوب. انها الكانتونات المذهبية في كل مكان: الشارع صار حدوداً فائضة على الشارع. صار الشارع كانتوناً. والأشجار، والافراد، والجماعات كانتوناته، واللغة، والاعلام، والمناطق: جدرانه مذهبية عازلة ومتدفقة بالكراهية، والقتل، والالغاء: انها هوية «اللاهوية»، ويوتيبية «اللايوتوبيا»، والحدود اللاحدودية هيمنت على كل لبنان. الماضي نفسه، وتواريخه، وإنجازاته، ووقائعه، تعفن في كانتونات الراهن. هنا بالذات يمكن القول بموت التاريخ، أي عندما يقرأه الحاضر بعيون انتقائية قاتلة. عندها يُصبح كل شيء مباحاً. والغريب ان الماضي والحاضر والمستقبل، (اي التأريخ) تتحول كل قراءة «خاصة» به، معزولة، ككل الأمور، والأديان والفلسفات. الثورة الفرنسية حاولت إلغاء الماضي، لتبشر بالمستقبل، وهذا ما فعلته الثورات «المستقبلية» المتلاحقة في الاتحاد السوفياتي وفي الصين الماوية، والكاستروية، وكذلك ما فعلته بعض الانقلابات العسكرية العربية «الثورية». وفي المقابل كأننا نعيش اليوم ما يعاكس «حلم» المستقبل، والتقدم، والتطور؛ اي العودة بالماضي ليحل محل الحاضر والمستقبل؛ هذه العودات المنهجية كانت تتهم بالرجعية في زمن المكونات التقدمية، في وقت باتت تُتهم «المستقبلية» والتقدمية «الحلمية» باليوتيبات الايديولوجية القاتلة. وقولة «موت التاريخ»، و»نهاية التاريخ»، و «موت الانسان»، وموت الفكر.. كلها تصب في هذه الجدران الجديدة التي استعادت التاريخ بتفسير الماضي، لتدمير الحاضر والمستقبل. وبدلاً من الفكر الصيروري الذي يشبهه بالنهر، وبدلاً من «الجنات الموعودة« في المستقبل، بزوال الفوارق والطبقات والدول لتنتصر الطبقات والديموقراطيات والليبراليات.
ها هي تتماثل أمامنا جدران الماضي: العودة إلى «الجواهر» بدلاً من الظواهر، العودة إلى الاثنيات بدلاً من المجتمعات. العودة إلى الهوية الواحدة، بدلاً من التعدديات الاجتماعية والفردية، العودة الى الغرائز بدلاً من العقلانية، العودة الى العنصرية بدلاً من التهجين والتواصل، العودة إلى الأصل منتناً بدلا من الجذور الحية، العودة الى مستنقع الجدران المغلقة، بدلاً من الأنهر الجارية. هذا ما نراه اليوم في فرنسا التي تحول بعض منها غيتوات مذهبية أو دينية أو عنصرية، تقلب مفاهيم الثورة الفرنسية المفتوحة، الى ما يناقضها، بقيمها الثورية، ووطنيتها، وعلمانيتها ومدينيتها: كأنما تعفن اليوم كل الارث الذي جعل من فرنسا رائدة التنوير، والتعدد، والانفتاح، والحرية، والتواصل: غيتوات للضواحي (عربية ـ إسلامية). غيتوات يهودية، غيتوات كاثوليكية (عادت الكاثوليكية الى بلاد ديكارت وجان جينيه والماركيز وفولتير وروسو) غيتوات افريقية، وانعكس كل ذلك على الأحزاب والبنى، والناس: الكراهية، والتعصب، والانغلاق، وضياع بوصلة اليمين واليسار، الشيوعي والاشتراكي، المتطرف اليميني (لوبان)، واليساري، والليبرالي. كانت فرنسا الجدران موصولاً للابداع، والطليعية. وها هي اليوم محكومة بالجدران التي هدمتها ثورتها في نهاية القرن الثامن عشر، بل لتعود ربما الى القرن السادس عشر وتذكرنا بالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت (ملايين الضحايا وعشرات المجازر).
مجزرة باريس
ان المجزرة التي ارتكبها الارهابيون في قلب باريس ليل الجمعة الماضي، وأودت بحياة 120 ضحية من خلال سبع هجمات متزامنة، هدفت الى اعلاء الجدران السياسية في فرنسا، بأخرى دموية، فهل كان يستهدف الارهاب فرنسا (وتاليا أوروبا)، للحؤول دون استقبالها المهاجرين من المسلمين والعرب والأفارقة؛ هل تعني عقاب فرنسا لتدخلها العسكري في سوريا ضد داعش وضد نظام بشار الأسد؟
هل تعني تعميق الملابسات بين بعض القوى اليمينية ذات الكراهية ضد المسلمين العرب، تثير ردود فعل عنيفة ضدهم. هل تعني رفع جدران «الفصل» بين المسلمين واوروبا والعالم؟ هل تعني تعميق الكانتونية القائمة بين المكونات الاثنية والدينية في فرنسا؟ هل تعطي جرعة زائدة للمتطرفين في الضواحي لكي يعززوا خروجهم على الدولة وعلى الانتماء، في ما يشبه الاقتلاع القاتل؟ هل لتزيد من سعير حروب الهويات التي يُنظّر لها اليمين المتطرف، واليمين الآخر الذي يصب فيه وعلى رأس الاول لوبان، وعلى رأس الثاني زمرة من «المفكرين» والفلاسفة والصحافيين امثال زيمور والصهيوني فينكركرافت؟ ان هذا التفجير الارهابي في قلب باريس، وفي حاضرتها (ملعب كرة قدم، قاعة استقبال، مسرح مطعم)، تعزيز قوة هذا اليمين الشعبوي تمهيداً لفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث تختفي كل الأصوات اليسارية العاقلة، والجمهورية، امام زعيق هذا اليمين. فرنسا لم تخل بعد من اصوات تدعم فلسطين، وتؤازر الضواحي وكانتوناتها، مطالبة بمساواتها المواطنية، مقابل اعراض الاحتقار، والدونية، والنبذ والاهمال؟ وهنا نستحضر اسماء أساسية تدين استهتار الحزب الاشتراكي بوضع الأقليات الأثنية والدينية وتناقضاته، وخيانته للقيم الجمهورية، بل ولمفهوم الدولة الحاضنة للجميع، امثال الفيلسوف الكبير ادغار موران...
أتكون فرنسا بعد العملية الارهابية مختلفة عن فرنسا ما قبلها؟: إعلان حالة طوارئ، اغلاق الحدود، هما اجراءان قد يبشران بسلوك أكثر انعزالاً ضد الاقليات والمهاجرين الجدد، وبكراهية أشد وأفظع مما هي عليه عند بعض اليمين الشعبوي؟ هل ستطاول الاجراءات المس بالحريات الشخصية، والجماعية، تحت شعار حماية «الأمن القومي»، ومكافحة الارهاب؟ هل سيتحول وجه فرنسا كلها، ليتحول ناسها مجرد ردود فعل فورية (سبق ان تعمقت)، ضد كل من هو إسلامي أو عربي أو إفريقي؟ أي تتكاثر الجدران النفسية والدينية والعنصرية فلا تكون فرنسا آنئذ هي فرنسا التي نعرفها، ولا تنويرها الذي نعرفه سوى ظلامية، ولا رحابها سوى سجون؟ هل ستنتقل فرنسا من زمن المساواة والاخوة والحرية الى زمن التفرقة، والفتن... ربما وصولاً إلى حروب أهلية؟ إنها أسئلة مطروحة، نتمنى على الشعب الفرنسي (الذي لم تجرفه بعد موجات الشعوبية) تجاوز كل ذلك. فهل يفعلها؟ لكن نظرة مبسطة إلى مثقفي فرنسا اليوم وأحزابها اليمينية والاشتراكية واليسارية، لا تبشر كثيراً بالخير. وكلنا يعرف ان منصات التلفزيون، ووسائط الاتصالات، وحتى الصحف (ما عدا ليبراسيون، ولوموند، و«نوفيل اوبسرفاتور) تهيمن عليها الاصوات المبتذلة، والسطحية، والجاهلة، والمتعصبة.. فزمّور حل محل ريمون آرون، و فينكركرافت حل محل سارتر وكامو، ومارين لوبن حلت محل ديغول، وريجيس دوبريه مشوش بين اكتشافه الكاثوليكية ونعيه اليسار. ما زالت فرنسا حتى كتابة هذه السطور مصدومة بهول الكارثة الارهابية، مفجوعة بدموعها، تماما كما كان لبنان على امتداد أكثر من اربعة عقود: مسرحا لارهاب الميليشيات. والتفجيرات اليومية، وايامه السود: من السبت الأسود، إلى الاثنين الأسود، إلى ايار الاسود، وتشرين الأسود، والعام الأسود والعقد الأسود.
ونكبة برج البراجنة
آخر نكبات لبنان الارهابية كان في يوم الخميس الاسود، عندما تعرضت برج البراجنة لعملية إرهابية اسقطت اكثر من اربعين شهيداً ومئات الجرحى. كأنه التفجير نفسه الذي حدث في باريس. والدموع نفسها. والمخاوف نفسها. لكن السؤال: من سيتعلم من الآخر فرنسا من لبنان، أو لبنان من فرنسا، ومن سيحفظ درس التماسك، والصمود، وكل ما حولنا جدران دموية، وموت، وهجرات، ومقابر؟
ان الالتفاف الكلي الذي اظهره اللبنانيون تضامناً مع اهلهم المنكوبين في برج البراجنة، نتمنى ان يثمر وعياً أعمق، واسلم بما قد ينتظرنا من أهوال جديدة اذا لم تسقط كل الجدران المذهبية والسياسية، لتبنى مكانها جسور المستقبل، والجمهورية، والعدالة، وثقافة الحياة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


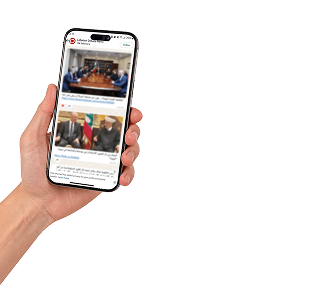




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





