منذ أحداث 1958 بدأت أواصر الاستقلال الطرّي العود تهتز. كأنما عودة مقنعة إلى زمن الانتدابات الممتدة من القرن التاسع عشر. لم يكن مضى أكثر من 13 عاماً من نيل الاستقلال حتى اعتكر: الوحدة بين مصر وسوريا وصراعاتها الخارجية، اختارت لبنان ساحة لمعاركها الخارجية وتصفية حساباتها. بل كأنّ هذه الأحداث كانت «بروة« للحروب المقبلة التي فجّرتها بوسطة عين الرمانة عام 1975، واندلعت طويلاً، حروباً مذهبية وما زالت حرائقها ودخانها مشتعلة حتى الآن. فإذا كان الاستقلال يعني المناعة ضد التدخلات الخارجية، والاحتكام إلى عناصر الأمة الشعبية لتكون السيدة في الانتماء والحكم والانتخابات بثقافة السيادة والديموقراطية والحرية والعدالة أي بتظهير الإرادة الوطنية اللبنانية المستقلة كعنصر أساسي ونهائي، فإن معاني هذا الاستقلال الهش تعرّضت لتشويش هذه الإرادة واستلابها وامتصاصها ومصادرتها.
وها هو عيد الاستقلال الثاني والسبعين اليوم يُطل باستقلال غير ناجز استمراراً لما كان عليه في زمن الحروب الطائفية: لا سيادة على الحدود، لا سيادة في مجلس النواب، ولا في الحكومة، ولا في الدولة كمختزلة مؤسساتها كل هذه العناصر.
واذا كان «اتفاق القاهرة» الذي تمّ تحت رعاية الرئيس عبدالناصر ضربة حاسمة لاستقلال لبنان من خلال تسليم المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل الجنوب اللبناني ووافق عليه مجلس النواب بشبه اجماع، وعارضه نواب الكتلة الوطنية وحدهم برئاسة العميد ريمون إده الذي اعتبره مسّاً بسيادة لبنان، فإن مجلس النواب الذي أقره تنكر لأبسط حقوق السيادة: قطعة من أرض لبنان تحت سيطرة قوة «خارجية» أي فوق سلطة الدولة. لا دولة إذاً في «فتح لاند» ولا قرار لها في الحرب ولا في السلم في الجنوب... امتداداً حتى إلى بيروت.
نقطة سوداء كبيرة، بل كرة ثلج سوداء، تدحرجت وتضخمت على امتداد الحروب لتشمل كل لبنان. الجيش حامي الاستقلال تمّ تقسيمه كالشعب، والمؤسسات وقوى الأمن، وباتت البلاد نهب إرادة كانتونات مذهبية، لها استقلالها وسيادتها كل منها ينتمي إلى الخارج لحماية هيمنته وشرعيته، وكيانات متصارعة تحوّلت «ميكرو» شعوب من آخر عناوينها «لبنان» ووجوده ومصيره وتاريخه وجغرافيته وحدوده.
مع هذا، كانت الانتخابات الرئاسية خطاً أحمر، ولم يتخل أحدٌ عن الحفاظ عليها، والمضي في إجرائها، وسط كل المعارك، وخطوط التماس (الكانتونية) وقصف مجلس النواب للحؤول دون قيامهم بهذا الواجب: إذاً بقي الرئيس رمزاً تجريدياً عاجزاً، لكنه بقي. بقي الرأس وتوزّعت الأطراف. لكن حتى هذه العملية الانتخابية كانت تعبيراً عن غياب السيادة ولو جاءت برئيس... سيادي، وهو غير سيادي. إنه الرأس، تتقاذفه الإرادات الخارجية: اسرائيل ومنظمة التحرير وسوريا والعراق وليبيا. بأدوارها المرسومة. وانتخاب رئيس لم يكن أكثر من تذكير بلبنان أو بالحنين إلى السيادة، أو بتذكر الحدود، أو الدستور، أو دور مجلس النواب.
العَلَم
اليوم، يهل عيد الاستقلال: الكل يحمل علم البلاد، كرمز لوحدته، تماماً كما كانت ميليشيات الحروب الأهلية الخارجية، لكن العلم، كأنه بات فاقداً رمزيته بوجود رمزيات مذهبية أعظم وأقدس منه. وإذا كانت الميليشيات الكانتونية كلها حافظت على هذا الإرث، فان العلم اليوم، نصفه ممزق والنصف الآخر يدافع عن قماشته وألوانه ومعانيه تحت أعلام أخرى. استقلال بلا رئيس، ولسان حال المُعطلين اليوم يقول إما أن نأتي برئيس غير سيادي (كما أيام الوصاية السورية الاسرائيلية)، أو لا تكون انتخابات رئيس: ولا رمزية ولا دستور. والغريب، أن معطلي انتخاب الرئيس «يحتكمون« إلى الدستور ويدّعون الدفاع عنه ليعطلوا الدستور، ويتكلّمون عن الميثاقية ليعطلوا الميثاقية وعن مصلحة البلد ليعطلوا البلد. وهكذا صنعوا من لبنان نموذجاً فريداً، يكون المثال الساطع لدولة بلا رئيس. لبنان وحده بلا رأس. حتى أحزاب لبنان كلها تتمتع «برؤوسها» ومخوخها. كلها عندها رئيس (أو وارث) ما عدا لبنان. الأطراف تحوّلت «رؤوساً» عبثية، عدمية بل أكثر: بات علم كل حزب له رمزية و»سيادة» الحزب ما عدا العلم اللبناني الذي يرفرف فوق كل هذه الأحزاب كطير مهاجر، فأي بلد هذا، خلع رئيسه وقطع رأسه مؤمناً بأن الأطراف والأعضاء يمكن أن تستمر في حياتها ووظائفها المطلوبة من دونه، والمشكلة خارجية أولاً وأخيراً. بالأمس كانت الميليشيات الكانتونية، واليوم الميليشيا المشابهة بجنونها وعمالتها حلّت محل الجميع، بسلاحها ووكالتها الخارجية المذهبية لتنسف موقع الرئاسة. «حزب الله« يتمتع بأمين عام ما زال قائداً له منذ عشرين عاماً ليكتفي بإنجازه القيادي ويستمر في مهزلة تغييب رئيس البلاد. كانت الوصاية السورية تنتخب رئيساً لها في لبنان. رئيساً وصائياً على شعب تحت الوصاية. وهذا ما حاولته منظمة التحرير، ونجحت فيه اسرائيل. كأنما الرئاسة بعد عام 1958 باتت شأناً «خارجياً» (كاتفاق القاهرة) رئيس لبنان رهينة وصاية خارجية! لكن في النهاية: فالرئيس موجود شكلياً، لفظياً، لكنه موجود. وكذلك الحكومة: التي كان يعيّنها الرئيس حافظ الأسد ثم وليده المفدى بشار الذي صار بدوره رأساً بلا رأس في دولة مدمرة تحت الوصايات، فمن واجباته القومية وقواعد الصراع مع اسرائيل، والقوى الأخرى أن يعيّن الحكومة اللبنانية ويحكمها، ويتدخل في الانتخابات النيابية ويمد يده إلى المؤسسات الأمنية، حتى تعيين ناطور أو موظف في هذه الدائرة أو تلك.
مع هذا، كان عيد الاستقلال هو المحتفى به في يومه. الرئيس محاط برئيس المجلس والحكومة وعلى المنصة ضباط سوريون وغازي كنعان ورستم غزالي والرئيس بالطقم الأبيض. فما أجمل الأبيض على رئيس ليس رئيساً، وعلى برلمان ليس برلماناً، ووزارة ليست وزارة. لكن مع هذا كان هناك برلمان في حدود متواضعة، ووزارة في عمل يقتصر على التدابير الإجرائية (السياسة الخارجية في أيدي الوصاية السورية).
الجدران
صحيح أن الميليشيات التي سبقت حزب إيران أقامت جدراناً وحدوداً رمزية ومادية، وخاضت حروب الآخرين لكنها اقتصرت على لبنان: مشروعها (الخارجي) داخل الحدود اللبنانية (المستباحة بالطرق العسكرية) لم يتجاوز إلى التدخل في الشؤون العربية، مشاريعها كانتونية، بمقاومات عدة؛ لكن الثورة الفلسطينية حاولت وهذا الخطأ الأساسي أن تستثمر كل هذه الصراعات لمصلحة مشروعها الفلسطيني واسترداد بلدها السليب. وهنا بالذات تداخلت الأوراق الخارجية، لتكون صراعاً بين الانتماءات: وهنا بالذات تكاثرت لغة «التحرير»: من تحرير لبنان من «الاحتلال» الفلسطيني (خدمة لسوريا أو لإسرائيل) أو تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي (المقاومة الوطنية تحت مظلة الحركة الوطنية والقيادة العسكرية المشتركة)، أو «تحرير» الورقة الفلسطينية من أيدي عرفات أو دعمها في سلطته تحت رعاية ليبيا والعراق، تمويلاً وسلاحاً. كان هناك إذن زحمة مقاومات وعناوين تحرير تمت كلها بالدم اللبناني. وها هي سوريا، مدعومة من بعض الميليشيات اليمينية تخترق هذه الاصطفافات القاتلة لتواجه الحضور العرفاتي ونزع الشرعية عنه باعتباره بحسب الإعلام السوري «عميل إسرائيل». لكن، وبعد الاتفاق السوري الإسرائيلي عام 1974 كأنما انعقدت بينهما اتفاقية تصفية الوجود الفلسطيني المسلّح؛ وهذا يفسر غزوة عام 1982، التي سبقها إسقاط مخيم تل الزعتر، وتلتها حروب المخيمات والشمال بواجهات مسيحية هنا، وإسلامية هناك.
استقلال الحزب
لكن عندما أنشئ «حزب الله« في إيران ليكون ذراعها المسلحة في لبنان (سيناريو المقاومات السابقة)، ثم صُنعت المقاومة الشيعية على أنقاض المقاومة الوطنية العلمانية، وبعد الهيمنة السورية الشاملة على لبنان إثر حرب «التحرير» العونية، انتقل لبنان من زمن الميليشيات المحدودة لبنانياً إلى زمن ميليشيا مشروع لبنان كله تحت السلاح الإيراني (خصوصاً بعد انسحاب الجيش السوري من البلد بعد ثورة الاستقلال) والمرتبط بمشروع أكبر لصياغة «الهلال الصهيوني الإيراني». من هيمنة مقاومات متصارعة إلى مقاومة حزبية واحدة تختزلها كلها. هنا بالذات تحوّل تخريب لبنان الميليشيوي إلى تدمير الكيان كله: من كيانات «محلية» إلى كيان آخر، استهدفت فيه الدولة كوجود وكرمز، والجيش، والحدود، والتاريخ: هنا يولد لبنان الآخر مع «حزب الله«: بين تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي إلى تسليمه كلياً إلى احتلالين إيراني سوري. وما لم تجرؤ الوصاية السورية على ارتكابه، ارتكبه حزب إيران: ليس فقط إضعاف المؤسسات بربطها بالوصاية السورية، بل تعطيلها، وتفخيخها، وانتهاكها، وغزوها غزو التتار: فالجيش الذي كان في عهدة سوريا... يريدونه وجوداً تابعاً للميليشيات المذهبية... والدولة يريدونها أشلاء بلا أطراف ولا حكم ولا حكومة ولا برلمان. لا شيء، فمعانيها ووظائفها في أيد عميلة لإيران. لا استقلال إذاً. لا ديموقراطية. لا حرية. لا قانون. لا قضاء. لا عدالة: فهذه المهمات كلها اختزلت في قبضة حزب إيران. وعندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، تُوّجت الانتهاكات، واكتمل مشروع «إبادة» الدولة، بقطع رأسها. لا رئيس. وحتى لا مرؤوس: فراغ مطلق. جنون مطلق. فوضى مطلقة. فحزب الله هو في النهاية حزب «فوضوي» يسعى في مرحلة الفوضوية إلى إقامة دولة وهمية بلا شروط، وعلى أنقاض الدولة اللبنانية العميقة. وهكذا يكون أمينه العام هو «المرشد» البديل من الرئيس المسلّح، القوي، الفاتك، حامل الحقيقة، والمشروع، والطريق، ليلعب دوره الحقيقي كأداة داخلية، تتمدّد إلى العالم العربي، تنفيذاً لمخطط تخريب الأمة العربية، ومؤسساتها، وتاريخها، وتنمية الفتن المذهبية خصوصاً بين السنّة والشيعة. لبنان كله يجب أن يكون منطلقاً ومحطةً لانطلاق «كتائب» إيران في مهماتها الحربية على العرب: من سوريا، إلى اليمن، إلى العراق، إلى البحرين: أي جعل الدولة العربية على شاكلة لبنان: وهمية، خرافية، بديدة، محطمة، تمزقها حروب مذهبية، لتجعل منها دويلات أو ميني دويلات تتصارع وتتنازع بلا نهاية: فلا رئاسات، ولا شرعيات، ولا مرجعيات، ولا حكومات، ولا جمهوريات. لا شيء. كلبنان. كما آلت إليه سوريا والعراق. إذاً محاولة محو الإنجازات العربية الثقافية، والحضارية (حتى القديمة)، من التاريخ: فلا تنوير، ولا ديموقراطية، ولا نهضة، ولا عروبة، ولا ماضٍ ولا حاضرٍ. وها هو لبنان اليوم، ما زال مطعوناً في رأسه. وها هو عيد الاستقلال وكأن هذا الأخير لم يكن: لا في الواقع، ولا في اليوتوبيا، ولا في الحدود، ولا في الرموز، ولا في المؤسسات. كأنه عيد استقلال الحزب الإيراني عن الدولة، وإعلان كانتونه مصدراً للسلطات، وسلاحه منتجاً الحقائق التاريخية: ألغيت احتفالات الاستقلال لأن ليس هناك من يحتفل بها، ولا يحضرها، ولا حتى من يتذكّرها: كل ذلك، مرتبط، كما سبق أن قلنا، بنيات الحزب المعلنة مرات، بأن لبنان آخر مرسوماً هو قيد التحضير: من مؤتمر تأسيسي (تراجع عنه الحزب)، ومن استبدال الطائف (تراجع عنه)، إلى مشروع تسوية: انتخاب الرئيس يأتي في سلة واحدة، مع طبيعة الحكومة، والانتخابات النيابية، ودور الجيش، والمؤسسات الأمنية، وربما ثقافة الدولة كلها. ونظن أن هذا التراجع في خطى الحزب المتورط في سوريا (3000 قتيل كرمى لإيران) مرتبط بالهزائم التي تكبدها وإيران في سوريا واليمن والعراق والبحرين. انكسر «الهلال» المذهبي الصهيوني، وانكسرت أجنحته. وها هو يسعى إلى التعويض عن كل ذلك بإنشاء دولة أضعف من دويلته، بسلاحها، وقوتها، وشرعيتها. وكما كان يحدث مع المقاومة الفلسطينية كلما ارتفع صوت بالتساؤل عن دور سلاحها في الداخل، فالنغمة ذاتها ترتفع كلما دعت الحاجة: من شروط التسوية (أو من خلفياتها)، تعزيز الكانتون الحزبي ليوسّع «استقلاله» عن لبنان، ويقوي ارتهانه بإيران. أما استقلال لبنان، كمنظور ومشروع، فهو بالنسبة إلى الحزب، مجرد «حلم ليلة صيف»: أن تبقى ربما الرموز، ولكن يبقى منقوصاً ومشوّهاً، وناقصاً، ومنفياً. فالحزب يعرف أن استقلال لبنان الناجز بأرضه وشعبه وحدوده ومؤسساته نفي له، ونهاية لدوره، ولسلاحه، وقضائه، وقوانينه، ولحدوده المرسومة بالدم في آخر الكانتونات المذهبية في لبنان، وكذلك نهاية للوصاية الفارسية.
السؤال الأساسي الذي يمكن طرحه: كيف يمكن أن يقوم حوار تسوية حول بنية الدولة، إذا كان هناك فريق لا يعترف بها. وكيف يمكن أن تناقش طبيعة الحدود الرسمية للبنان، إذا كان هناك فريق يعتبر أن حدود لبنان تبدأ من «الجنوب» الإيراني إلى طهران الفارسية؟ كيف يمكن معالجة قانون انتخابات، إذا كان الحزب يعتبر نفسه القانون الأعلى في المناطق التي يسيطر عليها بقوة السلاح؟ كيف يمكن حلّ مشكلة الرئاسة، إذا كان الحزب لا يعترف إلا برئيس خارجي له هو مرشد ولاية الفقيه؟ أي سبيل للتفاهم على قرار الحرب والسلم، إذا كان الحزب يعتبر أن هذا القرار مُلكه وحده أي ملك الإمبراطورية الفارسية؟... بل أي مفهوم يمكن الاتفاق عليه حول معنى الاستقلال، إذا كان الحزب يعتبر أن الاستقلال هو نقيض وجوده؟
كل هذا، نراجعه في ذكرى الاستقلال. لكن ما هو مبشر، وإيجابي، أن هذا الحزب بات معزولاً في أطروحاته، ومنقوصاً في استقلاله وحدوده الكانتونية تخترقه العمليات الإرهابية، وعملاء إسرائيل، وتُصدّعه تململات بيئته التي تعبّر عنها همساً، أو سراً خوفاً من جبروته.
كل ما سقناه في هذه المقالة، لا بد أن يذكرنا بأن هذا الحزب المهزوم في سوريا... سينكفئ مشروعه في لبنان، من خلال حقيقة ساطعة: إن أكثرية اللبنانيين الساحقة ما زالت حاملة معاني الاستقلال، والدولة، والديموقراطية والحرية.
فليتذكر الحزب ثورة الاستقلال بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكيف اجترحت معجزاتها؟
هذه الثورة ما زالت حية. ويحق لها وحدها الاحتفال بعيد الاستقلال!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


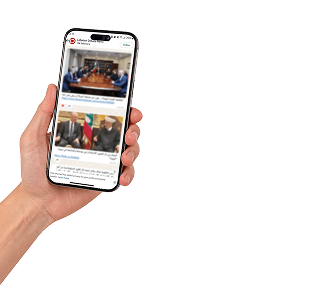
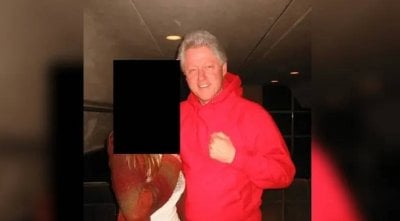



 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





