كأننا لا نستذكر شاعراً رحل من أربعة قرون، فهو ليس ذكرى. الذكرى يحدها ماضٍ أحياناً ويخذلها مستقبل وحاضر. كأن شكسبير قال للأجيال المقبلة «أكون معكم أو لا أكون» أتذكركم أو لا أكون. فهو معنا بحضور راسخ، طالع من عمق مآسينا وأفراحنا وعبثنا وجنوننا وحروبنا بكل هذه الديكتاتوريات السائدة المجذرة من مئات السنين. كأنه في القرن السادس عشر والسابع عشر. والثامن عشر والتاسع عشر... والعشرين وفي مطلات القرن الحادي والعشرين. شمسُ لا تغيب عن مخيلاتنا وكلماتنا وهواجسنا وأمراضنا ولامعقولنا ويومياتنا.
شكسبير لم يتركنا لكي نتذكره لأنه استذكر الحاضر في أعماله «الأبدية» حتى تحولت أسماء ابطاله «صفات» والقاباً نطلقها بسهولة على هذه الشخصية المعاصرة أو تلك: فمن لا يتذكر هتلر وهو يقرأ «مكبث»، من لا يتذكر المثقف المتردد العربي وغير العربي في «هاملت». من لا يتذكر في هذه الشخصية المتعددة عصور الانتقام... والجنون والتضحية والغدر.. وكم من أطفال سموا «روميو» و«جولييت» تيمناً بهذين العاشقين الشقيين (علماً ان مصادر غربية تقول ان شكسبير استوحى هذه المسرحية من قيس وليلى)، ومن لا يتذكر ديدمونه زوجة البطل المغربي عطيل، وما فرقهما من دسائس وخيانة... وغيره؟ ومن لا يلقب من العارفين ريتشارد الثالث الطاغية بحافظ الأسد وصدام حسين والقذافي ونتنياهو وصولاً إلى خامنئي؟ ومن لا يشير بإصبعه إلى عائلة لوبان وخيانة الابنة لوالدها وطرده من الحزب عندما يقرأ «الملك لير»؟
حتى من لا يخطر بباله تردد هاملت والرئيس الفرنسي هولاند أو حتى أوباما؟ أو تيمون الاثيني عندما يرى إلى أحوال المال، وأثره وسحره. بل من لا يتذكر «شايلوك» في «تاجر البندقية» ذلك اليهودي المقيت، البخيل، المجرد من كل احساس وضمير (اتُهم شكسبير بعد هذه الشخصية بمعاداة السامية).. ومن لا يتذكر رحابة شكسبير ازاء بطله المأسوي والتراجيدي «عطيل» المغربي «الأسود» ومسألة العنصرية المنتشرة اليوم؟ ومن لا يجد اليوم (وأمس) نماذج دامغة عن «الجنرال» الروماني كورليانو البطل والطاغية الذي تآمر عليه أهلوه والسياسيون فطردوه وأذلوه، ليلجأ إلى عدوه (عدو روما) ويقود جيشه للانتقام من الرومان والذي على حدود مدينته وامام جيشه الغريب وزوجته وأمه وابنه يقتل بين الحدودين؟ كم يمر ببالنا مثل هذه الشخصيات اليوم وخصوصاً في لبنان من هؤلاء الجنرالات الذين لاذوا بأعداء بلادهم للانتقام من أهلهم وبلدهم من أجل السلطة؟ (تذكروا الآن بعض جنرالاتنا وسياسيينا الذين خانوا بلدهم وحاربوه مع أعدائه طلباَ لحكم أو لطموح)... تقرأ شكسبير وكأنك تقرأ يومياتنا...
لكن ما يثير مخيلاتنا وعقولنا ومشاعرنا تلك الشخصيات التي وان حددناها في مقاربات وفي أمزجة وفي حالات إلاّ انها تتمرد على كل تفسير أحادي أو جامد، تاريخي أو نفسي، كلّ منها يتخبط في تناقضاته وتعددياته وصراعاته ومفاجآته.
صحيح أن شكسبير يرسم «نماذج» تكلمنا عنها إلا ان الصحيح أيضاً، ان كل شخصية تتوغل في ادغالها (أوليست هذه هي التراجيديا بامتياز؟). فهو كموليير (شكسبير المسرح الفرنسي) يمكن ان تسقط بعض شخصياته على ملامح ما نراه من أشخاص ومن زوايا مفتوحة: فقد رأى بعضهم في «هاملت» عدة أقنعة: 1) المثقف المتردد ، 2) وابن البلاط الثوري، 3) والرجعي المتمسك بقيم الماضي (كالانتقام لمقتل ابيه)، 4) «الأصولي» المتعصّب ازاء نظرته إلى المجتمع واخلاقياته، 5) أو «المجنون» الذي لعب دور المجنون، 6) أو القاتل بأعصاب باردة وبشكل عبثي (قتل بولونيوس والد اوفيليا)، 7) المصاب بعقدة أوديب من خلال علاقته بوالدته و(كأنه يعشقها) وبنزوعه العاطفي- الملتبس نحوها (التفسير الفرويدي) ، 8) أو الشخصية التافهة، السائبة، المجروفة، وراء سلطة ضائعة، 9) العبثي الذي ينظر إلى العالم اللامقعول ، البلا معنى، الذي تتحكم فيه المصادفات والموت (مشهد المقبرة والجمجمة في هاملت)... 10) المثقف العميق الذي يرى في قراءاته ما يعصمه عن الايمان بحقيقة ثابتة، 11) أو المسرحي الذي يفسر مفهومه للمسرح وللممثل وكيفية ادائه للفرقة التي أوكلها لعب مشهد مقتل أبيه بيدي عمه كلود بوس في القصر وكأنه بذلك يفتتح لعبة المسرح داخل المسرح، 12) المتواطئ مع من غزا بلاده ضد عمه مغتصب السلطة في آخر المسرحية. فـ»هاملت» ومن خلال هذه المواصفات والمشابهات في شخصيته هي التي اغرت كل «ممثل» بأن يلعب دوره في القرن التاسع عشر أو العشرين، أو الحادي والعشرين، في السينما والمسرح والتلفزيون... فلكل «هاملته» و»مكبثه» و»تيمونه الأثيني» و»شايلوكه».. و»كورليانه» (اقتبس برشت مسرحية كوريليانو بتفسير «ملحمي» ليشير إلى هتلر لكنه اغفل في ملحميته الأيديولوجية الجانب التراجيدي في هذه الشخصية.
لكن هل يقتصر «سحر» شكسبير على رسمه هذه الشخصيات والوقائع والتواريخ والأحداث؟ عندها سيكون مجرد شاعر ناجح يكتب مسرحاً مقبولاً أو رائجاً، يضعه في عداد سواه. فشكسبير شاعر ومسرحي، شاعر حميمي في «SONNETS« ودرامي في أعماله المسرحية وهذا قلّما نجده عند راسين أو كورنيل أو حتى عند سوفوكل، أو يوربيدس أو سينيك. ربما نجده عند أرابال أو عند أحمد شوقي، أو سعيد عقل.. لكن شكسبير أوجد فاصلاً حاسماً بين قصائده الحميمة وبين شعره المسرحي. الأولى تخضع لمختلف متطلبات القصيدة الغنائية الكلاسيكية، مع فسحة مميزة لمستويات التعبير، قصائد حب أو غزل... أو حكمة، كلها ترتبط بإرث طويل في الشعر الانكليزي، أو الفرنسي، أو الإيطالي، أو الاسباني، أو سواها. أما الشعر الدرامي فصارم في تصوير الشخصيات بسفلياتها وحقاراتها وعلوها وعبثيتها وتفاهتها. صارمة، في استبطان دواخل النفس البشرية بأعماقها وتلابيبها وغموضها وعنفها وضعفها وقوتها. فلا مهادنة في تدوير زواياها ولا تساهل في تصليب ضعفها: هكذا وجهاً لوجه بمرآة وحشية أمام الوحش، صافية امام النقاء، مجنونة امام الجنون، وهادئة امام «الحكمة»: صوّر هاملت من جوانبه المتباعدة والمتنافرة والمهتزة والمترددة والمختلة والحاسمة. لم يترك نقطة في دخيلاء هذه الشخصية إلا وتطرق اليها بمبضع التشريح. وهذا هو «شايلوك» المرابي اليهودي، البخيل، الكريه... (في تاجر البندقية) السادي، الشره، يرميه شكسبير بكل سواده على الخشبة... وها هي «الليدي مكبث» المنخرطة مع زوجها في مؤامرة الاستيلاء على السلطة تضربها الهواجس، والوساوس والتخيلات بعد القتل حتى تمكن منها الجنون: فمن امرأة تحسب وتفكر بعقل متآمر متماسك... إلى فريسة الهلوسات (كأنما عقاب الدنيا)....
[ بين الحميمي
والدرامي
لكن اذا كان هناك شكسبيران: حميمي ودرامي فما هو الفارق الشعري، أيكون سيكولوجياً أو رؤيا مسرحية أو غوصاً على التاريخ والشخصيات؟
في ظني انه اذا كنا نبحث عن شكسبير الشاعر المتفجر بلغته وتعابيره وقممه فلن نجده في «قصائده» الحميمية بل في مسرحه الدرامي: اللغة، والكيميائيات الايقاعية، والصور المجنونة وعنف الكلام العاري هنا والبلاغي هناك والكاسر في كل الأمكنة. وهذا يعني تلاقي اللغة الدرامية وطبائع الشخصيات وأحجامها وارتباطها بالوقائع والمواقف والمواقع. هناك مثلاً كتّاب مسرح عبروا عن مضامين ثورية عميقة وقدموا شخصيات غنية لكن بمستوى تعبيري دون تلك الشخصيات، المواقف: تفاوت بين معطى الشخصيات وبين ما يلائمها من لغة تتماهى بها أو أدوات قادرة على ان تتساوى معها: هنا يتميز شكسبير: شاعر أوصل لغته بوقائعها وايحاءاتها وسحرها وبلاغيتها وجنونها وفجائياتها ومرحلتها إلى جلود الشخصيات وأجسادهم وعقولهم وهمومهم ورفعهم كلهم إلى المستوى التراجيدي... وهنا لا يمكن البحث عن فوارق بين النماذج الشكسبيرية المتنوعة ومعانيها وخلفياتها ودلالاتها وبين طزاجة التعبير ومواءمته الأوضاع والأمزجة. هذه هي المعجزة الشكسبيرية اي ليس فقط في تقديم نماذج انسانية تجاوزت عصرها الينا فقط بل في العبقرية التعبيرية التي تجمع سحر الكلام وجاذبيته وجنوحه وجديده: وهنا يبدو الكلام على تنوع المواقف والطبائع وتنوع الأدوات الدرامية المعبرة: من مونولوغ كوريليانو بعد طرده من بلاده بحساسية جارحة، يائسة، مؤثرة، إلى حوارات «مكبث» وريتشارد الثالث وشايلوك وعطيل (اثناء تمكن الغيرة منه قبل أن يقتل ديدمونه) أو هاملت في «هلوساته« العبثية المتناقضة أو هذر مكبث في لحظاته الأخيرة في المعركة، أو خيبة يوليوس قيصر قبل مقتله من ربيبه بروتوس...
بمعنى آخر، جعل شكسبير لكل شخصية لغتها وللمواقف تعابيرها ومصطلحاتها وصورها واستعاراتها وكناياتها ومباشرتها وبلاغتها... من دون خيانة الدرامية المسرحية: فالشخصيات المسرحية تخضع للغة الدرامية.
وحتى عندما تبرز مواقف «غنائية» أو عاطفية فان شكسبير يوظف هذه الغنائية في خدمة النص المسرحي، وليس العكس فلا تنفصل الغنائية وتستقل عن السياق فتصيب البنية الدرامية. هذا ما فعله راسين وبن جونسون وكورنيل... لكن اتساع عوالم شكسبير تتطلب لغة تصهر كل هذه العناصر المتباعدة والشخصيات المختلفة والقصص والحكايات المتنوعة في اللعبة المسرحية: شكسبير يمسرح بقوة شعرية المواقف غير الشعرية ويذيب اللغات الشعرية في المتن المطلوب. مثلاً لا يتجاوز معجم راسين (مفرداته المستعملة) أكثر من 2000 كلمة بينما يتسع معجم شكسبير إلى 30 ألف مفردة طبقاً لتنوع الحاجات والمواقف وكثرة الشخصيات الأساسية والثانوية. وهنا الصعوبة أكبر فشكسبير سيستخدم مخزون البلاغة والبيان من تورية واستعارة وصور وتشابيه وايقاعات وجناس ليجعل منه كيميائية موسيقية، بصرية، تعزز المناخات المسرحية. أي لا تستعمل للتزويق أو للابهار الشكلي، أو لمجانية التراكيب والصور: وهنا بالذات سحر قراءة النص الشكسبيري في كتاب: قيمة شعرية لا مثيل لها حافلة بالادهاش تنزل على القارئ كصواعق جمالية وروائع بصرية وايحاءات موسيقية. لكن كل ذلك، من ضمن شروط العمل المسرحي. هذا ما فعله الشاعر والمسرحي بول كلوديل في انجازاته الشعرية الأدبية في الدراما، وهذا ما سبق ان فعله بشكل رائع سوفوكل ويوريبيدس... خصوصاً يوريبيدس شاعر المسرح الاغريقي الذي يبدو ان شكسبير تأثر بمواضيعه وبلغته المسرحية. بل يذهب بعضهم إلى القول (ومنهم الكاتب والمفكر المصري الكبير لويس عوض ان «هاملت» مأخوذة من احدى مسرحيات يوريبيدس. فشكسبير اخترق موروث الشعر الانكليزي واستفاد من تنوعه وتنوع شعرائه بتعزيز ملكاته الشعرية التي رفعها إلى مستوى المعجزة الابداعية. انه الوحش الذي افترس اللغة وليس الشاعر العادي الذي افترسته اللغة. وقد تمكن منها بطريقة جعلته يحولها عجينة بين يديه يصنع منها ألوان الخبز، والأشكال والحالات! وهذا بالذات ما يصنع شكسبير أكثر من شاعر وأكثر من مسرحي وأكثر من لاعب في جماليات اللغة (لقب شاعر صغير على شكسبير!) واذا كانت مسرحيات راسين مثلاً حدائق منظمة، مشغولة، بأدوات محددة، فان مسرحيات شكسبير غابات وأدغال وأمازونات وجدران وراءها جدران وآبار تحتها آبار وعوالم أمامها عوالم... انها الغرائز الكبرى الغامضة، المخيفة، المظلمة، أو المنقشعة، والأعماق التي كلما توغلت فيها ازدادت غموضًا، واللغة الشعرية ليست لتبسيط هذه الهندسات والمعمارية المتداخلة ولا لتجميل وحشية الطبائع، والعنف البدائي والحضاري وانما هي أداة لدفعها إلى آخر جنونها وجحيمها ودمائها ومجهولها. هنا بالذات يمكن ان نقول إن شكسبير هو ابو الحداثة قبل بودلير ورامبو ومالرمه. اقصد الحداثة القائمة على الالتباس والغموض وما بعد اللغة، وما قبلها، أي في تحافيرها وطبقاتها ومتونها... وشخصياتها. من هنا أيضاً نجد ان شكسبير بشر بالسوريالية قبل السوريالية وبالرومانطيقية قبل الرومانيطيقية وبالرمزية قبل الرمزية، وبالعبثية قبل العبثية وبالوجودية قبل الوجودية. هذه العملة النادرة في فتح طرقات غير مسبوقة عرفتها الحداثة العالمية هي التي تجعله من ارهافاتنا واحاسيسنا وهواجسنا وتحولاتنا الشعرية.. فشكسبير لأنه موجود في كل كبار القرنين التاسع عشر والعشرين: من بودلير إلى فيكتور هيغو، إلى رمبو إلى لوتريامون، إلى مالرمه، واليري وارابال وغروتوتسكي وانطوبان ارطو وكولينز ونوارينا (اليوم) وهاينز مولر، وبرشت وادوار بوند وسواهم... شعرياً ومسرحياً وفكراً وفلسفة ورؤيا لانهائية للعالم. وهذا لا يعني نفي فرادة هؤلاء ومواقعهم الابداعية الكبرى وخصوصياتهم وانجازاتهم التي اكتظ بها القرنان التاسع عشر والعشرون. لكن شكسبير موجود في كل واحد فيهم.. وفينا.
[ التقنيات
لكن هل يكفي رسم الشخصيات وقوة الشعر والدراما وعلو الرؤيا وتمددها إلى بعد صاحب «هاملت»، فكلنا يعرف أن شكسبير فنان شامل (ممثل، مخرج وكاتب وسينوغرافي بأدوات العصر آنئذ) وكوريغرافي فلكي يجسد كل هذه الاحتمالات المسرحية (والنص المكتوب مجرد احتمال) فقد لجأ إلى تقنيات اللعبة المسرحية على الخشبة، تمثيلاً وحركة واداء ومشهداً وجمالياً وادارة.
فما هي هذه التقنيات والعناصر والأدوات التي استخدمها شكسبير؟
«صنفت اعمال شكسبير في ثلاث: تاريخية، كوميدية، وتراجيدية، بشكل حاسم أحياناً. وكأن كل نوع مستقل عن الآخر ربما لتيسير المعالجة والقراءة والمقاربة.
لكنها في الوقت ذاته تسقط في احادية النوع والكتابة أو المخيلة. وهذا يعني اهمال تنوع نتاجه وتداخله وخلط مناخاته فالدراميات التاريخية مثلاً غالباً ما هي تراجيدية والتراجيديات درامية بل انها تجرد هذه الأعمال من جوانبها الخصوصية العديدة وهذا ما نجده في مسألة ما يسمى «plays» مثل «MESURE POUR » أو تيمون الأثيني، و»العبرة بالنهاية» و»ترويليوس وكريسيدا» وكذلك التميز بين هنري السادس (1590 1592) وريتشارد الثالث (1593)، و»ريتشارد الثاني» (1595) و»الملك جان» (1596) و»هنري الخامس» (1599). أما في الكوميديات فيمكن إدراج «كوميديا خواجات فيرونا» (1590) أو «كوميديا الأخطاء» و»تاجر البندقية» و»جعجعة بلا طحن» و»الزوجات السعيدات» و»ليلة الملوك» و»كما يحلو لك». وبين التاريخي والكوميدي التراجيدي «تيتوس وأندرونيكوس» (1592)، «روميو وجولييت» (1590) و»يوليوس قيصر» (1599)، و»هاملت» (1601)، و»تريليوس وكريسيدا« (1602)، و»عطيل» (1603)، و»كوريليون« (1609)... لتدخلها التراجيديات الكوميدية «Tale» (1600)، و»العاصفة» (1611) و»كازينو» (1612) (اختفت)، و»هنري الثالث» (كتابة جماعية)...
إنها النصوص المتشابكة خرج بها شكسبير عن قواعد «النوع» (كما نرى عند راسين وكورنيل وموليير)، وهي التي وفرت له، أو استنبط بها آليات رؤيته الإخراجية والديكورات والأداء والملابس والمواقف والمناخات. جنون مزج الأنواع يوازي جنون تنوع الكتابة. وقد ساعدت على تفجير مخيلته، وقراءته، وتصوراته، احتمالات الخشبة الواسعة في جدودها والتي تعبر إلى حد ما عن الجو الديموقراطي الذي وفرته العهود الاليزابيتية. فالخشبة كما رأينا من خلال رسوم نشرت في مراجع عديدة، تتقدم إلى وسط المتفرج، لتسمع بسهولة، وفي عرض واحد تطوير الأماكن، والمجاميع، والخشبة (جمهور، جيش، مواكب) لعزل المتفرج عن مقدمة العرض. وقد استخدم شكسبير هذه الوسيلة لنقل تحرك الأحزاب أو المجتمعات، وفي الوقت ذاته بين الأفراد والعواطف الشخصية، مهتماً بسماع مختلف أشكال الحوارات والمونولوغات، والسجالات السياسية وصولاً إلى التأمل الفردي، وكذلك اللعب على العلاقة بين القاعة والجمهور التي تعطي المتفرج في الوقت ذاته «الإيهام» ووعي الإيهام (برشت بعده).
ومن خلال الفن ذاته، أدخل صاحب «الملك لير» في أعماله عناصر تقنية، لا تقتصر على الموسيقى والغناء ولكن الرقص أيضاً (مسرح الفرجة في القرن العشرين)، أي الرقص الأرستقراطي في «روميو وجولييت» و»الأداءات» الشعبية في «حكاية الشتاء» وقناع البلاط في العاصفة.
ويستخدم شكسبير شخصيات شعبية بالطرق القديمة أو بأنماط حديثة مثل «المهرج» أو «الشبح» منها في «هاملت» و»الملك لير»... لكن الجديد عند شكسبير أن هذه الأدوار ليست هامشية أو تزويقية أو ترفيهية... بل تلعب دوراً في السياق المسرحي (كأداة درامية عضوية من أدواته)، وتخرج على كونها نماذج تقليدية أو نمطية، فكأنها لتكون مرآة أمام عاكسة للشخصيات...
إنه الفضاء السينوغرافي الدرامي، الذي لا ينفصل عن طبيعة الأدوار، ولا الشخصيات. ليست مجرد ديكورات أو إشارات إلى طبيعة الأمكنة (كالمسرح الطبيعي)، أو ترميزات إيحائية فحسب (كما في المسرح الرمزي)، بل هي جزء من الممثل والماكياج، والأزياء والحوار. وهذا ما ورثه المسرح الحداثي في نهاية القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين...
كل ذلك، يستجمعه شكسبير في حزمة واحدة، أي بنية واحدة تصهر العناصر الكتابية بتقنياتها والفكرة، ورهافة الحساسية وغنى المخيلة. وهذا يعني أن رؤيا هذا العبقري للعالم رؤيا شاعر درامي، عرف كيف يستفيد بثقافته الشاملة الأدبية، والموسيقية والتاريخية، والمسرحية، والفلسفية، والعلمية، ليغذي بها لغته التعبيرية وتصوره الدرامي.
على هذا الأساس نجد أن شكسبير مهّد بشكل كبير لمجمل الإنجازات المسرحية للقرون التي أعقبت. ففيكتور هيغو طلع من شكسبير، في تحطيمه قواعد المسرح الأرسطي، ونسفه وحدة الزمان والمكان... وعنف لغته، وتنوعها. وهذا ما فعله بول كلوديل (يسميه بعضهم شكسبير الشعر الفرنسي).
وإذا راجعنا بعض إنجازات المسرح العالمي في القرن العشرين نجد آثار شكسبير واقعة فيها، فهو الذي كسر الجدار الرابع، والعلبة الإيطالية، والمسرح داخل المسرح (بيراندلو)، ومسرح الفرجة، و»مسرح القسوة» (أرطو)، ومسرح المتعة والعبر (برشت)، والمسرح التسجيلي (بيتر فايس)، جعل السينوغرافيا مفردة من مفردات العمل الدرامي (لا مجرد ديكور)، ذات وظيفة تكمل دلالات المناخ والممثل وسائر الوسائل، وكذلك مزج الأنواع (جيرودو)، بين الكوميدي والتراجيدي، والتاريخي بالمتخيل، والفانتازي بالواقعي (العاصفة)، والسحر بأمور الحياة (مكبث).. والخروج من البيئة المحددة إلى الثقافات الأخرى (هارولد بنتر)، و»مسرح الشمس» في فرنسا، وبوب ويلسون (أميركا)، و»الطيب الصديقي» في المغرب... وريمون جبارة في «ديسديمونة»...
[ من الخشبة إلى الخشبة
ونرى في هذا الإطار التجديدي أن النص يصاغ من الخشبة إلى الخشبة، ومن الخشبة إلى النص. وهنا بالذات معنى الارتجال الذي ورثته أريان مينوشكين في «مسرح الشمس» ثم ورثه روجيه عساف في الحكواتي، ليكون تعبيراً عن العمل الجماعي. من هنا ان شكسبير، وفي هذا المناخ، لم يكن في نيته طبع مسرحياته (مثلما اعتمدت مينوشكين التي عادت وطبعت بعضها)، أكثر: فكرة النص النهائي لم تكن واردة في سياق إعداد شكسبير لمسرحه، أولاً من خلال التغييرات المستمرة التي كانت تتم عبر التمارين والممثلين، ثم عبر الجمهور: فمسرح الغلوب الذي أداره صاحب «هاملت» كان يتسع لنحو 3000 متفرج، وتقسيمات المسرح نفسها، تنفي انقسامه إلى خشبة وصالة، كما هي العلبة الإيطالية، أو ما يسمى الجدار الرابع. فكأن الحدود بين الخشبة والقاعة وما بينهما كانت ملغاة. من هنا إن مسرحه كان تبادلياً، بعلاقة تشاركية مع الجمهور، وهذا ما كان يستدعي تغيير النص بحسب العلاقة الثنائية بينهما. وإذا كان ذلك يوحي بالعابر، فإن طبع كتب شكسبير جعل هذا العابر اليومي أساساً في تاريخ المسرح العالمي. من النص إلى الخشبة، ومن الخشبة إلى النص، وأخيراً لا آخراً من الاثنين إلى الكتاب المكرس نهائياً... وهذا لا يعني أن قسماً أساسياً من مسرح شكسبير قد كُتب، لكن التمارين مع الممثلين والارتجالات والملاحظات المتبادلة بين الكاتب والممثلين، يضاف إليها طبيعة رد فعل الجمهور، لها الدور الأساسي في إعادة صوغ الحوار بما يتلاءم مع «المسرحية»، والإيقاعات، والجمل المنظومة، والطويلة، والبلاغية، والاستعادية، لكسر كل احتمال بوقوع النص في اللامسرحة، أي في مجرد الشعر والأدب. وهذا ما يؤكد حساسية شكسبير الشعبية، وتمكنه من وضع مناخ من المُتع البصرية، والإيقاعية، والصوتية، وحتى «القفشات» التي تعدّل من هيبة التراجيديا. لكن حتى هذه «القفشات» أدخلت في صُلب النص، وانتزعت من حاجتها الآنية والظرفية لتشكل جزءاً عضوياً من النص. ولا ننسى أن شكسبير بدأ ممثلاً ناجحاً، لعب أدواراً عديدة ومنها «الشبح» في «هاملت». بمعنى آخر يبدو احتراف شكسبير مهماً جداً في دمج كل العناصر المسرحية في بناء حي، قوي، شرس، مؤثر، جاذب... ومثير، ومحرك... وساحر. كل هذه العناصر المذكورة أَذابَها في كيميائية حولتها إلى كتلة مفتوحة مشعة ومشرعة على مختلف الاحتمالات، بما في ذلك «الغموض» أو «الالتباس»... لكن وفي كل الأحوال، من دون مجانية. لكن كيف تمكن النص الشكسبيري من «الانبعاث» بطاقته المكتوبة اللامحدودة، بعد تغير الأحوال، وطبائع الديكور، والأزياء، والإخراج، التي لازمت عروضه قبل أربعة قرون.
إنه النص الشكسبيري خرج مضيئاً ككوكب من الوظائف السينوغرافية التي كانت متوفرة آنذاك، لا سيما في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين عندما انتقلت سلطة النص إلى المخرج، وقراءاته، وتقنياته، مع اختراع الكهرباء، والإضاءة، والديكورات... لكن على الرغم من مجمل تطور التكنولوجيا، والمدارس الإخراجية، والرؤى التمثيلية، فإن تقنياته واستحداثاته، كما سبق وقلنا لم يضف إليها أحد شيئاً: لا أرطو، ولا برشت، ولا غروتوفسكي، ولا بيتر بروك، ولا بوب ويلسون، ولا بيتر فايس... نوعوا على «تقنيات» شكسبير. وهذا يعني أن ما صمد ليس النص فقط، وإنما الأدوات والابتكارات الشكسبيرية المسرحية. فمن «متعة» برشت، إلى طقوسية غروتوفسكي، إلى تسجيلية فايس، إلى ارتجالية وجماعية أريان منوشكين، كأنما استُلهم شكسبير الممثل وسينوغرافي الفضاءات والخشبة، والمخرج، والعلاقة بين الجمهور والعرض...
لم يترك شكسبير شيئاً لنضيفه إليه: من القضايا الإنسانية، والوحشية، والعنصرية، والخيانة، والانتقام، وسطوة المال، والبخل، والبطولة، والديكتاتوريات والسحر إلى انهيارات العرش الإنساني وضعفه وهشاشته.
[ من كتب مسرحياته؟
لكن من هو شكسبير؟ أكان موجوداً؟ أهو الذي كتب مسرحياته أو كُتبت له؟ أهو صاحب نصوصه أم منتحلها؟
نعود إلى جملة شهيرة في مسرحية «هاملت« «أكون أو لا أكون، هذه هي المسألة»، إنها المسألة التي بعد نحو قرنين (أي في القرن التاسع عشر)، قد طرحت أيكون شكسبير كاتب أعماله أم لا؟ بدأ ذلك مع داليا باكون التي تخيلت أن زوجها الفيلسوف فرانسيس باكون هو كاتب مسرحيات شكسبير. وقد تمكنت من إقناع العديد من الكتّاب المعروفين في تلك المرحلة والمؤثرين، وأصحاب السطوة، مثل امرسون، والشاعر والت ويتمان، والكاتب مارك توين، الذين أخذوا برأيها، وقد «مولت» حملاتها هذه لتظهر أن «العبقري» هو زوجها وليس شكسبير... ثم كبرت كرة الثلج لتصل لائحة المرشحين ليكونوا هم الكتاب الأصليين إلى 78 شخصاً: كلهم «شكسبير» ما عدا شكسبير. ومن أبرز هؤلاء الذين «توجوا» ملوك نصوص ابن ترتسفورد فلوريو. أما الذرائع التي كانوا يسوقونها لدعم آرائهم، ان شكسبير لم يكن سوى بورجوازي ريفي أمي، لا يفقه شيئاً من الأدب العالمي، ولا التاريخ ولا السياسة، ولا البلاط. أما فلوريو، فينسب إليه سعة ثقافته، وعزلته، وقراره إخفاء توقيعه عن مسرحياته، لأنه كان من كبار رجال البلاط. لكن هذه الاستيهامات كسواها، تقوم على وقائع وتفاصيل غير مقنعة. فقبل فلوريو كان ثمة آخر هو ادمون دي فير، كونت أوكسفورد، وقد «لقي ترشيح» هذا الأخير تأييداً من فرويد الذي شارك في حملة خلع التاج عن رأس شكسبير، بعدما دعم باكون، ما عدا أن كونت أوكسفورد مات عام 1604 أي قبل سنوات من تقديم «العاصفة»..
هذه النغمة شملت موليير أيضاً عندما ادعى بعضهم، وخصوصاً الشاعر بيار لويس وفي القرن التاسع عشر أن كورنيل (صاحب «السيد») هو كاتب مسرحيات صاحب «البخيل»... وقد أيد بعض الكتّاب هذا الادعاء ومنهم بول كلوديل، باعتبار أن موليير لا يتمتع لا بالثقافة ولا الموقع اللذين يجعلانه كاتب أعماله. (النغمة ذاتها مع شكسبير). وقد علّق أحد المسرحيين المعاصرين على هذه «القضية» قائلاً «أيكون لكورنيل رأسان ودماغان: واحد مولييري وآخر كورنالي؟». لكن المسألة عند موليير (وهو شكسبير المسرح الفرنسي) سهلة إذا قورنت بما ألصق بشكسبير وبعدد الذين «أحلوهم» مكانه.
لكن السؤال النقدي الضروري ليس بزرع الشكوك حول هوية من كتب مسرحيات شكسبير، بل بمقاربة بمن تأثر صاحب «الملك لير». فهو لم يطلع من عدم وهو ابن عصره، وسليل ثقافة تعود إلى ألوف السنين. وكتّاب وشعراء كبار أثروا فيه من أوفيد إلى هوميروس إلى أوريبيدس، كما أنه (كهوميروس)، اقتبس أو استلهم مواضيع من مختلف الثقافات القريبة والبعيدة، من فيرونا، إلى البلاطات الملكية البريطانية والفرنسية، وصولاً إلى بعض القصص الشرقية والعربية (يقال أن «روميو وجولييت» مستلهمة من «قيس وليلى» في العصر الأموي)...
هذا الغبار الذي ذُرّ على قامة شكسبير بقي غباراً زائلاً. ولا يعبر سوى هذه «الفوقية» الثقافية، والاحتقار... لشخص اتخذوا من أصوله الريفية، ومستوى تعليمه، ذرائع لإلغائه، من دون أن ننسى أن مثقفي تلك المرحلة وما بعدها، كانوا دوماً يكنون احتقاراً لكل من ليس من دوائرهم... حتى سرفانتس (صاحب دونكيشوت) كان محتقراً من قبل هؤلاء المثقفين، وكذلك موليير، وصولاً إلى شكسبير: هؤلاء الثلاثة هم من أعظم ما أنجبته البشرية!
ويكفي اليوم، وفي هذا العام بالذات، تحتفل الدنيا كلها قاطبة بهذا العبقري، الذي يعتبره بعضهم «أعظم شاعر عرفته البشرية». الاحتفالات بريطانية وفي مسرح «غلوب» بالذات الذي أعيد ترميمه بعدما أحرقه بعض المتطرفين المسيحيين بعد موت شكسبير، ومن مسقط رأسه، وصولاً إلى فرنسا، وأوروبا وأميركا.. وهوليوود، والمسارح العالمية، والشعراء...
العالم كله ينهض لينحني لهذه الظاهرة الشعرية المسرحية، التي لن تتكرر!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


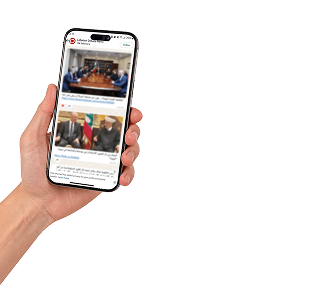
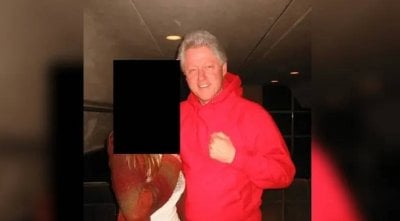



 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





