نعيش في عالم متعدّد الديانات والمذاهب والطوائف، ونشهد توجّه بعض المجتمعات إلى التقوقع والانغلاق وقد وصل البعض منها إلى مرحلة التطرّف الأعمى ونبذ الآخر لاختلافه وتنوعه. كما يشهد عالمنا اليوم تعدّد التيارات الدينيّة الطائفيّة وما هي إلا وليدة الانغلاق والتطرف.
لكلّ مجتمع ثقافته ولغته اللّتان تميّزانه عن غيره من المجتمعات فنجد على سبيل المثال مجتمعات منفتحة تتقبّل الآخر بتنوّعه واختلافه، يقابلها مجتمعات أخرى منغلقة ترفض الآخر لاختلافه عنها، كالاختلاف العرقي والمذهبي والدّيني فهذه المجتمعات لا تتقبّل الآخر بل على العكس تسعى جاهدةً إلى فرض رأيها وعاداتها وتقاليدها عليه.
تبرز أهميّة الترجمة الدّينيّة في تقريب وجهات النظر وبناء الجسور بين المجتمعات المختلفة والمتنوعة من خلال ترجمة الكتب الدّينيّة، فتصبح كافّة المجتمعات منفتحة على بعضها البعض على الرّغم من كلّ الفروقات والتباينات. لم يعد الدّين يُفرض على النّاس بالولادة، بل على العكس تماماً، يمكن للإنسان أن يقرأ وأن يكتشف الاديان وان كانت غير مكتوبة بلغته. وتتيح له هذه الترجمات ان يختار ديناً آخر أو أن يكتفي بالإطلاع عليه. بفضل هذا النوع في الترجمات، تصبح الكتب والنصوص الدّينية في متناول الجميع، فيضطلع شخصٌ منتمٍ إلى هذا الدّين أو ذاك على الأديان الأخرى. كما يمكنه أن يتعرّف أيضاً إلى دينه بلغةٍ جديدةٍ كما يراه شخص آخر يعيش في مكانٍ آخر من العالم.
مشكلات الترجمة الدينيّة:
لمَ ترفض الديانات معظم الترجمات الدّينيّة؟ ولمَ قبلت بها في النهاية؟ الدّين لجميع البشر، إذا بقي في لغةٍ واحدة يصعب فهمها من غير الناطقين بها؛ لذا لا بدّ من ترجمتها إلى لغاتٍ حيّةٍ. إلاّ أنّ هذا العمل ليس بالأمر اليسير بل يطرح إشكاليّات كثيرة مثل الأمانة العلميّة وجمال النص وغيرها من الإشكاليّات.
تعاني اللّغة العربيّة من مشكلتيْن أساسيتيْن على مستوى المصطلحات التقنيّة والعلميّة والدينيّة ويلجأ معظم علماء اللّغة إلى الاستعانة بالمقترضات اللّغويّة أو ما يسمّى باللّغة الفرنسيّة "les Emprunts". أمّا فيما يتعلّق بترجمة النصوص الدينيّة وخاصّة تلك المنقولة من اللّغة العربيّة إلى لغةٍ أجنبيّة أو من لغة أجنبية إلى اللّغة العربيّة فالأمر مختلف تماماً، فيصعب ايجاد ما يعادل مصطلحاً أو عبارةً معيّنة في لغة الهدف تعطي المعنى ذاته كما ذُكر في لغة المصدر. لذلك نرى أن عدداً كبيراً من الذين يريدون اعتناق دين معيّن، يلجأون أولاً إلى قراءة الكتاب المقدّس بلغتهم الأمّ، ويصرّون على تعلّم لغة الكتاب وقراءته كما أُنْزِل أو كما وُضع. وتسهيلاً لقراءة النصوص، يلجأ البعض إلى كتابة النص المقدّس الأصلي بأحرف لاتينيّة وتكون هذه الكتابات عادةً مقرونة بترجمة أجنبيّة، مثالاً على ذلك ترجمة الآية الأولى من سورة الفاتحة التي جاءت على الشكل التالي: Al Hamdu lilahi rabbil ‘alamin لتتيح للقارئ الأجنبي قراءة النص الأصلي بأحرف أجنبيّة.
وبما أن لكلّ لغةٍ ثقافتها وكلماتها وتعابيرها يحاول المترجم "الأمين" أن ينقل الصورة كما هي من لغة الإنطلاق إلى اللّغة الهدف، من خلال ايجاد ما يقابل المعاني المقصودة من كلمات وتعابير في اللّغة الثانية.
والأمر نفسه ينطبق على الترجمة الدينيّة، في حين أن العمل الترجمي الدّيني أصعب من العمل الترجمي الأدبي أو السياسي أو العلمي. لأنّه يترتب على المترجم الالتزام بالنص الأصلي كما هو؛ ما معناه أنه بوسع المترجم أن يغيّر في تسلسل الكلمات في نصٍ أدبيّ أو سياسيّ أو علميّ بينما يجب عليه أن يتقيّد بتسلسل الكلمات والعبارات والآيات كما وردت في النص الأصلي.
وإنّ دلّ هذا الكلام على شيء، إنّما يدلّ على صعوبة الترجمة الدينية وكثرة الإشكاليّات التي تصعِّب عمل المترجم ونذكر منها:
- مسألة غياب الترادف.
- مسألة الحروف المقطّعة في أوائل السور (ألم سورة البقرة - كهيعص سورة مريم –) (ذُكِرَ سابقاً).
- مسألة أسماء الله الحسنى.
- مسألة إختلاف اللّغة العربيّة عن سواها في التأنيث والتثنية.
- مسألة الضمير هل هو عائد إلى إسم مذكر أو إلى إسم مؤنث.
- مسألة الآيات المتشابهات والمحكمات.
- مسألة الأسماء التي ذكرت مرّة واحدة أو الأسماء المعرّبة مثل (زمهرير).
- مسألة إعجاز ألفاظ القرآن الكريم ووفرة معانيه.
- مسألة ترجمة لفظ الجلالة (الله).
تباينت الآراء بين رافضٍ للترجمة ومؤيدٍ لها، دعم الفريق الأوّل حجّته بضرورة اتقان اللّغة العربيّة، التي أنزل بها القرآن من جهة وتساءلوا ما إذا كانت الترجمة الأجنبية تجعل منها نصاً مقدّساً. ومن هذه الفتاوي نذكر فتوى الشيخ إبن عثيمين التي جاء فيها : أمّا ترجمة ألفاظ القرآن الكريم، فهذا لا يمكن وهو من المستحيل لأنّه لا يمكن أن يأتي بلفظٍ يماثل اللّفظ القرآني لأن هذا الأخير، معجزٌ في ألفاظه وتراكيبه وإنّما تجوز ترجمة معاني القرآن الكريم.
وتترجم كتب التفاسير هذه للمحتاجين إليها ببعض اللّغات الأخرى غير اللّغة العربيّة، ليعرفوا معاني القرآن الكريم بألسنتهم مع إنّه وجب على المسلم تعلّم اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن الكريم والشريعة الإسلاميّة، حتّى يستطيع فهم دينه وسنّة نبيّه على الوجه الصحيح.
أمّا الفريق الثاني الذي نادى بضرورة ترجمة القرآن عازياً ذلك إلى ضرورة تبليغ الرسالة إلى كافّة البشر من العرب والأعاجم، وكون الترجمة لن تقلّل من اعجاز القرآن الكريم بل ستتيح لغير المسلمين التعرّف على الدّين الأمر الذي سيغيّر من وجهة نظر الكثيرين تجاه القرآن والمسلمين.
اللّغة في تطور دائم وكذلك الترجمة، والمقارنة غير منطقيّة بين الكتب الدينية وترجماتها في ما يتعلق بمصطلح ديني مقبول في كافة الحقبات. وهذا منوط بقدرة المترجم الذي تَقَعُ على كاهله هذه المهمّة الصعبة. ومن الصعب ايجاد مقابل دقيق وملائم للمصطلحات الدينيّة في ظلّ التطوّر الدائم للّغة، أيّة لغة.
يواجه مترجم الكتب الدينيّة إشكاليّات كثيرة تحتاج إلى بذل جهد كبير من أجل تخطيها مع المحافظة على قدسيّة النص وروحانيته، سأدرج في ما يلي بعضاً منها:
وردت الآية التالية في القرآن الكريم : {أَنُلْزِمْكُمُوها} وهي الآية رقم 28 من سورة هود. قبل أن أتكلم على الترجمة، سأشرح هذه الآية وأفسر تركيبها: أولاً معناها في القرآن الكريم أنجبركم على قبولها. أما في ما يتعلّق بتركيب هذه الكلمة فهي على النحو الآتي: (لزم) لزوم الشيء طول مكثه ومنه يقال لزمه يلزمه لزوماً والالزام نوعان/ إلزام با لإجبار من الله أو من الإنسان. ( الله لا يجبر بل يخيّر.)
قبل البدء بترجمة هذه الآية علينا التفكير مليّا بتركيبها، وجود حرف الألف الذي يدلّ على الاستفهام، والفعل لزم تعود لكلمة البيّنة لقوله تعالى: قال نوح يا قومي أرأيتم إن كنت على حجّة ظاهرة من ربّي في ما جئتكم به، تبيّن لكم إنّي على حقّ من عنده وآتاني رحمة من عنده، وهي النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم فهل يصحّ أن نلزمكم إيّاها بالإكراه وأنتم جاحدون بها؟ وهذا تفسير1 مفصّل للآية الكريمة التي وردت على النحو الآتي {قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي وآتاني رحمة من عنده فعمّت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون}.
لا يستطيع المترجم أن يجد مقابلاً في اللّغة الأجنبية لكلمة "أنلزمكموها" وتعطي المعنى التامّ والكامل، لذا لجأ المترجمون إلى تفسير الآية ومن ثمّ ترجمة هذا المعنى ليتبيّن لنا أن ترجمتهم قد احتاجت إلى سبع كلمات في اللّغة الانكليزيةّ
shall we compel you to accept it
لم تكن اللّغة الفرنسيّة مختلفة في تركيبها عن الانكليزية، فكانت هي أيضاً ترجمة للمعنى وليست ترجمةٌ أو مقابلٌ لكلمة معيّنة، إحتجنا إلى 9 كلمات من اللّغة الفرنسيّة لترجمة كلمة واحدة من القرآن الكريم devrons-nous vous l’imposer alors que vous la répugnez?
لكلّ لغة ثقافتها وتعابيرها خصوصاً في النصوص الدينيّة، فاللّغة العربيّة والعبريّة لهما خصائصهما الأمر الذي ينعكس على الترجمة التي يغلب عليها الطابع التفسيري. تتّم مراجعة هذه الترجمات من قبل المختصّين، وعلى الرغم من ذلك لا تسلم هذه الترجمات من الانتقادات فنجد للقرآن الكريم عدّة ترجمات تفسيريّة ونجد أيضاً عدداً لا بأس به من ترجمات الإنجيل المقدّس، في حين لا نجد ولتاريخ كتابتي لهذا المقال ترجمة عبريّة للقرآن الكريم تحظى بموافقة مجمع الملك فهد، فيطلق البعض عليها صفة ترجمة إسرائيليّة أو الاستشراق الإسرائيلي الصهيوني.
ما هي صفات مترجم النصوص الدينيّة؟
على مترجم النصوص الدينيّة ان يتسم بعدّة صفات تعتبر الركيزة الاساسيّة لعمله، اذ لا يمكنه أن يتصرف بحريّة مطلقة بالنص لما لهذا العمل من تبعاتٍ سلبيّةٍ على المترجم من جهة وعلى ترجمته من جهةٍ ثانية. لا يمكننا في هذا الصدد إلّا ان نذكر المستشرق الفرنسي جاك بيرك وترجمته لمعاني القرآن الكريم، واجه المترجم الكثير آنذاك من الإتّهامات "كعدوّ العرب" و"ذي وجهيْن" بسبب "التصرّف الواسع" بالنص المترجَم، ففي بعض الاحيان لم يكن يحترم تسلسل الآيات بل قدّم آيةً على أخرى، ولم يلتزم بترجمة أسماء السور فأعطى اسميْن لبعض السور وترك حريّة الإختيار للقارئ.
كان يجب عليه أن يحترم قدسيّة النص الاصلي ومكانته عند المسلمين وغير المسلمين لتجنّب هذه الاتهامات، لذا على المترجم أن يتّسم بعدّة صفات أذكر منها:
- أن يكون أميناً ودقيقاً في ترجمته.
- أن تتسّم ترجمته بالموضوعيّة.
- أن يحترم القرّاء والنص الديني.
- أن يتقن لغة المصدر ولغة الهدف.
- أن يحظى برصيد كبير من المصطلحات والمفردات المتعلّقة بالنص الدّيني.
ترجمة معاني القرآن الكريم بين رافضٍ ومشجّعٍ:
تنقسم الآراء حول الترجمة الدينيّة فمنهم من يؤيّدها ويساندها ومنهم من يرفضها جملة وتفصيلاً. فضل البعض من علماء الفقه، الإكتفاء بترجمة الأحاديث النبويّة وقصص الأنبياء وعدم ترجمة القرآن باعتبار أن الأحاديث النبويّة ليست كلام الله المنزل.
أرجع العلماء رفضهم لترجمة معاني القرآن إلى سببيْن:
1. لا تصحّ الصلاة وتعتبر باطلة إذا قرأ المصلّي الترجمة ولم يقرأ النص العربي الأصلي ويقول الإمام النووي :"مذهبنا أنّه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربيّة أم عجز عنها وسواء كان في الصلاة أو غيرها، فإن أتى بترجمته في صلاة بدلاً من القراءة العربيّة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وابو داود".
2. النص العربي الأصلي هو النص الوحيد المنزل الذي {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد} (الآية 42 من سورة فصّلت) ممّا يثير التساؤلات حول النص المترجم هل تصبح اللّغة الهدف أيضاً منزلة لأنّها ترجمة للقرآن؟
ومن جهةٍ أخرى نادى بعض العلماء بضرورة ترجمة القرآن لما تحمله هذه الترجمة من أهميّة، فهي تساهم في إيصال معاني القرآن إلى غير الناطقين باللّغة العربيّة، كما وتتيح المجال أمام القرّاء الذين ينتمون إلى ديانةٍ أخرى، بالإطلاع عليه وعلى معانيه ليتمّ وضع حدّ للإتّهامات الموجّهة للإسلام وللمسلمين خصوصاً في الآونة الأخيرة.
يقول الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في كتابه "حكم ترجمة القرآن الكريم:" زُعم أن الإسلام أَلْزَمَ الناس العربيّة وتعلّمها ونَبَذّ ألسنتهم ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم، وهذه الشائعة تكفّل بردها كتابي (جواز ترجمة القرآن) فقد برهنت فيه على أن الدّين لا يلزم الأمم التي دخلت في الإسلام التكلّم بالعربيّة بدليل بقائها إلى الآن تتكلّم بلغتها الأصليّة وما منع ترجمة القرآن أصلاً ولا ورد المنع في كتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع ولا قياس".
إنّ ترجمة معاني القرآن الكريم من الأمور المرغوب فيها، لقوله (ص) فليبلغ "الشاهد الغائب" وقال أيضاً "بلّغوا عنّي ولو آية"، لذلك وجب على العرب أن ينوبوا عنه ويبلّغوا غيرهم من الأمم، ولا يمكن التبليغ لجميع الأمم إلا بالترجمة إلى لسانهم وأجاز أبو حنيفة قراءة القرآن بغير العربيّة وقال في هذا الصدد :" القرآن إسم للمعنى فقط والنظم ركن زائد".
ما هي السبل التي تساعد على تجاوز العقبات التي تقف بوجه الترجمة الدينيّة؟
يمكننا القول إنّه وعلى الرغم من تباين الآراء في صفوف العلماء بين مؤيّدٍ ومعارضٍ للترجمة الدينيّة، على العلماء أن يحذوا حذو علماء الدين المسيحيين الذين رحبّوا بترجمة الإنجيل منذ زمن. أضف إلى هذا على القيّمين في مجمع الملك فهد أن يقوموا بتوحيد الترجمات أيّ أن يضعوا ترجمةً واحدة من كلّ لغة، وتشجيع المترجمين الجدد على ترجمة معاني القرآن من جديد، كون الترجماتِ الموجودةِ اليوم قديمةً للغاية من دون أن ننسى توحيد كتب التفاسير، فقارئ هذه الكتب يلحظ إختلافاً وتبايناً في المعاني، أيّ إنّ هذه الآية تُفسّر بهذه العبارات في مسند الإمام أحمد على سبيل المثال، بينما يفسّرها الطبري وإبن عثيمين بطريقةٍ اخرى. إن هذا التباين والإختلاف في كتب التفاسير من شأنه أن يشتّت المترجم من خلال إعطائه ترجمةً مختلفةً عن المعنى الموجود في النص الاصلي.
أنزل اللّه اليهوديّة والمسيحيّة الإسلام، ووجب على المنتمين لهذه الديانات أمانة نشرها وتوطيد الحوار في ما بينها ولعلّ من أهمّ الأدوات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف النبيل هي "الترجمة الدينيّة"، لذلك يجب على العلماء والقيّمين على المجامع الدينيّة اعداد جيلٍ من المترجمين الأكفّاء القادرين على ترجمة النصوص الدينيّة وثقافاتها الدينيّة، على الرغم من اختلافها ليكونوا دعاة لأديانهم ولأهدافها السامية.
حين كانت الثقافة العربيّة من أقوى ثقافات العالم، مارست الأثر نفسه على الثقافات الأجنبيّة فالترجمة عنصر تغيير والعمل الترجمي ليس سهلاً وغالباً ما تظهر إشكاليّات كبيرة تقف عائقاً أمام الترجمة. تعدّدت هذه الإشكاليات وتنوعت، أوّلها صعوبة إيجاد مقابل في اللّغة الهدف لكلّ مصطلح أو مفهوم ديني يكون مناسباً ومقبولاً من الجميع، وأن يكون مقبولاً أيضاً في كلّ الحقبات الزمنيّة. كما وتظهر إشكاليّة أخرى تتعلّق بالترجمة من اللّغة العربيّة إلى اللّغات الأجنبية، وتكمن في إيجاد مقابل في اللّغة الهدف خصوصاً أن اللّغة العربيّة أوسع وأشمل فغالباً ما يجد المترجم نفسه أمام مثل هذا التحدّي ولا يستطيع أن يعطي مقابلاً، لذلك غالباً ما يلجأ إلى الإقتراض اللّغوي ليبقى بذلك المصطلح الديني كما هو من دون تغيير في لغة الهدف. ومن جهةٍ ثانية، تؤثر ثقافة المترجم وديانته على الترجمة فيستطيع القارئ أن يعرف إلى أيّ دينٍ ينتمي المترجم مع العلم أنّه على المترجم أن يبقى حيادياً ولا يُظهر الإنتماء الديني من خلال التعابير والكلمات والمصطلحات التي يستعين بها.
المراجع المتعدّدة:
- د علي القاسمي، علم اللغة و صناعة المعجم، جامعة الرياض٬ (1975 ٬ ط2 ٬1991 ص 3.
- د. محمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن، دار الآفاق الجديدة بيروت 1980.
- مجموعة من المحاضرات التي ألقيت في ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر " ملتقى القرآن الكريم " الذي انعقد بالجزائر العاصمة في الفترة من 02 إلى 08 ذو القعدة 1401 هـ الموافق 01 إلى 07 سبتمبر 1981م.
- القرآن الكريم وإشكاليّة الترجمة، ضمن كتاب "دراسات في الإستشراق ومناهجه للدكتور حسن عزوزي، طبعة فاس 1999م.
- فريد وجدي، الأدلّة العلميّة على جواز ترجمة معاني القرآن الكريم، الى اللّغات الأجنبيّة، دار نشر (غير متوفر)، 1940.
- MASSON, Denise (m 1995) Essai d’interprétation du coran, inimitable, revue par Sobhi Al Salah, Beyrouth 1980.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News
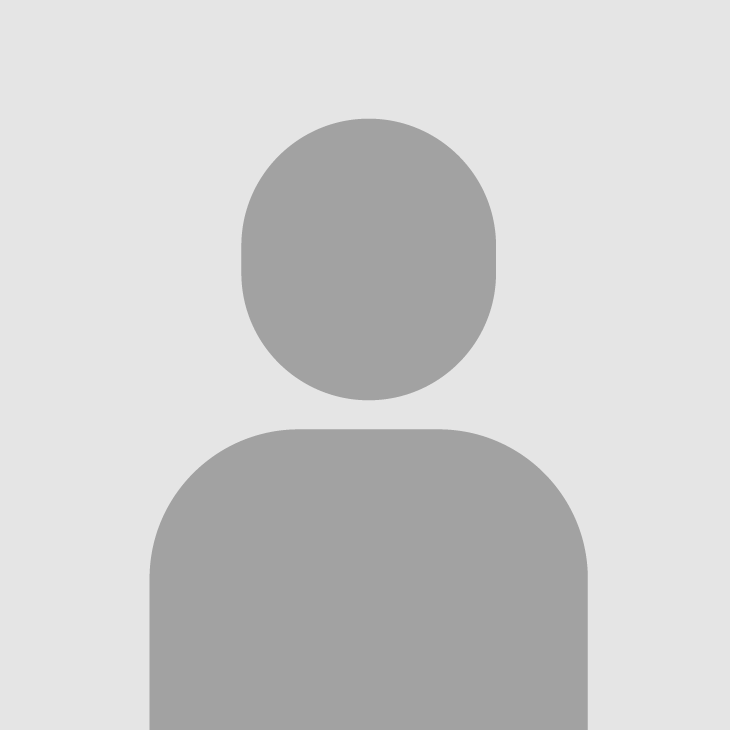

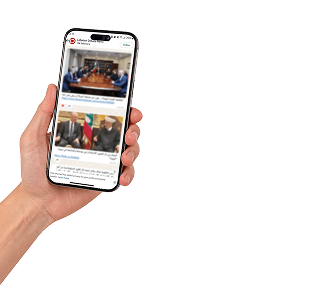




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





