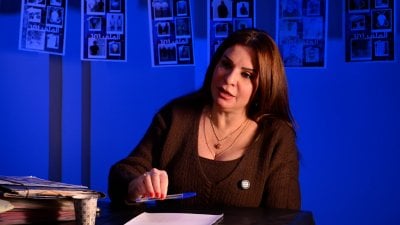في بلدٍ عُرف تاريخيًا باحتضانه تنوّعًا ثقافيًا ودينيًا كبيرًا، كانت البيئة المعمارية انعكاسًا لهذه الهوية الجامعة؛ فتجاورت الكنائس والمساجد، وتفاعلت الأديان والثقافات في نسيجٍ مديني عبّر عن انتماء جماعي لا يُقصي أحدًا. لكن هذا التوازن بدأ يتآكل تدريجيًا، أولًا مع التخطيط الاستعماري، ثم خلال العقود الخمسة من حكم حافظ الأسد وابنه، حيث تحوّل العمران إلى أداة بيد السلطة لتعزيز السيطرة وإنتاج الفرز الاجتماعي والطائفي.
في دمشق، راجت أسطورة تقول إن حافظ الأسد يراقب كل شيء من قصره على قمة قاسيون، في مشهد يتقاطع مع تصميم "البانوبتيكون" كما وصفه ميشال فوكو، حيث الحضور الخفي للسلطة يحكم الحياة العامة. وقد أسّس النظام السوري لهذا الحضور من خلال البنية المدينية نفسها، التي وُضعت لتكون قابلة للضبط والمراقبة، فحوصرت الساحات والفضاءات العامة، وانتُزعت العفوية من الشوارع، وتحوّلت مناطق السكن الأولى إلى ما يشبه أبراج الحراسة، حيث تتداخل العسكرة بالتخطيط العمراني.
كان التخطيط في العاصمة يهدف إلى الإطباق على المدينة من خلال شبكات طرق تفصل ولا تصل، مثل المتحلق الجنوبي وأوتوستراد المزة، التي قطّعت النسيج الاجتماعي، وأدت إلى تهجير قسري للسكان تحت ستار التطوير. هذا التدمير للذاكرة الجماعية لم يكن استثناءً، بل بات نموذجًا معمّمًا في حلب، وحمص، ومدن أخرى، حيث اختفى الامتداد الطبيعي بين الأحياء، وتحوّلت بعض المناطق إلى جيوب مغلقة بحسب الانتماء الطائفي أو الطبقي.
في حمص، على سبيل المثال، أدّى مشروع "حلم حمص" إلى تدمير أحياء تاريخية بكاملها، وولّد عزلة بين الفئات الاجتماعية. فالمدينة التي كانت ذات نسيج متجانس، تعايش فيه الجميع في الأزقة والأسواق، تحوّلت إلى مشهد عمراني منقسم تحكمه الكتل الخرسانية. هذا "التحديث القسري" مهّد لاحقًا لتفجير الأوضاع بعد الثورة، وكأن تخطيط المدينة أُعدّ مسبقًا لحرب، بشوارع واسعة لعبور الدبابات وأبنية جاهزة لتمركز القناصة.
وتشير الكاتبة والمهندسة المعمارية مروة الصابوني إلى أن الفقر البصري والمعماري للعشوائيات، التي احتضنت نصف سكان سوريا تقريبًا، كان مقدمًا لانفجار اجتماعي. إذ سكن الناس في كتل إسمنتية بلا جمال ولا خدمات، وهو ما عمّق الشعور بالغربة والانفصال، وسهّل تأجيج الصراع.
العشوائيات التي نمت على أطراف دمشق وحلب وغيرها، لم تكن نتيجة فوضى عمرانية فقط، بل جزء من منظومة السلطة. فالنظام، بحسب دراسة "اليوم التالي"، ترك هذه المناطق تنمو، وأتاح للمقرّبين منه الاستثمار فيها، ثم أبقى سكانها في موقع هشّ قانونيًا وأمنيًا، ما جعل ولاءهم عرضة للابتزاز الدائم. بعض هذه الأحياء، مثل المزة 86، أنشئت أصلًا لإيواء عناصر سرايا الدفاع، وبقيت على ولائها للنظام، فيما أُطلقت يد "الشبيحة" في غيرها لإبقاء السكان تحت السيطرة.
هذا التخطيط المقصود لعزل الناس عن بعضهم، وعن الفضاء العام، أنتج مدنًا مقطّعة، محكومة بالخوف، وغير قابلة للحياة المشتركة. وقد ساهم لاحقًا في إطالة أمد الحرب، عندما تحوّلت الأحياء إلى ساحات معارك، تُقصف وتُهجّر ثم يُعاد رسمها ديموغرافيًا تحت عنوان "إعادة الإعمار"، كما حدث في داريا، واليرموك، وحيّ الوعر.
لقد كان التخطيط العمراني أداة استراتيجية في يد السلطة، ليس فقط للسيطرة، بل لإعادة إنتاج المجتمع على صورة النظام، بحيث تختفي الفضاءات المشتركة، وتُفكّك الروابط، ويعيش المواطن في عزلة سياسية واجتماعية ونفسية، لا يرى فيها أمامه سوى جدران إسمنتية شاهقة، وعبارات على الحيطان تؤكد: "الأسد أو لا أحد".

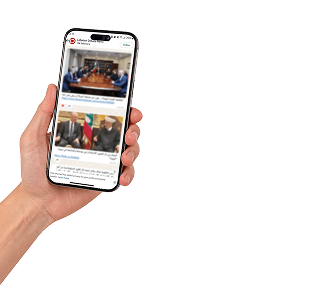



 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد