في جوهر الموقف، يسعى عون إلى توظيف ما يسميه الواقعية الاستراتيجية، أي أن يتعامل مع المتغيرات الإقليمية من دون الاصطدام بها. هو يدرك أنّ ما بعد حرب غزة لن يكون كما قبلها، وأنّ الغرب، ولا سيما واشنطن وباريس، يريدان للبنان أن يدخل منظومة التسويات الجديدة من باب الدولة لا من نافذة الميليشيا. لذلك جاءت تصريحاته الأخيرة لتؤكد أن زمن الانعزال انتهى، وأنّ حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد مطلباً أميركياً فحسب بل شرطاً مسبقاً لأي دعم دولي.
لكنّ هذا الانفتاح لا يخلو من المخاطر، فالقوى الممانعة تراقب كل كلمة، وتقرأ بين السطور خوفاً من إعادة إنتاج 17 أيار بثوب جديد، في حين أنّ الشارع اللبناني، المتعب والمنهك، لا يريد مواجهة جديدة ولا انهياراً إضافياً.
بدورها، تراهن الولايات المتحدة الأميركية على عون باعتباره "رئيس المرحلة الهادئة" القادر على تمرير خطوات التفاوض من دون ضجيج. أما فرنسا فتسعى إلى تحويل الانفتاح إلى مسار واقعي يبدأ من تثبيت الحدود وينتهي بإعادة الإعمار. وفي المقابل، يراهن حزب الله على الوقت وعلى برودة الداخل لإفشال أي مشروع تفاوضي قبل أن يولد.
لذلك، يتحرك الجميع على إيقاع الانتظار، فالأميركي يضغط، الإيراني يراقب، الإسرائيلي يناور، والرئيس اللبناني يحاول أن يمشي بين النقاط من دون أن يبتلّ. هو يعرف أن أي توقيع ناقص قد يتحول إلى انتحار سياسي، وأنّ التسرع في تسوية غير متوازنة قد يعيد فتح الجروح القديمة تحت عناوين جديدة.
تاريخ 17 أيار ما زال حاضراً في ذاكرة اللبنانيين، لا كاتفاق فقط، بل كجرح وطني لم يلتئم بعد. واليوم، حين يتحدث الرئيس عون عن ضرورة الانخراط في مسار التسويات، يعود ذلك الطيف ليطلّ من جديد. فهل يتكرر السيناريو بصورة مختلفة، أم أن لبنان تعلم من التجربة أن السيادة لا تُشترى، وأنّ أي سلام لا يستقيم ما لم يكن عادلاً ومتوازناً؟ الإجابة ستتضح في الأشهر المقبلة، حين تبدأ المفاوضات الفعلية حول الحدود، وحين يُختبر الموقف الداخلي بين الدولة والمقاومة، وبين الواقعية والمغامرة. وحتى ذلك الحين، يبقى السؤال معلّقاً فوق لبنان،
هل يسير عون على درب أمين الجميل، أم أنه يكتب فصلاً جديداً من التاريخ اللبناني، بلا توقيع ولا 17 أيار جديد؟


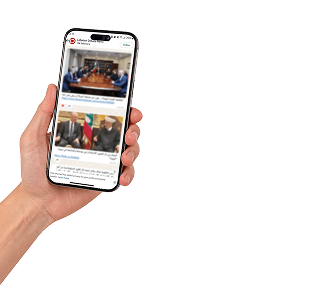




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






