في صباح الأحد 21 تشرين الأول 1990، أُجهض الهدوء في شرق بيروت باقتحامٍ مدبّر: موكبٌ من سيارتين من نوع BMW يقلّ ثمانية مسلّحين متنكرين بزّي الجيش اللبناني، وصل إلى عمارةٍ سكنيّة في الطابق الخامس، حيث اقتحم أربعةٌ منهم شقة داني شمعون وطرقوا الباب حوالي الساعة 7:40 صباحًا. ما إن فُتح لهم حتى انهالوا على المنزل بوابلٍ من الرصاص، مستخدمين مسدساتٍ ورشّاشاتٍ مزوّدةٍ بكواتمٍ للصوت لتجنّب تنبيه الجيران. خلال دقائق معدودة، وُجد داني شمعون وزوجته إنغريد (45 عاماً) وولديه طارق (7 سنوات) وجوليان (5 سنوات) قتلى داخل منزلهم، فيما أُصيبت طفلتهما الرضيعة تمارا ونجت من المجزرة بأعجوبة. بعد التنفيذ الهادئ والاحترافي، انسحب منفّذو العملية إلى وجهةٍ مجهولة، تاركين خلفهم مشهدًا مأساويًا: عائلةٌ بكاملها مقتولة داخل بيتها الآمن.
تفاصيل المجزرة التي كشفها التحقيق لاحقاً تؤكد فظاعة الأمر: وُجدت إنغريد مضرّجةً بالدم عند مدخل الصالون وهي ترتدي ثوب النوم، وقد أُصيبت بعدّة طلقاتٍ نارية في الصدر والذراعين. وعلى بعد خطوات، كانت جثة داني شمعون ممدّدةً على ظهرها بملابس النوم أيضًا، وقد اخترق الرصاص جسده في الظهر والصدر والجبهة، ثم وُجدت طلقتان في الرأس للتأكد من الموت. وعلى عتبة غرفة النوم، سقط الطفل طارق على ظهره وقد اخترق رأسه ثلاث رصاصات، واحدة عند نهاية حاجبه الأيسر واثنتان تحت أذنه اليسرى. وفي داخل الغرفة نفسها، وُجد الطفل جوليان مصفّحًا ببقع دمائه، وكان قد نُقل إلى المستشفى حيًّا لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه البليغة. لم تنجُ من العائلة سوى الرضيعة تمارا؛ نجاةٌ لم تكن عن رحمةٍ أو شفقةٍ، بل كانت نتيجة قضاءٍ وقدر. بدا واضحًا أن منفّذي العملية أرادوا إعدام عائلةٍ بأكملها وإرسال رسالةٍ سياسيةٍ مكتوبةٍ بالدم.
وقعت الجريمة في توقيتٍ شديد الحساسية، فقد دخلت بيروت الشرقية، بعد انهيار حكومة العماد ميشال عون العسكرية في 13 تشرين الأول 1990، مرحلةً انتقالية نحو هيمنةٍ أمنيةٍ سوريةٍ متزايدة. كان داني شمعون من أبرز داعمي عون، كما كانت خصومته مع سمير جعجع مفتوحةً وبعنف. لذا، اعتبرت المجزرة من قبل العديد رسالةً سياسية، تصفيةَ منافسٍ مسيحيٍ بارزٍ أو إحكام الطوق الأمني على ما تبقّى من المعسكر المعارض للنفوذ السوري آنذاك. أصابع الاتهام تردّدت بين الجهات، فزعيم الدروز وليد جنبلاط اتهم السلطات وسمير جعجع بـ”التخطيط” للاغتيال، فيما جعجع أنكر صلته بالجريمة وأدانها بشدة.
في 24 حزيران 1995، أصدرت المحكمة المختصة حكمها وأدانت سمير جعجع وآخرين بقتل داني شمعون وعائلته. القاضي فيليب خيرالله أعلن أن جعجع “قرّر تصفية منافسه فكلّف جهازه الأمني بتنفيذ الاغتيال”. الحكم تضمّن إصدار الإعدام، ثم خُفّف إلى السجن المؤبّد مع الأشغال الشاقة. لكن، وعلى الرغم من صدور الحكم، وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “مُعيبة بشكلٍ خطير”، مستندةً إلى تقارير تفيد بأن المدّعى عليهم تعرّضوا للتعذيب أو للاحتجاز غير القانوني، وأن بعض أقوالهم انتُزعت تحت الضغط أو التهديد، وأنه لم تتوفّر إمكانية استئناف قانوني كاملة ضد الحكم. من جانبها، قالت ترايسي شمعون إن الحكم “بداية نهاية عصر الميليشيات”، لكن عمها دوري شمعون ظلّ يُشكّك في صدقية القرار، واعتبر أن المتورّط الأوّل كان النظام السوري أو عملاءه، لا جعجع.
في تموز 2005، وبعد انسحاب الجيش السوري وتحوّل التركيبة السياسية اللبنانية، أقرّ مجلس النواب قانون عفوٍ خاصّ أفضى إلى إطلاق سراح سمير جعجع بعد نحو 11 عامًا في السجن. لكن هذا الإفراج لم يلغِ الحكم الصادر عام 1995 ولم يُقدّم خطوةً حقيقية نحو توضيح الحقيقة الكاملة. بقيت الروايتان متوازيتين: رواية القضاء التي سمّت مرتكبي الجريمة، ورواية الحقوقيين والمعارضين التي شكّكت بها وأرجعتها إلى منطق الحسابات السياسية. ومع مرور العقود، يبرز سؤالٌ جوهري: إذا كان سمير جعجع يملك، كما يؤكّد، براءةً ويصف الحكم بأنه مفبرك ضمن لعبة نفوذ، فلماذا إذن لم يتبنَّ مساءلةً قانونيةً أو شعبيةً تُتوّج بتوضيحٍ كاملٍ وشامل؟ لماذا لم يُطلِق حملةً خاصةً لتبرئة نفسه؟ ولماذا لم يُسرّب من فريقه ملفًّا بديلًا يحلّله أمام الرأي العام، أو يُطالب بمحاكمةٍ دوليةٍ أو مختلطة؟ ولماذا لم يقم بمحكمةٍ “شعبية” توثّق كل تسلسل الزمان والمكان والقرائن، أو يُوكل محامين دوليين لإعادة فتح الملفّ؟ منذ خروجه من السجن، فضّل جعجع، بحسب المراقبين، العمل السياسي التقليدي والانخراط في التحالفات بدلاً من توجّهٍ قضائيٍّ استباقي، مع ترك الباب مفتوحًا للتأويل بأن الإفراج كان صفقةً سياسية لا نتيجة تبرئةٍ كاملة.
هذا الامتناع يُثير ثلاث ملاحظات: أولًا، غياب الدعوى المضادة أو المبادرة بتنقيبٍ مستقلّ يُضعف روايته الدفاعية أمام الرأي العام. ثانيًا، رفضه حتى اليوم كشف أرشيف الأجهزة الأمنية ذات الصلة بتلك المرحلة أو المطالبة بفتح تحقيقاتٍ شاملةٍ تستدعي المسؤولين السابقين. ثالثًا، استمرار حالة الغموض حول الجريمة يحافظ على شبهة الإفلات أو الصفقة السياسية بدل إنصاف ذوي الضحايا، ويضع جعجع في موقعٍ دفاعيٍّ سلبي لا فعّال.
ومن ثم، يبرز التناقض الآتي: طالب جعجع أكثر من مرةٍ ببيان براءته، لكنه لم يُقدّم خطوةً فعليّةً تُحوّل تلك الدعوى إلى مشروعٍ قانونيٍّ مستقلّ، أو إلى حملةٍ سمعيةٍ بصريةٍ وثائقية تُعرض أمام اللبنانيين. هذا الواقع يجعل موقفه مفتوحًا للنقد، ليس فقط باعتباره مدانًا قضائيًا سابقًا، بل باعتباره شخصًا يملك ولايةً سياسية ويتحمّل، بالمقابل، مسؤوليةً أخلاقيةً تجاه الحقيقة والعدالة.
إذا كان جعجع يؤكّد أنه ضحية مؤامرة، فالمؤامرة الحقيقية ربما كانت في صمته الطويل. فبعد كل هذه السنوات، يبقى السؤال معلّقًا: لماذا لم يدافع عن نفسه كما يدّعي أنه بريء؟ ولماذا ترك جريمة قتل عائلة داني شمعون تتحوّل إلى ملفٍّ مطويٍّ على أوراق القضاء فقط؟ وإذا كان يملك روايةً أخرى، فلماذا لم تُروَ كاملة؟ ولماذا لم يُنصف نفسه ولا الضحايا؟ وإذا كان جعجع اليوم يُقيم مجسّمًا لسجنه في معراب ليُظهر مظلوميته أمام جمهوره، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم يُقم أيّ مجسّمٍ أو مبادرةٍ لتفنيد القرار القضائي الذي أدانه وإظهار براءته المزعومة؟ أليس من الأجدى لمن يرى نفسه مظلومًا أن يُثبت للرأي العام بطلان الحكم بدلًا من الاكتفاء بتخليد زنزانةٍ رمزية؟ ولماذا يبني ذاكرةً لمظلوميته ولا يبني مشروعًا للحقيقة؟
إنّ هذه الأسئلة لا تهدف إلى الإدانة المسبقة ولا إلى التبرئة المجانية، بل تُعيد التذكير، في ذكرى تلك الجريمة المروّعة، بحقّ اللبنانيين وذوي الضحايا بمعرفة الحقيقة الكاملة بعيدًا عن الحسابات الآنية والتوازنات السياسية المتقلّبة. فبعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على اغتيال داني شمعون وعائلته، وحدها الحقيقة الموثّقة، قضائيًا وتاريخيًا، قادرةٌ على وضع حدٍّ نهائيٍّ لسؤال “من قتل داني شمعون؟” وإغلاق باب التأويلات، بما يُنهي ثقافة الإفلات من العقاب التي صنعت جانبًا مأساويًا من تاريخ لبنان الحديث.


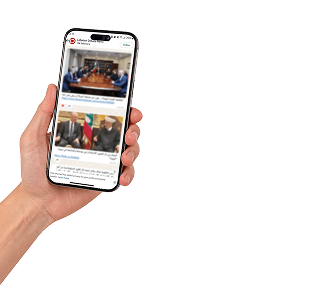




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






