بعد مرور 10 سنوات على هجمات 13 تشرين الثاني 2015 التي هزّت فرنسا، ما زال النقاش محتدماً حول علاقة الدولة الفرنسية بالإسلام السياسي، ولا سيّما تنظيم الإخوان الذي تتّهمه باريس بالوقوف خلف خطاب التطرف. فبينما نجحت الإجراءات الأمنية في الحدّ من خطر الجماعات المتشددة، برزت أسئلة أعمق تتعلّق بالتحوّلات داخل المشهد الإسلامي الفرنسي، وبالحدود الفاصلة بين الدين والسياسة، وبين حرية المعتقد ومخاوف "الانفصالية الإسلاموية" التي تُنسب إلى الإخوان.
في حوار أجرته صحيفة "لا كروا" الفرنسية مع الباحث داميان سافرو، أستاذ الدراسات الإسلامية في معهد العلوم السياسية في باريس، قدّم الأكاديمي قراءة تحليلية لمسار الدولة الفرنسية في مواجهة الإسلاموية وتحوّلات علاقة المسلمين بالمجتمع والسياسة منذ عام 2015.
يرى سافرو أنّ الدولة تعاملت مع مرحلتين متباينتين بعد الهجمات. المرحلة الأولى امتدّت حتى عام 2020، وتميّزت بـ"ردّة فعل أمنية عاجلة" شملت تشديد المراقبة، إنشاء النيابة الوطنية لمكافحة التطرّف، وتطبيق برامج للوقاية وإعادة التأهيل. وقال الباحث إنّ الدولة نجحت في تقليص الخطر المباشر عبر إحباط عمليات وتفكيك شبكات متشددة، لكنّ السلطات أدركت لاحقاً أنّ التطرف نشأ ضمن سياق اجتماعي وفكري طويل الأمد.
من هنا، ظهرت المرحلة الثانية عام 2020 التي انتقلت فيها الدولة من مواجهة الخطر المباشر إلى التركيز على ما سمّاه الرئيس إيمانويل ماكرون "الانفصالية الإسلاموية"، وهو مفهوم تعزّز بعد مقتل المعلّم الفرنسي صامويل باتي الذي قُطع رأسه على يد شاب متشدّد. واعتبر ماكرون أنّ التطرف لا ينفصل عن "بيئة حاضنة" تغذّيه، تشمل وفق الخطاب الرسمي تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان المسلمين وبعض الحركات السلفية المتشددة.
وأشار سافرو إلى أنّ اغتيال باتي شكّل نقطة تحوّل، إذ تبيّن أنّ الدافع لم يكن عملاً فردياً، بل نتيجة تعبئة جماعية قادها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم عبد الحكيم الصفريوي المعروف بخلفيته الإخوانية الدعوية. وأضاف أنّ هذا الحدث دفع السلطات إلى توسيع نطاق المواجهة ليشمل أصحاب الأفكار المحرّضة وليس فقط المنفّذين.
وتُرجمت هذه المقاربة في قانون مكافحة الانفصال الذي أُقرّ عام 2021، واستهدف جمعيات ومساجد ومؤسسات دينية وناشطين يُشتبه في ترويجهم لأفكار الإسلام السياسي. ومن بين الجهات التي طالتها الإجراءات جمعيات مرتبطة بالفكر الإخواني وخطاب "مناهضة الإسلاموفوبيا".
لكنّ سافرو لفت إلى وجود التباس في هذا المسار، قائلاً إنّ وزير الداخلية جيرالد دارمانان تحدث عام 2020 عن ضرورة "توجيه رسالة"، لكن من دون وضوح حول الجهة المقصودة: الإخوان؟ السلفيون؟ أم اليسار المتعاطف مع الإسلامويين؟ وهذا الغموض جعل بعض القرارات تبدو كأنها عقوبات جماعية، مثل إغلاق مساجد بالكامل بسبب خطب أئمة محسوبين على الإخوان، ما أثار لدى بعض المسلمين مشاعر الإقصاء.
وأشار الباحث إلى أنّ ذلك ساهم في اتساع شعور التهميش وتراجع الثقة بالدولة، وصولاً إلى الاعتقاد بأنّ "الإسلام ذاته بات مشكلة في فرنسا".
اكتسب مفهوم "الإسلاموفوبيا" بعد 2015 زخماً سياسياً جديداً. فبينما كان اليسار الفرنسي يتحفّظ على استخدام المصطلح بدعوى غموضه وارتباطه بخطاب الإسلام السياسي، بدأ جزء منه، خصوصاً تيار "فرنسا الأبية" بزعامة جان لوك ميلنشون، يتبنّاه علناً. واعتبر سافرو أنّ مشاركة ميلنشون في مظاهرة 2019 ضدّ الإسلاموفوبيا كانت لحظة فارقة كشفت انقسام اليسار بين تيار علماني تقليدي وآخر أقرب إلى خطاب الإسلام السياسي حول التمييز ضدّ المسلمين.
ومع ذلك، تبقى كلمة "الإسلاموفوبيا" موضع جدل في فرنسا، إذ تُنظر إليها من قبل السلطات على أنها أداة يستخدمها ناشطون إسلاميون، خاصة من يدورون في فلك الإخوان، لمنع أي نقد للإسلام السياسي أو للمقاربات المتشددة.
وتسعى الدولة منذ عقود إلى إنشاء "إسلام فرنسي" يخضع لمؤسساتها، لكنّ ذلك لم يتحقق بعد. فبعد انهيار "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي كان يُتهم بسيطرة الإخوان عليه، أطلقت الحكومة "منتدى الإسلام في فرنسا" في 2022 لإعادة هيكلة التمثيل الديني والحدّ من نفوذ الإخوان الذين واجهوا المشروع باتهامات حول "غياب الشرعية".
وهكذا، يبقى الإسلام في فرنسا بعد عقد على هجمات باريس في وضع مركّب: فخطر الجماعات المسلّحة تراجع، لكنّ الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية الدعوية، ما زال في صلب الجدل العام بين من يعتبره تهديداً لهوية الجمهورية ومصدراً محتملاً للتطرّف، ومن يرى أنّه يتحوّل إلى ذريعة لتعزيز سياسات تمييزية ضدّ المسلمين.

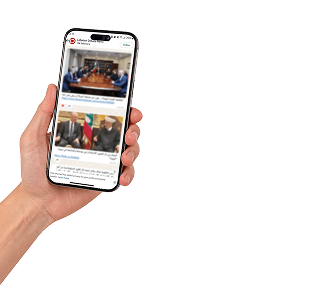




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






