في شباط الماضي، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته قراراً بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم الصينية إلى الولايات المتحدة، في أول خطوة تستهدف بكين خلال ولايته الجديدة. ورغم أن الولايات المتحدة باتت تستورد كميات محدودة مباشرة من الصلب الصيني منذ الرسوم الأولى التي فرضها ترامب وأبقتها إدارة جو بايدن لاحقاً، فإن بكين بقيت حاضرة في السوق الأميركية عبر صادرات تُشترى من دول وسيطة ثم يُعاد شحنها إلى الولايات المتحدة.
ولم يتأخر الرد الصيني، إذ أعلنت بكين فرض رسوم قدرها 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية، و10% على اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، ما ينبئ بتصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
ويعكس هذا التصعيد مخاوف واشنطن من النمو الاقتصادي الصيني المتواصل منذ نحو عقدين، والذي جعل بكين منافساً جدياً على صدارة الاقتصاد العالمي، حيث بلغ ناتجها القومي 17.8 تريليون دولار مقابل 27.7 تريليون دولار للولايات المتحدة (بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2023). غير أن هذه المنافسة الاقتصادية تخفي صراعاً أوسع يتعلق بالهيمنة على النظام الدولي خلال العقود المقبلة، بعد عقود من التفرد الأميركي منذ تفكك الاتحاد السوفياتي بداية التسعينيات.
وبحسب إستراتيجية الأمن القومي الأميركية، تُعد الصين القوة الوحيدة التي تملك "الرغبة والقدرة" على تغيير شكل النظام الدولي، فيما يزيد من تعقيد المشهد أنها قادمة من فضاء سياسي وثقافي مغاير تماماً للبيئة الغربية التي قادت العالم طويلاً.
وفي ظل هذا التحول العالمي، يعود الاهتمام إلى نظرية "الواقعية الهجومية" التي طرحها عالم السياسة الأميركي جون ميرشايمر في التسعينيات، وتقدم تصوراً تشاؤمياً لمستقبل العلاقات الدولية عامة، وللعلاقة الأميركية الصينية على وجه الخصوص.
ينقسم منظّرو العلاقات الدولية إلى تيارين أساسيين: المثاليون (الليبراليون) والواقعيون. ويعتقد المثاليون أن العلاقات الدولية يمكن أن تتجه نحو السلام والاستقرار مع انتشار الديمقراطية واقتصادات السوق، وهو ما تعزز بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وصعود فكرة "نهاية التاريخ" لفوكوياما.
وعلى هذا الأساس، ساد الاعتقاد بأن التطور الاقتصادي في الصين سيؤدي إلى نمو طبقة وسطى تُمهّد لتحول ديمقراطي، انسجاماً مع أطروحات بارينغتون مور حول الارتباط بين الديمقراطية وصعود الطبقة الوسطى.
لكن الواقعيين يرون أن النظام الدولي بطبيعته تنافسي وصراعي، وأن القوة هي العامل الحاسم، وتاريخياً شكّل هذا المنظور الأساس لفهم العلاقات بين الدول، منذ أفكار ثوقيديدس مروراً بميكافيللي وهوبز، وصولاً إلى الواقعية الجديدة التي أسسها كينيث والتز، الذي يرى أن النظام الدولي "فوضوي" بطبيعته، وأن الدول تتشابه في الوظيفة وتختلف فقط في القدرات.
ينقسم الواقعيون إلى "دفاعيين" يرون أن الدول تسعى للأمن، وإلى "هجوميّين" مثل ميرشايمر يرون أن الدول تسعى إلى تعظيم قوتها بلا توقف، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالهيمنة.
يطرح ميرشايمر في كتابه "مأساة سياسة القوى العظمى" خمسة عوامل تجعل الصراع على القوة حتمياً: فوضوية النظام الدولي، امتلاك القوى العظمى قدرات هجومية، غياب القدرة على معرفة نيات الدول الأخرى، مركزية مسألة البقاء، و"عقلانية" الدول في حساب المكاسب والخسائر.
ويُظهر التاريخ القريب كيف أدى امتلاك الولايات المتحدة القنبلة النووية ثم امتلاك السوفيات لها إلى سباق تسلّح طويل وانفراج نووي لاحق، فرضته حقيقة قدرة كل طرف على تدمير الآخر بالكامل.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بدت الولايات المتحدة في طريقها لهيمنة مطلقة، لكن ما يسميه ميرشايمر "القوة المانعة للمياه" جعل السيطرة الكاملة على العالم مستحيلة. فمنذ تأسيسها، توسعت الولايات المتحدة إقليمياً، ثم منعت القوى الكبرى الأخرى من الهيمنة في مناطقها، عبر التدخل في الحربين العالميتين وفيتنام وأفغانستان وغيرها.
يرى ميرشايمر أن الصين تسير على الطريق نفسه: محاولة السيطرة على محيطها الإقليمي أولاً، لكنها تصطدم بحضور عسكري أميركي ثقيل في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وعبر تطوير قوتها البحرية والجوية والصاروخية، تسعى الصين لفرض "منطقة حظر وصول" في بحر الصين الجنوبي، ومنع القوات الأميركية من الاقتراب، وهو ما قد يتحقق بشكل واسع بحلول 2030.
وتشير التقارير إلى أن الصين باتت قريبة من امتلاك قدرات بحرية وصاروخية قادرة على تهديد حاملات الطائرات الأميركية، وأن تطوير قاذفات مثل "H-20" وصواريخ "دونغ فينغ" يهدف إلى تقليص تفوق واشنطن الإستراتيجي.
هذا المسار، إذا تواصل، قد يجعل المواجهة المباشرة بين البلدين مسألة وقت، كما تقول نظرية "فخ ثوقيديدس"، القائمة على أن القوة الصاعدة تهدد القوة المهيمنة فتتجه العلاقات نحو الصدام.
ورغم هذا التشخيص المتشائم، يرى آخرون أن الصراع ليس حتمياً، فهناك أدوات ضغط غير عسكرية قد تستخدمها واشنطن، كما أن بكين قد تفضّل تفادي المواجهة المباشرة واستثمار عامل الوقت، فيما يشكل الردع النووي عامل توازن يمنع الانزلاق إلى حرب مدمرة.
وإذا نجحت الصين في تعظيم قوتها دون صدام، فقد يتشكل نظام عالمي ثنائي القطب شبيه بالحرب الباردة، لكنه أكثر استقراراً نسبياً. أما إذا تحققت رؤية ميرشايمر بوقوع صدام مباشر، فقد يعني ذلك نهاية العالم الدولي كما نعرفه اليوم.

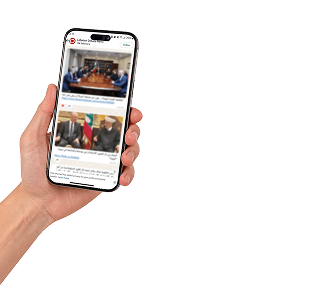




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






