"ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي
للسنة الثانية على التوالي، تأخّر موسم الأمطار في لبنان، الذي من المفترض أن يبدأ في شهر تشرين الأول ويمتد حتى شهر آذار من كل سنة، بينما يبقى نحو 6 إلى 7 أشهر من دون أمطار. ما يرفع نسبة القلق والتخوّف من أن يكون شتاء 2026 مشابهاً للعام الماضي لجهة تراجع نسب المتساقطات، خصوصاً أنه لا وجود لخطة رسمية لمواجهة هذا التحدي الذي يطال جميع اللبنانيين، بل مجرد حلول ترقيعية وآنية من قبل وزارة الطاقة والمياه، تعتمد على استخدام المياه الجوفية بشكل عشوائي وفوضوي لتعويض النقص، في حين يبقى مجلس الوزراء غائباً تماماً عن مقاربة هذه المشكلة الطارئة. علماً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجّه إنذاراً قبل نحو 10 سنوات حول المخاطر التي تهدّد قطاع المياه في لبنان، من دون أن تقوم الحكومة بأي خطوة جدية تجاه هذه المخاطر المتعاظمة.
وفي ظل أزمة المياه غير المسبوقة التي يواجهها لبنان عاماً بعد عام، بات من الضروري أن تتخذ الدولة خطوات جذرية لصون الأمن المائي للبلاد، بدلاً من الحلول الترقيعية والاعتماد المتكرر على إجراءات الطوارئ عند كل تفاقم للأزمة. وللتذكير، فإن معدلات الأمطار في عامي 2024–2025 تُعد “الأسوأ منذ 80 عاماً” في سجلات لبنان. وقد انخفض معدل الهطول السنوي في الموسم الماضي بنسبة 50 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الماضية الذي تراوح بين 700 و1000 ملم. ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض مفاجئاً تماماً؛ فبحسب المجلس الوطني للبحوث العلمية، انخفض معدل الهطول السنوي إلى 600 ملم في سنوات 2014 و2018 و2021 بعد أن كان يبلغ 800 ملم سنوياً، كما تقلّصت فترة تغطية الجبال بالثلوج إلى 30 يوماً بدلاً من 120 يوماً سابقاً، ما أدى إلى ذوبان سريع للثلوج وحرمان الطبقات الجوفية والينابيع من التغذية الطبيعية.
ووفق تقديرات “المرصد اللبناني للمياه” لعام 2023، أصبحت حصة الفرد السنوية من المياه في لبنان أقل من 500 متر مكعب، أي دون نصف خط الفقر المائي المحدد بنحو 1000 متر مكعب، وأيضاً دون خط الندرة المائية المحدد بنحو 500 متر مكعب. وهذا يعني أن لبنان دخل في مرحلة الفقر المائي المدقع. وأشار تقرير صادر عن “يونيسف” و”واش كلاستر” حول قطاع المياه في لبنان إلى أن “تأثير الجفاف في لبنان أصبح مدمراً بالفعل، إذ يعيش 1.85 مليون شخص في مناطق شديدة التأثر بالجفاف، ويعتمد أكثر من 44 بالمئة من السكان على خدمات صهاريج المياه المكلفة وغالباً غير الآمنة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل”. فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة على السكان نتيجة تضرر قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والصحة وغيرها.
وأصبحت صهاريج المياه الخاصة اليوم هي المصدر الرئيسي، لا الاستثناء، لتوفير المياه لعدد كبير من اللبنانيين، بما في ذلك سكان بيروت وضواحيها، في ظل غياب ضمانة الدولة لتزويد الناس بالمياه بشكل مستدام. وتعمل هذه الصهاريج من دون أي رقابة حكومية، فضلاً عن أن كلفتها أعلى بكثير من تلك التي تقدّمها مؤسسات المياه الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة المياه على المواطنين.
ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد الآبار نتيجة انتشارها العشوائي، إلا أن تقارير البنك الدولي لعام 2022 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 تشير إلى وجود نحو 100 ألف بئر غير مرخصة، مقابل 15 ألف بئر مرخصة، و4 آلاف بئر تابعة للدولة، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة والمياه بين 2020 و2023، كما يشرح الخبير أحمد الحاج.
قصور بنيوي في مقاربة ملف المياه!
يشرح خبير مختص لـ”ليبانون ديبايت” أن “لبنان يتعامل مع أزمة المياه عبر خطوات مؤقتة تركز على الترشيد والحلول الطارئة، مثل دعم الريّ بالتنقيط ونشر الوعي حول ترشيد الاستهلاك، ودعم بعض المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، إضافة إلى استجابات دولية وإنسانية محدودة من منظمات مثل اليونيسف”. ويوضح أن “هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، ضعف البنية التحتية، تفاقم الهدر بسبب التسرب والريّ العشوائي، والتلوث الناجم عن سوء الإدارة، ما يجعل البلاد عرضة لكارثة مائية حقيقية إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية وشاملة”.
ويضيف: “هناك قصور بنيوي في مقاربة ملف المياه، يتمثل في غياب بنية تحتية وطنية قادرة على جمع المياه وتخزينها، ما يحدّ من قدرة لبنان على التعامل مع ندرة المياه على المدى الطويل. كما تتجاوز نسبة هدر المياه بسبب التسرب والريّ العشوائي 35 بالمئة سنوياً، فضلاً عن انتشار الآبار الملوثة بمياه الصرف الصحي التي تلوّث المياه الجوفية والخزانات المنزلية، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المائية، ما يحد من فعالية أي حلول مطروحة”. ويشدد على أن “الحلول المطلوبة تبدأ بإطلاق خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تشمل بناء السدود والاستثمار في حصاد مياه الأمطار، والتحوّل إلى الزراعة الذكية مناخياً، والاستثمار في طرق ريّ أكثر كفاءة، وتطوير قوانين صارمة للحد من حفر الآبار العشوائي ومعالجة التلوث، وتنفيذ إصلاحات في تسعير المياه وزيادة الشفافية في إدارة الموارد”.
وينبّه المصدر إلى “ضرورة تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية في إدارة الموارد لضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً على المياه”. ويؤكد أنه “حتى الآن، لا تمتلك الدولة اللبنانية خطة وطنية شاملة وفعّالة لمواجهة تراجع المتساقطات وتفاقم أزمة المياه، رغم أن الظاهرة أصبحت واضحة في السنوات الأخيرة نتيجة تغيّر المناخ وسوء إدارة الموارد”. ويجزم أن “ما تم طرحه من مبادرات قطاعية مثل مشاريع السدود (بسري – المسيلحة – بلعة…) إما متوقف أو مثير للجدل أو غير مكتمل، كما أن هناك خطط دعم لمؤسسات المياه من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لكنها تبقى تقنية ومحدودة، إضافة إلى مبادرات فردية في بعض البلديات أو المنظمات المدنية للريّ المستدام وجمع مياه الأمطار والتوعية”.
ويختم: “الدولة على دراية بالخطر، لكن التحرك لا يزال جزئياً وبطيئاً وغير مواكب لحجم التحدي”.


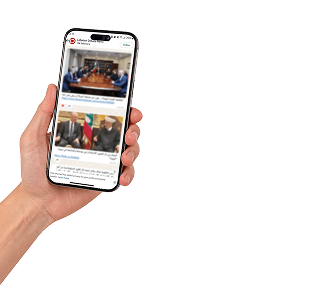




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





