هل حقاً زالت الحواجز بين الناس ولم يعد للحدود الجغرافية تلك الأهمية التي عرفناها على مَرِّ السنين؟
العالم يجري بسرعة، ما كان يحتاج سنين صار يحدث في أيام، وما كان يحصل في أيام لم يعد يلزمه أكثر من ثوان معدودات. المكتبة التي كانت تحتل غرفة كاملة بتنا نحملها في «جهاز» أصغر حجماً من كتاب، الأغنيات التي كانت تُسجَّل في الأسطوانات والكاسيتات صارت تُخزَّن في الهاتف الجوال أو في وسائط الواحد منها بحجم أنملة، وقِسْ على هذا المنوال. الأهم من هذا كله تواصلٌ آخذٌ في الاتساع بين أهلِ معمورة متعددة العرق والثقافة. تواصلٌ ذو حدَّين، ليس بالضرورة أن يكونا متناقضين، بل لعلهما متلازمان متوازيان. من جهةٍ يتعارف الناس ويتعرَّفون بعضهم على بعض، بما يُضمره التعارف من فضول ورغبة باكتشاف الآخر ولو «افتراضياً» عبر الصور والكلمات. هنا لم يعد الآخر مجهولاً أو مجرداً، صار معلوماً ومعروفاً، ولئن كان الإنسان عدو ما يجهل، فإن النتيجة «المنطقية» لـ «واقع افتراضيّ» مستجد جعل المجهولَ معلوماً هي أن يصبح العالم أقل عداوة وحروباً ونزاعات، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
من جهة ثانية، يمثِّل هذا الانفتاح الهائل «خطراً» على الهويات القومية والثقافات المحلية ما يدفع كثيرين للانكماش والانغلاق ومحاولة سدّ النوافذ في وجه رياح «الثورة الرقمية». برهانُ هذا «الخطر» تنامي التيارات اليمينية المتطرفة والأصوليات الدينية والعرقية في أنحاء العالم كله، ومشاعر النقمة والغضب حيال المهاجرين واللاجئين. هل أنكى من أن يكون مثل دونالد ترامب بخطابه المقيت رئيساً محتملاً للدولة الأقوى؟
ما يعزّز الاتجاه الثاني من معادلة حائرة بين انفتاح وانغلاق، هو عدم التوازن بين عالمين، واحد متقدِّم منتِج لأدوات العصر (لا نقول إنه خال كلياً من الأزمات)، وآخر رازح تحت وطأة الحروب والفقر والأمية والبطالة، مستهلِك لكلِّ ما ينتجه العالم الأول. عالمٌ مهيمِنٌ مسيطِرٌ، وعالمٌ مهيمَنٌ ومسيطَرٌ عليه. المفارقة أن الأول يبدو أيضاً خائفاً وهلِعاً، لم تعد الحروب بعيدة أو «نظيفة» كما كانت تبدو، أو كما كان يُراد لها أن تبدو. الإرهاب المعولَم بات قادراً على الضرب أنَّى ومتى يشاء، موجات الهجرة عبر بحارٍ تحوَّلت «مقابر مائية»، صارت فزاعة تخيفُ المتمسكين بـ «صفاء» مجتمعاتهم وأعراقهم، التنقل بين البلدان غدا محكوماً بهواجس الأمن ومستلزماته، الحدود الجغرافية التي خلخلتها «العولمة الافتراضية» يسعى حرّاسها جاهدين لإعادتها الى سيرتها وصورتها الأوليين.
صحيح لم يعد للحدود الجغرافية الأهمية والجدوى اللتان كانتا عليها، لكن على الرغم من تشكِّل ما يُشبه كوكباً افتراضياً في استطاعة «مواطنيه» التواصل في ما بينهم بلا حدود ولا رقابة، فإن حدوداً أخرى أكثر رسوخاً لا تزال تفصل بين أهل المعمورة الواحدة، وتترسَّخ وتتعمق وتعلو أسلاكها الشائكة، هي حدود العلم والمعرفة. لا يستوي منتِج المعرفة مع مُستهلِكها، حتى لو تواضع الأول وسعى الى شيء من العدالة والمساواة. فكيف الحال اذا كانت مصالحه ومطامعه تدفعه الى التمسك بهيمنته وسيطرته، وتوسيع الفجوة بينه وبين الآخرين؟
لئن فهمنا أن «صناعة المعرفة» والتكنولوجيا الذكية الممكن استخدامها في جميع المجالات بلا استثناء، هما ثروة العصر الرقمي لا فقط ثورته، وميدان الاستثمار المستقبلي الأهم، نستطيع أن نفهم كثيراً من تحولاتٍ مفصلية جارية في العالم بالنار والحديد ودماء الأبرياء، ولا سيما في منطقتنا التي تراجعت مكانتها الاستراتيجية بفعل أسباب كثيرة من أبرزها تخلّفها عن إنتاج «المعرفة» بعد أن تخلَّفت أصلاً عن ركب الثورة الصناعية، وبداية أفول مكانة النفط كمحرك أساس لاقتصادات العالم.
تتخلخل حدود ومسلَّمات وتنشأ حدود ووقائع جديدة، والمؤسف أن حدوداً معرفية وثقافية تفصل بين عالمين هي أشدّ وأدهى من حدود الجغرافيا، وأكثر قابلية لمزيد من التمييز والشعور بعدم العدالة والمساواة ما يؤدي الى مزيد من العنف والكراهية في عالم بأمسِّ الحاجة الى الحُبّ والإنصاف.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


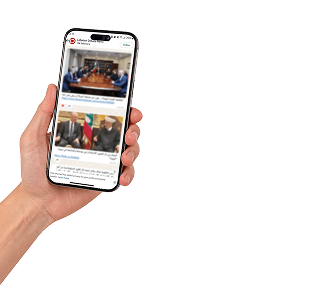




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





