العالم بات وراء واجهات تخفي ما تخفي من غموض، وعيون مؤرقة، وأفواه تنتظر الكلام أو الخراب أو الموت كأنها تهددنا باستمرار. أوروبا، المفككة سياسياً واقتصادياً ولغوياً، تخفي ديناصوراتها القديمة، في أدغال هذه الحضارة التي ما إن تجهر حتى تعلن احتضاراً طويلاً.
واجهات لماعة، وبضائع، ومصارف، وشركات، ومقاه، ومكتبات، ودور سينما… وكلها من إرث بات من التباس بلا تاريخ. ولا جغرافيا. لكن العالم بخير ما دامت الواجهات اللماعة بخير! وإن بلا قوة، وإن بلا سطوة، وإن حتى بحضور أشبه بالغياب: من النازحين والمهاجرين، والحدود بجدرانها العالية، والناس بجدرانهم الصلبة، يتفكك الزمن بين أيديهم. والأمكنة. والروح. والضوء. والتاريخ. كأنما في القرون الوسطى أو ما قبلها. أو في الحرب الثانية أو ما قبلها وبعدها. هذيان بلا مقدمات يدفع الأدغال من خلفية الواجهات إلى الشوارع، والعقول، والأجسام، والأفكار.
كل هذه الخواطر تبلبلت في رأسي، إثر مجزرة باريس، وقبلها “شارلي إبدو”، والثلاثاء في مطار بروكسل. أوروبا والعالم نهب الفوضى، فريسة من فرائس الإرهاب. ولا منأى، ولا سماء، ولا سقوف. كل دولة باتت على حدة تنصرف إلى مخاوفها. كل حدود باتت آخر حدودها، تزرع الأسوار والنبذ، والفقراء، والمظلومين، من أبناء هذا العالم الواسع، الذي على رحابته بات أضيق من دمعة.
تعيش أوروبا اليوم عنصراً انتكاسياً انقلبت فيه كل الأدوار وتعثرت عليه كل الخطى. لا أمن. لا اقتصاد صلباً. لا اطمئنان. لا يقين. كأنها مشروع هجرة تواجه التهجير، وكأنها هياكل مرفوعة طنانة تتلقى الضربات. أي ضربات؟ من حيث انتهت أوروبا، وبدأت صراعات الماضي، والأشباح، والنهايات، وأشكال الانحطاط، منفتحة على كل من يجعل العالم الثالث مكاناً جوالاً بالدم، والخراب، والتعصب، والجنون، والعنف، والانقسامات، والشروخ: كأنه مكان اللامكان.
أوروبا اليوم باتت على صورة ما رسمته من مستعمراتها القديمة، خصوصاً في هذا الشرق المرتد على أنواره ومحفوظاته، وكنوزه وتراثه وإبداعاته. أوروبا شجرة رمت ثمارها وتعرّت للفصول القاسية، والعالم العربي رمى إرثه الروحي والإشعاعي والحضاري، وتعرى أمام الرياح الآتية من الجحيم. الإرهاب في أوروبا (ومن أوروبا)، والإرهاب في عالمنا العربي، يجتاح كل التواريخ: الإسلام، والمسيحية، والتنوير، والعقل. اليقظة المتأخرة في أوروبا، والصحوة الميتة عندنا.
التفكك العضوي في بلاد الديموقراطية، والقيم الجمهورية، ومثله في بلادنا، في أمور الدول وكياناتها والناس ومعتقداتها، والأمكنة وشياطينها، والأزمنة بأفكارها السليبة. كأنهما على تمازج “حضاري” متشابه من نوع جديد. على تلاق موضوعي في منعطفات: فاحت العنصرية في العالم المتحضر، عاد العنف الأبيض بعيونه الزرق، وعبق الموتى الطالع من النازية القديمة، وجنرالات أميركا اللاتينية، والثورات المنقلبة، والاستهلاك، ونظام الأشياء والتكنولوجيا المستبدة، وديكتاتورية البنوك… تراجعت الدول وكأنها دالت، والمؤسسات وكأنها تطفو على حرائق، والثوابت كأنها بلا جذوع: عالم مفضوح حتى الانتهاك، ومُنتهَك حتى العجز.
لمعان الواجهات
كل شيء يتحلّل في لمعان الواجهات، وعروض الأزياء، وتجارة الرقيق، والأطفال، والجنس، والعنف، والدين: صارت كلها من متاع الراحلين بلا عودة.
صورة العالم، من دونالد ترامب، إلى لوبان، إلى النازيين الجدد في ألمانيا، إلى حزب الشاي في أميركا، إلى الغيتويات في فرنسا إلى أواصر العداء، إلى حروب المذاهب، والأديان، والفِرق، والعُصب، والرايات، كلها باتت سوداء على حُمرة، وخضراء على خناجر، أو بيضاء على فراغ. صورة العالم البعيد (الأقرب بموته إلينا)، هي صورتنا، إمبراطوريات تعود بنرجسيات مرضية، عفنة من عفن الموتى بعنصرية الظواهر العاتية، بمطامح الطغاة، وجنون الابتزاز الديني، والثقافي، عندنا هنا بوتين الآتي من دهاليز المخابرات إلى قمة المنتقم، أسموه القيصر، وأسموه ستالين. وأسموه إيفان الرهيب. وعندنا المواجد المدفونة من طبائع الإسلام والمسيحية واليهودية، تنفض غبارها، وتحتل الساحات والمدن، والدساكر، بأنظمة العقول ووتائرها.
وعندنا، اليوم، إيران المتآكلة ترجع بأبهة الفرس، على جياد الأئمة، ومركبات الآلهة. بوتين آخر، هو خامنئي، وقيصر آخر، أو كسرى آخر، يمشي بخيلاء على أرض محروقة، وعلى دماء طازجة، وجارية بلا روافد. وعندنا نمارقة الأصوليات والتكفير، من أحزاب انتحلت السماء والله و”القداسة” والعصمة، والانعزالية، لتجعل عالمنا يشبهها: سفراء الموت، إلى أقصى عنفهم، وطغيانهم، وعمالتهم المتأصلة كطبائعهم الأولية…
إسرائيل المختزلة
وها هي إسرائيل، الصورة المختزلة لكل هذه الظواهر “الشيزوفرانية”، المتطرّفة المعتصّبة، ترفع “أباطرتها” القدامى، تنبشهم من قبورهم، وتبعثهم لتصنع منهم حضوراً “نموذجياً” لهذا العالم الطاعن في ترحالاته: التوراة “خارطة تاريخ”، أو خرافات ذرائع، أو مجازات ظلامية، مبعثرة جمعت، و”رؤى” ملمومة. الأسطورة تصبح تاريخاً والواقع أسطورة.
لكن، ها هي، على دوراتها “الأخروية” أيضاً باتت تشبه ملموماتها العشوائية: العنصرية من باب “الحق الإلهي”، والعدوان من باب “الوصايا”، والمستوطنات من باب الاستيهام، لكن أوليس هذا ما يشير إلى ارتداد صورتها المفبركة عليها: أصارت هي مجرد كانتونات وغيتوات اثنية؟
انتهت الصهيونية ولم تنتج سوى عصائب التطرف، والقتل، والهويات المتضاربة: كانت إسرائيل تريد أن تقدم نفسها على صورة أوروبا، ربما! لكن اليوم باتت أيضاً على صورة أوروبا المفككة، المفلسة، المضروبة على خواصها، ووحدتها، وبنيتها. هناك في أوروبا كلام على حروب أهلية، وكذلك في إسرائيل، علماً بأن إسرائيل ورثت القرون الوسطى وتاريخ أميركا مع الهنود والزنوج… لترفع نموذجها إلى أقصاه. كل شيء على آخره، ولن تسلم دويلة “الملالي” اليهودية… فالكوليرا التي استوردتها من كراريسها، ومن تواريخ الاستعمار والهمجية، ثم صدّرتها… ترتد عليها: فالهواء واحد في هذا الفضاء المفتوح، وفي هذا العالم الصغير.
الأرض الخراب
كأنما شريط واحد يمسك بالحواس، والأمكنة والظروف والتواريخ: “الأرض الخراب” (بالإذن من إليوت)، كأن الأرض كلها صارت خربة، وسديماً فوضوياً، بلا علامات ثابتة، وبلا أصول، ولا بوصلات، وحتى بلا جذور. كأنما الإنسان الذي صنع كل تلك الحضارات، وحاول أن ينقل الجنة من السماء إلى الأرض، ينتقم من نفسه، ويتنصّل من صنائعه، ويرمي كل شيء في طاحونة عمياء، هي استهلاك التاريخ، والماضي، والحاضر والمستقبل.
تسليع كل شيء: الموت كالحياة. الآخرة كالبداية، الطبيعة كالآلات، والكائنات كالبضائع، والمتاحف كالحطام، والقيم كالنفايات… اختلطت الأزمنة باختلاف الأثمان والأسعار. لكل شيء سِعره، لأنه فقد ثمنه “الرمزي”؛ بازاراً كونياً صار العالم، سوقاً معولمة مبوبة بتصنيفاتها الجذابة بكل البضائع والسلع من الأفكار إلى المعتقدات، إلى الفلسفات، فإلى التكنولوجيا، والسلاح، والموتى والأحياء، النووي والكيمياوي… الأدبي والفكري… كل ذلك على تبويب من صنع العقول الإلكترونية البيروقراطية، المحدودة، ومن نزعات أباطرة المال، والسلطة، والعصابات، والأنظمة، والكتاتيب، والتطرف، والأصوليات، والطائفية والعنصرية… كلها بضائع برسم التوزيع والتصدير والاستيراد: منطق السوق بات لا معقول العالم.
من هنا، بات هذا العالم مكاناً موبوءاً، موتوراً، تهزهزه النكبات الأزمات، وترعبه المآتي، لأنه لم يترك أمكنة للأمان، والاستقرار، والنهوض، والاسترجاع، وإعادة البناء، والإصلاح: فأوروبا أشلاء، والعالم العربي على ارتداد، والاقتصادات على كف عفريت، والأنظمة تتقدم على رمال متحركة، والحضارات نَهبُ الاحتضار، والحروب الصغيرة تنتج مآسي كبيرة، وكوارث لا حدود لها، ولا شيء يردعها، لأن كل شيء بات كأنه على أواخره، أمام أبواب موصدة، وأمام ظواهر امتزج فيها خراب الطبيعة بخراب الثقافات، خراب الكائنات باستبداد التكنولوجيا، خراب الاجناس بخراب الشركات والمؤسسات العابرة القارات بأمراضها، وجنونها، وسحقها لكل ما هو قائم.
علامات النهايات
وما نشهده اليوم كأنه من علامات النهايات، ومن أعراض الفوضى التي تسترجع عناصر الجيولوجيا بلا صفات ولا أصول، لتنقلب السمات، وتتدحرج الجِبلاّت التي هي من ضرورات حتى بقاء هذا العالم، حتى استمرار الحياة على هذا الكوكب: وما الذي مسته هذه الأعراض ولم يفسد، أو يُلوّث، أو يندثر، أو ينقرض، أو يتماوت: من البحر الذي بات جزيرة عائمة على الموتى، فإلى الطبيعة التي باتت مقبرة لكائناتها، فإلى المناخ الذي بات مجرد وسيلة لخرابه وللحياة نفسها التي باتت أداة لنفي نفسها، وللغرائز التي ارتدت على كل ما هو “قيمي” وموضوعي، وللماضوية التي، بعد إشعاع الحاضر على المستقبل، باتت مدفاقة بظلاميتها، وعنفها، وعدميتها، وافتراسها كل ما هو مضيء في هذا العالم، وفي العقول، وفي الأبدان، وفي المصائر، والجمهوريات والكيانات التي باتت أشباحاً تدب في احتضاراتها، أو آلات تدمر في مساراتها، أو خرباً خلف أبهة الصولجانات والسلطنات، والطغيان، كشركات مفتوحة لأسواق القتل، والدمار…
كأن كل شيء بات مستبداً وخاضعاً للاستبداد قوياً ويسري فيه الضعف، غنياً ومهدداً بالفقر، فقيراً ومهدداً بالزوال، طاغياً وتحت الطغيان، خطراً وهشاً، شرساً وجباناً، عقلانياً في هلوساته، ومهلوساً في عقلانيته، تنويرياً في دربه وظلامياً في كواليسه وكوابيسه.
العولمة
يُقال أن “العولمة” من أسباب تلك التداعيات، والاستمارات العبثية الجديدة، ووصول العالم إلى لعبة المنعطفات الخطرة، ذلك لأنها حوّلت “العالمية” المبشرة بزمن جديد بعد الحرب العالمية الثانية إلى نقيضها، وحوّلت الليبرالية ذات الأفق التعددي، الديموقراطي، والإنسانوي، إلى وحش يفترس الأفكار، والجمهوريات، والدول، والاقتصادات، والجوهر الذي يربط الكائنات ببعضها، والتواصل الذي يفرش جسوراً لا تنتهي بين الحدود. لكن العولمة ليست فكرة “مجردة”، هيولية، طوباوية، بل هي واقع مصنوع، وظاهرة متجسدة، بناها الناس أنفسهم، بل كأنها آخر الإيديولوجيات التي لم تترك مكاناً في جوانبها لليوتوبيات، والأحلام، والمخيلات، وحتى المنامات. كتلة عرف صانعوها كيف يؤلفون هياكلها المعدنية الصماء ودولاب ضخم يسحق كل ما في طريقه، في الأرض والسماء في الجنوب والشمال في الغرب وفي الشرق، في أوروبا وفي أميركا وفي بلادنا.
إنها الإيديولوجية الجديدة التي انتصرت بلا غريم، ولا منافس، ولا مُعارض. بل هي الإيديولوجيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. الكل يحاول تلقيها بطريقته (لا دفعها)، واحتضانها وإن وقعت على صوره ككرة النار: حوّلت كالحجر “الفلسفي” كل شيء إلى مادتها: الإرهاب صار معولماً، الاقتصاد صار معولماً. الجمهوريات، الديموقراطيات، الأديان، الطائفية، العنف، وسائل الاتصال، الآثار، الفنون، العائلة، التاريخ، المدرسة، المشاعر… بل كأنها صارت طبائع ثانية حلت محل الطبيعة الأولى؛ إنها “الثقافة” القاتلة لأنها قاتلة الثقافة.
ونظن أن آثارها هذه، وشواغلها، وظواهرها، ونموها السرطاني، جعلت العالم واحداً في بواطنه، وجذوره، وفروعه، وأفكاره، وأحداسه. وما نراه اليوم، من انحطاط شامل، ومن قهقرى، ومن نزاعات، ومن تزايد الفقر، والهجرات والحروب، وكوارث الاقتصاد، والكوارث الطبيعية، والاحترار المناخي، وما يخلفه من انقراض للكائنات النباتية والحيوانية…
هو انقراض للكائن الإنساني، بما تراكم عليه من إنجازات ألفية، وحضارية، لتشييئه، وتسليعه، وتصنيفه، وتبويبه، وترتيبه، وتصنيعه وتوليفه: صحيح أن التكنولوجيا والاختراعات الطبية والتقنية، ووسائل الاتصالات، والعلوم، قد سجلت تطوراً مذهلاً، لكن لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تحترم كل هذه الانجازات “الإنسان”، فاكتشاف سر “الجينات” انتصار مذهل، لكن ماذا لو استخدمه العقل المعولم ضد وجود الكائن البشري، بابتكار ما يسمى «سوبرمان» اللامتناهي الكفاءة والقوة والتمكن ليحل محل الإنسان العادي في وظائفه ومهنه وأشغاله؟ تماماً كما استخدم الابتكارات الحربية لدفاع الشعوب عن نفسها، ليحوّلها أداة لإبادة الإنسان نفسه، وحتى الأرض. فكل ما يُسلّع كبازار ومنافسة ومردود وربح يصبح عدواً للبشر إذا لم يخضع لمواصفات تجعل منه أداة رفاه، وتقدم، وسعادة؟ أوليس عندنا ما يسمى “أسلحة الدمار الشامل”؟
“الأرض الخراب” اليوم، وربما غداً أنقاض، أو استبداد خفي، لأن العولمة التي صنعها الإنسان، على صورتها الحالية، هي وحش. اخترعه الإنسان، وسيفترسه، إنها “فرانكشتاين” الذي تفوّق على صاحبه، أو “عولم” صاحبه، وكل شيء… ليصبح العالم كله، شعوباً، وأمكنة، وطبيعة، وحضارة… مكاناً زائلاً، أو محوّلاً، متبرجاً لأبسط الشروط الإنسانية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


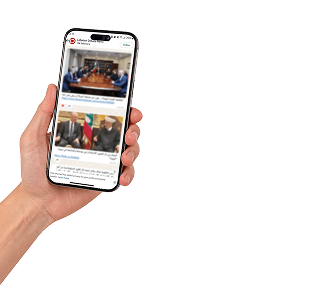




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





