عندما تشاهد بشار بن حافظ الأسد على الشاشة ترى شخصاً غادره كل شيء. بلا متاع. بلا ارث. بلا حَيل. ولا رجاء. ولا مستقبل ولا ماضٍ. شخص مَصَلتْ جذوره. شخص لم يَعدْ سوى الزمن. والزمن بات بعيداً عنه. كل ما حوله حيطان وخيبات ومُلك ضاع. لا جيش. ولا شعب سوى ما تبقى من قبيلته . رأسه لم يعد على كتفيه. وعيناه لم تعودا في وجهه، ومصيره بديد. لا يقوى على البقاء. ولا على الرحيل. لا على الصعود ولا على الترجل. لا على المواجهة ولا على الاستسلام. يحارب ولا يحارب. يقود وهو مَقود. يصرخ بأصوات سواه. يُصرّح بمواقف سواه. “ينتصر” بقوى سواه. ويخسر بخسارة سواه. يقتل بإرادة سواه. انه الشخص الذي فقد ظله. أو الشخص الذي احتّله ظلُّه. ظِلّ بين المعادن. ظل بين جدران القصر. ظل على الشاشات. يتكلم صدى صوت من تملّكه. هنا الروس. هنا “حزب الله”. هنا فيلق القدس. هنا أوباما… كلهم موجود وحاضر إلاّه! فيا لهذا البقاء غير الباقي… ولهذه النهاية غير المنتهية. ويا لهذا الموت الذي لا ينتهي.
انه الشخص الذي فقد زمنه. ورث ما ورث. وبدّد كل شيء حتى لم يتبق له سوى يديه الخاويتين وسوى عينيه الشاغرتين. لا شيء. ولكن عندما يتكلم كأنما شخص آخر يصغي ويتكلم. وعندما تمتعت بخطابه المتلفز امام مجلس الشعب المنتخب (أي المعيّن) شعرت انه واقف وغير واقف. ومخاطِب وغير مخاطَب. فلا هو محدّد ولا من يسمعه معروف: هو بدَا مجهولاً ومجلسه مجهولاً: مجهولان تصادفا في قاعة.
فلا هو، رئيس يتكلم، ولا مجلس الشعب مجلس يصغي كأنما ديكوران من أدوات قديمة، لمسرحية قديمة، ولشخصيات قديمة، وحكاية قديمة. مجلس الشعب أشباح تصفق لشبح. أشياء تتحرك نحو أشياء. وعندها يحلو كل شيء، حتى ما هو غير موجود (ومتخيل) وما هو موجود (وغير متخيل) . قاعة صَفْصَفْ، بجدران من فرط ما اصغت إلى الفراغ شحُبتْ ألوانها، وضجرت حجارتها! اذاً في مثل هذه المونودرامات “اللوناتيكية” يصبح كل شيء ممكناً. وكل فصام عافية ذهنية، وكل ميغولومانيا تماسكاً نفسياً وكل تهريج نوعاً من الدراماثورجيا. كأنها اللحظة التي تفصل بين الجسد والمكان، بين المكان وسكانه. بين سكانه ووجوههم. اذاً هنا تزول المفارقات بين ما هو جنوني وما هو هلوسي، وما هو نِهيلي ذاتي وما هو حقيقي. وما هو حقيقي وما هو تصوري. ما هو حاضر وما هو ماض. ما هو زمني وما هو غير زمني… بين ما هو مادي وما هو غير مادي. فتلتبس الأحجام والأوزان والنبرات والقامات فتظن وهو يتكلم عن “انتصاراته” وكأنه انتفخ كبالون ضخم مكتظ بالحصى والحجارة.. أو كعملاق مطاطي عندما تكف عن شده ينحسر إلى كرة صغيرة. انها انتصاراته ينسبها إلى جيشه! وانت تعرف ان جيشه بات بلا جيش، وأركانه بلا اركان، وعزيمته بلا عزائم… وروعه بلا رَوع. يتخيل جيشاً جراراً هزم العالم كله. دحر كل أعداء “الوطن” وحرَّر الأرض من الغزاة ومن الوافدين…. دون كيشوت اذاً! ماذا نسمي ذلك، عندما نكتشف لا الأرض تحررت ولا الوطن ولا الجيش انتصر. نواجه العالم كله “بإرادة شعبنا…” هكذا يقول الصوت الآتي من النهايات. لكن اين العالم كله؟
تبحث لتجد انه استجلب ما تيسّر من العالم من شتات ليشعر بأنه “موجود بهم” … وانه مستمر في دوره “التاريخي” بهم وانه بلا جيش، ولا ارض ولا حدود ولا سلطة.. شيزوفرانيا مقصودة او غير مقصودة! أهاملت كان مجنوناً ام كان يتظاهر بالجنون؟ هنا المسافة ملغاة، ايهما نجد بشار الشيزوفراني أم الذي يلعب دور الشيزوفراني: ذاك ان المسافة ممحوة، لكن هذه الحالات المشوشة، اذا كانت تتملك هذه الشخصية “المشخصنة” فلكي تحجب الرؤية عن العالم. فالعالم موجود ليقضي عليه. العالم غير موجود لكي لا يرى واقعه. ذلك انه يُنكر كل ما هو في حدود الحواس والملموس والحقيقة والمخيلة والذاكرة… وكل المسافات ملغاة. وهو في هذه “اللعبة” البائسة يلغي من يريد الغاءه أو تمحو تصوراته من يريد الغاءه في اطار دراماتيكي متقلب. فأميركا اوباما معه، ويرى انها ليست معه! واسرائيل حليفته ويدعي انها “عدوه”. وفلسطين الذي دمّر والده مقاومتها في لبنان (الأعز على قلبه) وهو الذي ورث حقده عليها من والده. وعليه في هذه الأحوال والأهوال ان يرى ما يراه النائم في مناماته: فتركيا دولة ارهابية.
لأنه هو غير إرهابي. وأردوغان دكتاتور لأنه هو “أسانس” الديموقراطية. والسعودية أخطر من إسرائيل… وهو استرجع الجولان. وإيران هي الحل: مع هذا يتكلم عن العروبة و”قلب العروبة النابض”، وربما يتماهى بصلاح الدين أو بعبدالناصر وحتى بالسادات… إنه افتراق الذهن عن الذهنية. أكثر: يتكلم عن السيادة وعن شجاعة جيشه بالحفاظ عليها، في الوقت الذي لا يسيطر سوى على أقل حصة من حصص المحتلين أو المسيطرين على أرضه. سيادة ونص! نعم! ولم لا! أحياناً تصبح ردهات قصر المهاجرين أوسع من البلاد كلها، وها هو سيدها! وفي هذه الحلقات الحلزونية ينسى روسيا! التي لم تكتف باحتلال الأرض بل احتلت القرار تاركة لحزب الله والمستجلبين الشيعة وغير الشيعة من العراق وأفغانستان الفتات: أي القتل، والنهب، وممارسة المتعة المذهبية الدموية، وإذا كانت ملابسه جميلة، وأنيقة، فلمَ لا تكون هذه الأناقة من وفر السيادة والاستقلال والعزة، والكرامة، من وَفْر الخزائن المنهوبة من الناس، أو من تهريب الآثار (بالشراكة مع داعش)! إنها روسيا باتت جزءاً من البلاد، ولأنها جزء من البلاد فجيشها هو “جيشنا” العربي السوري الباسل، لا محتل ولا أوراسي ولا من يحتلون. ولأن إيران من جِبلّتنا ومن “أرومتنا”(!) فلمَ لا يكون حرسها الثوري وتوابعه من “حزب الله”، جزءاً من مكونات البلاد وهويته وتاريخه، فلّمَ العجب: فوجودهم هو تعزيز لسيادتنا! خصوصاً لسيادة الرئيس! ولا بأس إذا كان هناك عدة “سيادات” خارجية تصنع سيادة وطنية. فهذا يشكل خصباً وثراء وتعدداً في الاختلافات التي تثري الاستقلال وإرادة الشعب الواحد… ولمَ لا يقول “سيادة الرئيس” إن الشعب الذي أراد استجلاب هؤلاء من روسيا وإيران وأفغانستان والشيشان، لكي يحقق أمنياته بالتحرير الوطني، والحرية، والديموقراطية، ونظام متكافئ، شعبي إلى آخر قطرة من دماء فيه.. وهو من وراء كواه المحصنة وفي أقبية قصره يحصي الشعب كل يوم، ويتأكد أن ما زال كله موجوداً في سوريا، ولولا ذلك لما عبّر عن إرادته في “انتخاب مجلس الشعب”. فتلك الملايين التي هجّرها أو قام بهذه المهمة حزب سليماني أو سوخوي بوتين، أو البراميل المتفجرة، أو القصف بالكيماوي، هو لم يهجرها! على العكس تماماً. فلو كان هو الفاعل لأكمل على البقية الباقية! وهذا ليس من شيم “الكبار” وهو “كبير”! وذو رؤيا، وذو علم وثقافة وطب ودكترة وحضارة… وكومبيوتر! والذين غرقوا في البحار، أو شردوا في جهات الأرض الأربع (لبنان، الأردن، تركيا، أوروبا…)، أغراهم أعداء سوريا وضللوهم، بأبشع المؤامرات ليتركوا بلدهم. فسيادته (وسيادة بوتين وخامنئي)، منعوا استمرار الهجرة لأنها إفراغ الوطن من طاقاته وعقوله وصموده وهذا لا يمكن أن يرتكبه إلا أعداء سوريا! “ومن لم يهجره أصحاب المؤامرات الصهيونية الغربية، فقد هجره الإرهابيون!”.
إنهم الإرهابيون من “داعش” ولفيفهم. ونحن هدفنا الأسمى محاربة الإرهاب! الإرهاب الذي يذبح ويقطع الرؤوس ويسبي النساء ويغتصبهن ويبيعهن كجوارٍ وعبيد، الإرهاب الذي دمر حلب، وحمص، ودرعا، والقصير، ودوما، ونهب تدمر، سنقضي عليه، من دون أن ننسى إرهاب أردوغان! فنحن نحارب مع دولتين ديموقراطيتين هما روسيا وإيران كل الطغاة والاستبداديين والإرهابيين والمذهبيين من أجل المصلحة السورية البحتة وقيمها الجمهورية تماماً كما دحرت هاتان الدولتان الشقيقتان المؤامرات الشعبية في بلديهما، بما تستحق من عقاب وخيانة! أما نحن فكيف نكون إرهابيين كما يدعي أعداؤنا، ونحن نحارب “داعش”! ومن تراه استرد “تدمر” غيرنا من بربرية هذا التنظيم، ومن دون معركة! تسلّم وتسليم. إنها هيبة جيشنا جعلتهم ينسحبون آن اكتشفوا أننا قادمون بلا مقاومة تماماً مثل جيشنا الذي انسحب من تدمر تجنباً للضحايا لدى هجوم “داعش”: لم يكن لا تسلّماً ولا تسليماً، بل إعادة تموضع قواتنا. لا تذكرونا بالجولان، وكيف انسحب والدنا تاركاً أسلحة وعتاداً لجيش كامل، معلناً سقوط الجولان قبل أن تعلنه إسرائيل بـ48 ساعة: فالنظام الذكي العبقري الوطني هو أهم من الأرض: أخذ الأرض قد يتكرر ولا يتكرر. وقد لا يتكرر ويتكرر. وهكذا الأرض قد تذهب ولا تعود، أو تعود لكي تذهب: أنه الفكر السياسي التكتيكي الذي يتحول استراتيجية، أو الاستراتيجية التي تتحول تكتكة ساعة معطلة!
ونظن أن سيادة الرئيس في مونودراماه أمام مجلس الشعب (الشعب أو ساكن السجون، أو المقابر الجماعية…) يعرف معرفة القائم في مناماته، إن نبش التاريخ يعرقل انتصارات الحاضر، وسيرة الجغرافيا الناقصة تزرع الإحباط في الجيوش المنتصرة! وإن كل من يسعى إلى تقليب تذكارات من متاع الإرهاب الذي نتهم به، ما هو إلا مؤامرة على سوريا وشعبها وقيادتها الحكيمة والطبية والنباتية… والحيوانية. هناك إرهاب نُرهبه هو داعش. وهذا يبرئ كل تهمة توجه إلينا كدولة ورئيس بارتكاب الإرهاب الأقصى، فميشال سماحة صديق علي المملوك وهما رتبا نقل السلاح لإحداث جرائم جماعية في أهل السنة وغير السنة… أو اللبنانيين (أشقائنا) أو غير اللبنانيين، ونظن أن ما أوشك سماحة على “تحقيقه” لم يكن مجرد جريمة موصوفة، لا! إنه جزء من تفكير “مقاومتنا” الباسلة. وممانعتنا “الصامدة”… إنه فعل تطهيري حراجي تشريحي يجب تطبيقه في بعض الفئات الخائنة، أو العميلة كأهل عكار، وطرابلس… طبعاً لا يمكن أن نؤيد “محارق” هتلر في حق اليهود ولكن يحتاج أحياناً كل ذي أحلام كبرى أمثالنا وامثال ايران وروسيا إلى إبادة كل من يقف في وجه مشاريعه العظمى… من حشرات، وكائنات فائضة… ونوافل.
هكذا بدا سيادة الرئيس على تلفزيونه وأمام مجلس شعبه. يتبارى مع ظله، أو مع خيالاته، أو مع تهويماته. وهذا شأن أبطال المونودرامات “التراجيدية الكوميدية” الذين يلتبسون أحياناً مع أشيائهم، وديكوراتهم: كملابسهم، ومنصاتهم، والكراسي المزروعة أمامهم، والناس التي لا تميزها عن الكراسي ولا عن اللمبات، ولا الميكروفونات والزخارف… فترى أن البطل الحقيقي في هذه المسرحية ليس الواقف أمامك، أو اللاعب على أدوار، بل هي الأشياء والديكورات والمؤثرات، والإضاءة، هي البطل ليصبح عندها “الممثل” بلا دور… وبلا شخصية، ولا حوار، ولا جمهور…
تصبح الكراسي المليئة بالظلال الشاغرة هي الحضور!
وعندها لا ينتظر أحد من كل ذلك سوى إطفاء الأضواء والمغادرة، وإغلاق الأبواب، وترك البطل غارقاً في ظلمته الغامرة!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News


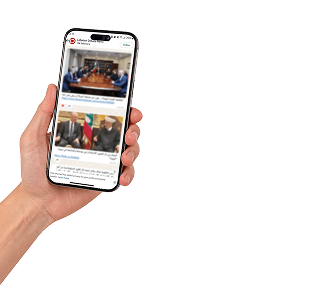




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد





