في المنافسة السياسية، لا يكون الخوف دائمًا من الخصم المباشر، بل كثيرًا ما يكون من الناس أنفسهم. فعندما تتراكم الأزمات بلا حلول، تتحوّل صناديق الاقتراع من وسيلة لتجديد الشرعية إلى أداة محاسبة قاسية. هذا هو المشهد اللبناني اليوم، استحقاق انتخابي يُفترض أن يشكّل محطة ديمقراطية طبيعية، لكنه بات مصدر قلق وجودي للأحزاب، التي تدرك أنّ الشارع سبقها بخطوات، وربما خرج من عباءتها.
الواقع الشعبي اليوم لا يوحي بمنافسة سياسية تقليدية، بل بحالة غضب مكتوم تتقدّم على كل الحسابات. غضب لا يصرخ دائمًا في الشارع، ولا يتجسّد فقط في الاحتجاج، بل يظهر بأشكال أكثر خطورة، منها الامتناع عن التصويت والتصويت العقابي والرفض الصامت للنظام بأكمله. هنا، لا يعود السؤال لمن سيصوّت الناس، بل ما إذا كانوا سيمنحون أصلاً هذه العملية أي معنى سياسي.
تدرك الأحزاب، على اختلاف مواقعها وخطاباتها، أنّ ثمّة ملفات ضاغطة تجعل من أي انتخابات مخاطرة غير محسوبة. وفي مقدّم هذه الملفات سلسلة الرتب والرواتب، التي أُعيد فتحها أكثر من مرة من دون أي معالجة جدّية. هذا الملف لم يعد مسألة أرقام أو توازنات مالية، بل تحوّل إلى رمز لانكسار الثقة بين الدولة وموظفيها. كل طرح جديد بلا نتيجة عمّق الإحساس بالخذلان، وحوّل الموظفين إلى كتلة انتخابية ناقمة ترى في الطبقة السياسية طرفًا واحدًا مسؤولًا عن الفشل.
إلى جانب ذلك، تقف فئات المتقاعدين، من عسكريين وأساتذة وموظفي قطاع عام، أمام واقع قاسٍ وغير مسبوق. هؤلاء الذين شكّلوا لعقود العمود الفقري للمؤسسات والدولة، باتوا اليوم يشعرون بأنهم تُركوا لمصيرهم. حقوقهم التراكمية تآكلت، وتعويضاتهم فقدت قيمتها، ورواتبهم لم تعد تؤمّن الحد الأدنى من الكرامة. غضبهم هادئ لكنه عميق، وإذا قرّروا المشاركة في الانتخابات، فلن يصوّتوا بدافع الولاء، بل بمنطق محاسبة شاملة لكل من شارك أو سكت أو تهرّب.
أما الشباب، فهم العقدة الأكثر إرباكًا. جيل كامل نشأ في قلب الانهيار، ولا يرى في الأحزاب لا مشروعًا ولا أفقًا ولا صدقية. لا يثق بخطابها، ولا يؤمن بوعودها، ولا يشعر بأنها تمثّله. مشاركته، إن حصلت، ستكون تصويتًا عكسيًا بامتياز، تصويتًا ضد الأحزاب لا لصالح بدائل واضحة، ما يجعل هذا الجيل خارج أي قدرة على الضبط أو الاحتواء.
ويعلو فوق كل ذلك ملف المودعين، بوصفه القنبلة الاجتماعية الأكبر. فالمودعون لم يعودوا فئة مطلبية عادية، بل تحوّلوا إلى كتلة وطنية عابرة للطوائف والمناطق والانتماءات. وجعهم واحد، وإحساسهم بالظلم جامع، وقناعتهم راسخة بأن السلطة السياسية أخفقت، أو امتنعت عن حماية حقوقهم. هذا الملف كسر آخر خطوط الثقة بين المواطن والدولة، وتصويت المودعين، إن حصل، سيكون تصويت نقمة لا يستثني أحدًا.
تلاقي هذه العوامل جميعها يعني أنّ الذهاب إلى الانتخابات في ظل غياب الحلول يشكّل خسارة محتملة للأحزاب، ليس فقط بعدد المقاعد، بل بمعنى العملية السياسية نفسها، حين تتحوّل إلى استفتاء شعبي واسع على فشل الدولة والمنظومة الاقتصادية والمالية والسياسية.
من هنا، لا يمكن فصل الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات عن هذه الوقائع. فالتأجيل، إذا طُرح، لن يكون تعبيرًا عن حرص على الاستقرار، بل محاولة لشراء الوقت وتفادي لحظة محاسبة قاسية. غير أنّ الوقت، من دون معالجات جدّية لسلسلة الرواتب، وحقوق المتقاعدين، وكرامة العسكريين، وودائع الناس، لن يكون عامل تهدئة، بل عبئًا إضافيًا يُراكم الغضب.
المشكلة اليوم ليست في موعد الانتخابات، بل في غياب مشروع يعيد بناء الثقة بين الدولة والناس. فصناديق الاقتراع لا تخيف الأحزاب بذاتها، بل تخيفها لأنها قد تكشف، بوضوح لا لبس فيه، حجم الانهيار الذي لم يعد ممكنًا تأجيله ولا الهروب من استحقاقه.


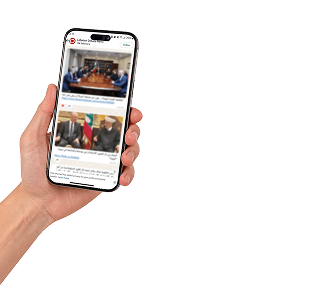




 الـــمــــزيــــــــــد
الـــمــــزيــــــــــد






